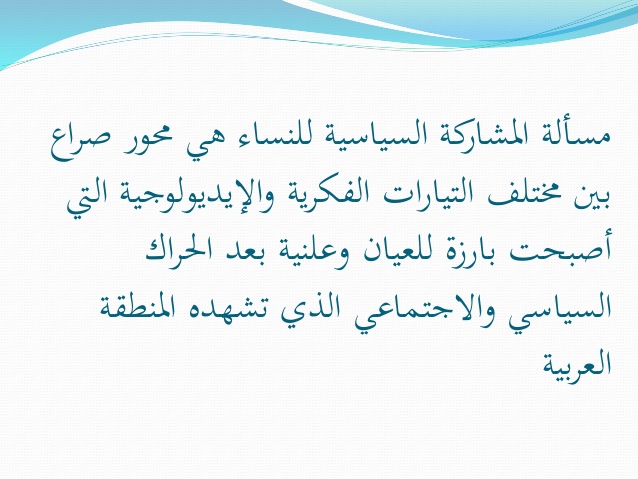زينة الحلبي/ aljumhuriya- إلى زميلاتي الكاتبات..
حَرسُ محمود درويش رجال. هم روائيون وشعراء ومؤرّخون وأكاديميون أيضاً. هم يعرفون درويش شخصياً وبشكل حميمي؛ هم الذين أنهى مكالمةً معهم أياماً معدودة قبل وفاته؛ غالباً ما يمازحونه، وغالباً ما يشهدون على جاذبيّته لدى النساء؛ هم الذين أسرَّ لهم بخبايا حياته العاطفية؛ هم الذين سلّمهم سرّ أبوّته غير المعلنة؛ هم الذين استشارهم بقصيدة احتار بها؛ هم الذين أمّنهم على مخطوطته الأخيرة؛ هم الذين قرأوا له كلّ شيء، فأصبحوا عالمين بكل شيء؛ هم الذين ينتظرون الذكرى السنوية لغيابه لينشروا صورتهم معه؛ هم الذين يعرّفون عنه بـ«الشاعر»، صفةً وحيدةً لا شريك لها. هم يتناحرون حيناً، لكنّهم يلتفّون أحياناً عند مشهد امرأة تبدو وكأنها تتكلّم في مَحفلهم، هم حرس الصنم.
هذه المقالة ليست عن محمود درويش، بل عن المنهجية التي يتّبعها حرس الأصنام في نقدهم. أضع بين يديكِ، عزيزتي القارئة، مطالعةً حول مقالة سجالية خطّها أحد حَرَس الشاعر، كاتب يستشيط غضباً أمام كاتبة قدّمت تأويلاً مغايراً لتركة الشاعر الذي يحرس. كان يمكن لهذه المطالعة أن تتعاطى مع المقالة من باب النقد الأدبي، حتّى لو كان كاتبها ممّن لا يزالون يستخدمون، بثقة مبهرة، مصطلح «ما بعد حداثة» في معرض التوبيخ. كان يمكن أيضاً التغاضي عن بعض التعابير السفيهة والردّ على الحارس الغاضب باستشهادات من نصوص درويش نفسه الذي ترك أعماله نصاً مفتوحاً للتأويل، وهو القائل لحُرّاس القلاع ومُمتهِني الخنادق، إنّ «الهويّةَ مفتوحةٌ للتعدّد/ لا قلعةً أو خنادق». لكن هل يمكن حقاً أن تناقشي مَن يحاول أن يفرض عليكِ منطقاً توحيدياً في القراءة الأدبيّة؟ وماذا يبقى من الشعر أصلاً حين تُفرَض عليه القراءات الأحاديّة؟ وماذا يبقى من النقد حين يطرح الناقد نفسه خاتم القراءات والتأويلات؟
للوهلة الأولى، قد تجيبين: لا شيء، وأنّ المسألة برمّتها لا تستحقّ الردّ. لكن ماذا لو وضعنا درويش جانباً، وابتعدنا قليلاً عن شؤون النقد الأدبي حصراً؟ عندها، ستظهر قيمة النص التي ينبغي التعامل معها، وهي أنه يقدّم لنا نموذجاً عن منهجية للنقد الذكوري التي غالباً ما يتمرّس بها الحرس من خلال توحيد القراءات وإسكات الأصوات الكافرة، فيقدّمون حقل النقد الأدبي برمّته قرباناً على مذبح الهيكل الذي يحرسون. ومن خلال ممارستهم لهذه المهنة، يقوم الحرس بما هو أخطر بكثير من النقد التكفيري، إذ يحاولون وضع حدّ لامرأة خرجت عن دورها المتوقّع كفراشة تطوف في فلك الشاعر وحرسه. تُضيء هذه المقالة إذاً على منطق النقد الذكوري بأركانه الأربعة، وذلك في سبيل الإجابة على السؤال الحاضر- الغائب: كيف تستدعي بعض السجالات تهافتاً ذكورياً تأديبياً؟
أولاً: استعطاف القارئ وتحريضه
منذ الجملة الأولى، يبدأ الحارس بالإعلان عن حيرة تجتاحه لدى قراءة مقالة الكاتبة، إذ إن «المرء يحار من أين يبدأ في تفنيد كلام الناقدة». هو «المرء»، الكائن البشري، العالمي، التاريخي، المجرّد من أي هوية أخرى— اللهم إلا هويته الذكورية— يقف حائراً، فالمصاب أليم والمهمّة عسيرة. يعاود الحارس التأكيد على حيرته، وعندما يصل إلى منتصف المقالة، يقلب طاولة اللعب. يتعرّض الحارس لوعكة صحية، فيقرّ بأنّه لم يعد لديه «رغبة في تفنيد الدليل تلو الدليل (…) لقد تعبت»، فينهار أرضاً صارخاً مستصرخاً القارئ بهول مأساتهما المشتركة، مأساة التعرّض الأنثوي للصنم.
قد تتساءلين عن سبب هذا التعب: هل ما يُتعِبُ الحرس هو ممارسة التأديب ومهنة الحراسة؟ وإن كانوا يتعبون فعلاً، فلماذا لا يرتاحون قليلاً من هذه المهمة التي لم يوكلهم بها أحد؟ لكنّ الحرس لا يرتاحون، بل سرعان ما يتخطّون حيرتهم ليمارسوا التكتيك الكلاسيكي الذي تعرفينه جيداً، أي الطعن بمؤهّلاتك كي يجرّدوك من الحقّ في القول.
ثانياً: الطعن بمؤهّلات الكاتبة
هذا الركن، عزيزتي القارئة، من أشدّ مراحل النقد غرابةً وأكثرها دلالةً على هشاشة الحارس وتمرّسه بمهنته الحراسيّة. فمنذ المقطع الأوّل، يطرح الحارس السؤال- المسألة الذي سوف يحدّد نبرة المقالة: «كيف يمكن لكاتبة وناقدة أن تكتب نصاً يفتقد إلى التماسك المنطقي ولا يميّز بين المصطلحات والمفاهيم الأساسية؟». ثمّ يكرّر الحارس ذكر اسم الكاتبة 38 مرة فيصبح شخصها العلّة والحجة الوحيدة لنشر الرّد. وهنا تبدأ رحلة الطعن بمؤهّلات الكاتبة.
يكرّر الحارس التذكير بأنّ الكاتبة «ناقدة أدبية» و«أستاذة جامعية في مجال الأدب»، ممّا يضاعف صدمته لأن موقعها لا يتناسب وقولها، خصوصاً وأنها لا تعرف ما يعرفه هو. فيتساءل إن كانت تقرأ فعلاً، وإن كانت تعلم فعلاً، وإن كانت تعرف فعلاً. لا، لا تعرف الكاتبة ما يعرفه هو، وهي أيضاً غير قادرة على القراءة، وإن قرأت فإنّها «تسيء الفهم» (مكرّرة خمس مرات). هي تكتب «بشكل استطرادي غير واعٍ» و«دون أن تنتبه» (مكرّرة مرّتين)، وتجرّ نفسها «من حفرة إلى حفرة أعمق»، حتّى أنّها «وقعت» ثمّ «انزلقت» (مكرّرة مرّتين) في «مطبات فكرية كثيرة». أمّا الصورة التي تتكلّم عنها، فـ«موجودة في خيالها فقط»، في إشارةٍ إلى انقطاعها عن الحقيقة والمنطق والمعرفة. كلّ ذلك قبل أن ينتقل الحارس إلى الكلام عن مقاربة الكاتبة التي تُعاني، على ما يبدو، من عدّة مشاكل يبدأ بتعدادها: مشكلة أولى، مشكلة ثانية، إلخ. يشتكي من «خلطها للأمور والمفاهيم والمصطلحات»، ومن «التضاد المفهومي»، ومن «فقر» تصوّرها.
ثمّ يأتي الانقضاض الأخير على الكاتبة على شكل مهاجمة الكائن الهلامي، تلك الشمّاعة المسماة «ما بعد الحداثة». فمشكلة الكاتبة أنّ نصّها «ما بعد حداثي» (قد تتساءلين عن خطورة هذه التهمة، ولكننا نعجز عن شرحها، خصوصاً وأنّه عُثر على ما بعد الحداثة في الأدب العربي منذ خمسين عاماً). لـ«ما بعد الحداثة» توأم اسمه «التفكيك». يتّهم الحارس الكاتبة بالانزلاق الدوغمائي نحو «التفكيك» الذي قامت عليه النظريات النقدية للنسوية والعرق والاقتصاد والجنسانية واللسانيات والبيئة منذ أكثر من نصف قرنٍ. ثم يبني أمام الكاتبة حائطاً دفاعياً منيعاً، فهو الأصيل ونصّها الما بعد حداثي هو الدخيل، فيما يتخطّى نصها خطوط التماس النظرية التي يحرّض الحارس من داخلها. يُنهي الحارس هذه المرحلة بتكرار عبارة «تنظير» (خمس مرّات). وهنا بدأت تتّضح خطيئة الكاتبة: إنّ لديها نظرية وإنّها تكتبها وإنّه يقرأها؛ أي إنّها تفعل بالضبط عكس ما ينبغي أن تفعله: أن تقرأ هي النظرية التي يكتبها هو.
بعدما يحاول الحرس إقناعك، عزيزتي القارئة، بأنّ الكاتبة أمامهم ناقصة عقلٍ ودين (دين عبادة الصنم)، يصبحون مستعدّين لتقديم عرضهم الأدائي أمام جمهور لم يأتِ، في الحقيقة، ليستمع إليهم. إلا أنهم يصعدون على المسرح الذي لم يدعُهم إليه أحد ويبدأون. ركّزي جيداً لأنّ المرحلة الثالثة شديدة الإدهاش.
الركن الثالث: الأستذة المعروفة أيضاً بالمانسبلاينينج
ليس المانسبلاينر غريباً عنك، طبعاً. هل تذكرين ذاك الذي التقيتِ به في المصعد وشرح لك أطروحتكِ بعدما قام بالتشكيك في جدواها؟ أم تذكرين ذاك الذي قاطع محاضرتكِ عدة مرّات كي يلفت انتباهك إلى مقال كتبه هو عن الموضوع؟ يشبه ذاك الذي اتصل بك عقب نشرك لمقالة معاتباً: «غلط. ما كنتِ اسأليني». قد تختبرين المانسبلاينينج أيضاً في كثافة المعلومات التي يرشقها الحارس في وجهك لأنك، كما الكاتبة، لا تعرفين حجم ما يعرف، فوجب الشرح والتصويب. عندها، يبدأ الحارس بتقديم سلسلة من الإرشادات في سبيل تأديب الكاتبة، لعلّ الأخريات يعتبرنَ، فيصمتنَ.
المانسبلاينر يختار النصوص التي يجب أن تعملي عليها. كانت الكاتبة قد استشهدت بنصٍّ لفنّانة ألهمتها. إلا أنّ نصّ الفنّانة لا يستهوي الحارس إطلاقاً، فينتقد خيارها ويدعوها إلى تبنّي مقاربة أخرى، على هواه هو («كان يجب أن»، «كان أجدر لها أن»، «كان حرياً بها أن»، «ليس بالإمكان أن»، «كان من الممكن أن»… إلخ). بعد قليل، سوف يقدّم بديلاً يلائم رؤيته هو، فيُرشدك إلى الطريقة الأنسب (له) في النقد: «إذا كان لأحد أن ينتقد فإن نقده يجب أن يكون بعكس ما جاء». بمعنى آخر، إنّ الحارس هو الوحيد المخوّل بتحديد قواعد النقد، وعليه، ترينه يصوّب ويشرح ما كان يجب عليك أن تقرأي وكيف يجدر بك أن تنتقدي. من هنا، تبدأ سلسلة الشروحات المستفيضة الهادفة إلى إعلاء شأنه هو، شأن الحارس العليم.
المانسبلاينر متمرّس في المقاربات النظرية، على عكس الكاتبة التي لا تميّز بين المفاهيم. هي استخدمت مصطلح «النبوءة» الذي يرفضه رفضاً قاطعاً فيستبدله بمفهوم آخر هو «الحكمة». قد تتساءلين عن الإفادة الفلسفية للفرق بين المفهومين. سيشرح لك، ولكن عليه أن يستطرد قليلاً (بشكل واع طبعاً وليس كالكاتبة الفاقدة لوعيها) ليشرح لك الفرق بين حساسية ماركس وبنيامين التاريخية، حتّى لو لم تأتِ على ذكرهما في مقالتك. شكراً على الدرس الذي لا يفيد إلا في فضح ضيق معرفة المانسبلاينر بتعدّد التيارات الماركسيّة. لكنّ استعراض المعلومات لا يكفي وحده ليشفي غليل المانسبلاينر، فيذهب إلى دعم حجّته من خلال الاستشهاد، بمن؟… بنفسه طبعاً، متكئاً على نصّ آخر له. المانسبلاينر لا يستشهد بكِ أو بها، ما دامت لديه نفسُه جاهزةً لدفقٍ بلا حدود.
بعدما ينتهي الحرس من مهمتهم الإلغائية، التأديبية، التفسيرية، ينتقلون إلى المرحلة الأخيرة، أي مرحلة تلميع الصنم.
رابعاً: تلميع الصنم
بعكس المراحل الثلاث السابقة، تتميّز هذه المرحلة بالإيجابية والجهد البنّاء. يدع الحارس الكاتبة جانباً، ويباشر في ممارسة دوره الأصيل في تلميع الصنم. يبدأ بالإعلان بأن النص الذي يكتبه «ليس نصاً للدفاع عن بطولة درويش ولا جرأته». لكنّه لا يلبث أن يعود بمهمّة دفاعية ليعلن إنه «يدافع» عن «شاعرية الشاعر» و«ردّ التهم التي وردت» في مقالة الكاتبة.
هنا تكتمل مرحلة التصنيم التي تتميّز بأحادية المعنى والتعريف المباشر، أي استخدام جمل إسمية تعرّف بشكل قاموسي عن الشاعر وجوهره وحقيقته. الحقيقة واحدة وهي في جيب الحارس. نتعلّم منه أنّ درويش هو مجموعة من الصفات الواضحة والأحادية، تميّزها نبرة النفي والقطع والجزم. ولكن من يهمّه الجزم بأن درويش فعلاً «شاعر الحنين بامتياز» وليس «شاعر الأيديولوجيا ولا شاعر اليوتوبيا»؟ القاطع الناهي هو الحارس نفسه. وما دام نقده الأدبيّ قائماً على الهجاء، فلا بأس في أن يستعين ببعض السجع، فيصبح درويش «شاعر المستحيل بقدر ما كان شاعر الجليل». ولئن كان الصنم دائماً كاملاً مكتملاً، يدعونا الحارس إلى «درويش المتأخّر الناضج والمتأمّل»، أي الصنم الذي انتهى لتوّه من تلميعه. نفهم أخيراً أنّ إثم الكاتبة هو أنها «تكذّب نبوءة غير موجودة، وتحطّم صنمًا وهميًّا، فلا أصنام ولا نبوة». ليس الشاعر صنماً، إذاً. لكن، إن لم يكن الشاعر صنماً، فما هذا الشيء الذي يحرسه الحارس بهذا العنف؟ ولماذا ينهار أمام كاتبة يظنّها تهاجم من هو ليس، في الحقيقة، صنماً؟
*****
يستمرّ الحرس في الدفاع عن قلعتهم حتى النفس الأخير، حتى ولو تعبوا من التأديب. ولكنّ الحرس لا يُتركون وحيدين، حائرين، تعبين، بل يأتي لنجدتهم عدد من قدامى حرس الشاعر الذين يصفّقون إعجاباً وتأثّراً بالحرس التوحيديّين التكفيريّين. ولكنّكِ، قارئتي العزيزة، تعرفين جيداً أن القضية ليست عن محمود درويش ولا عن هذا الحارس أو ذاك. بل هي في الأساس عن منهجية نقد ذكوري تسبق معشر الحرس. وبعكس الشعر ونقده، تعمل تلك المنهجية وفق أركان يتجلّى فيها النقد انهياراً وتحريضاً، فاستعراضاً وتلميعاً. تهدف المنهجية إلى وضع كاتبة عند حدّها، قد تكون أنا أو أنتِ أو أي كاتبة أخرى، حين تخرج عن أقانيم النقد السائد وتتجرّأ على القول. هي منهجية تُثبت هشاشة الحرس في لحظة دفاعهم عمّن يدّعون حمايته من التصنيم فيما يبنون له صنماً جليلاً، مقالاً تلو الآخر، مرثيةً تلو الأخرى. وهم الطامحون عبر رثائه إلى وراثته، علّهم يصبحون، بدورهم، أصناماً يتولّى رجال آخرون حراستهم.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.