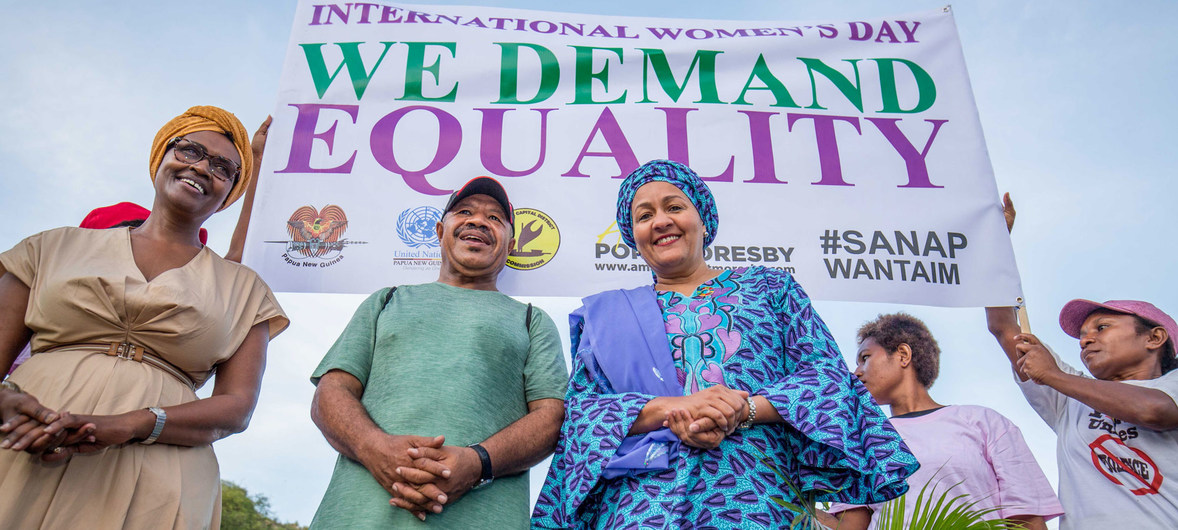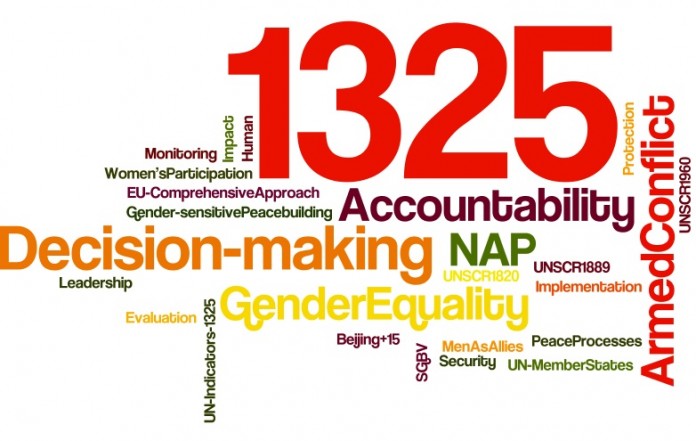سوسن جميل حسن/ سيريا تي في- ملاحظةٌ سمعتها أكثر من مرة عن النساء الألمانيات اللواتي عشن محنة الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها ألمانيا مدمّرة، وكيف ساهمت النساء في إعادة بنائها من تحت الأنقاض ومن ركامها، الملاحظة الجديرة بالوقوف عندها هي صمت غالبية النساء، وقد تقدّمن في العمر ومعظمهن كنّ جداتٍ. الأحفاد يقولون بأن جدّاتهن كنّ يتجنبن الحديث عن الحرب، وكان لديهنّ صفة مشتركة أيضاً هي تخزين المؤن في البيت بالرغم من توافرها ومن تحسّن حياة الفرد الألماني ونهوض ألمانيا ووصولها إلى مرتبة دولة مستقرة ذات اقتصاد قوي.. لكنها الحرب التي لا تترك أحداً ينجو من دون بصمة على الأقل، بصمة للروح وبصمة للجسد.
هي الحرب وما تترك من وشوم لا يمكن أن يمحوها الزمن مهما عاش الفرد أو عمّر، وشوم الروح التي تعيد تثبيتها الذاكرة كلما بهتت ألوانها. ما مرّ على النساء الألمانيات في الحرب يبدو من الصعب البوح به بالرغم مما حكي عنه، لكن تلك الأرواح المشروخة والنفوس المنتهكة بالفظائع التي ارتكبها بحقها الجيش السوفييتي، بالإضافة إلى وحشية الحرب وما تخلّف من فاقة وجوع وتهجير وانحرافات أخلاقية وتعويم لسلوك غريزي غايته الوحيدة البقاء بأي طريقة حتى لو على حساب كل الكرامات والقيم الإنسانية يبدو من الصعب عليها البوح أو حتى إحياء العالم الذي كان، عالم الأمس وقد غلفته الدماء وغبار الحرب فأربكت صورته وشوهتها في الذاكرة.
الحرب السورية قد تكون أفظع، فالحروب لا تقاس بما خلفت من دمار وما زهقت من أرواح فقط علما بأن الدمار الذي خلفته الحرب السورية، ولا يمكن توقع انتهائها، دمار جبار رهيب، بل تقاس بقدرتها على إحداث شروخ وتصدعات وانهيارات معمرة يلزمها الكثير من العمل والطويل من الحقب من أجل ترميمها ومحو آثارها.
من هذا المنطلق فإن الحرب السورية من أشرس الحروب في التاريخ، ولقد دفعت المرأة السورية أثمانها الباهظة، السورية المطعونة بكرامتها وعرضها والمهددة بكيانها وأطفالها، فاقدة الأمن والأمان وفاقدة الاعتراف بها بالرغم مما تحملت من أعباء تلك الحرب.
ما الذي خزنته المرأة السورية في ذاكرتها كي تعمّر الحكايات وتنسجها لترويها لأبنائها وأحفادها فيما بعد؟
المرأة السورية هي الشاهد الأكثر نزاهةٍ ومصداقية عن الويلات التي عانى منها السوريون، وهي الجرح المفتوح ينزف بصمت ويلتهب في عمق كيانها، وحيدةً تعضّ عليه وتصارع المصير الغاشم من أجل أطفالها أو من بقي من أطفالها، فما هي الحكايات التي سترويها عن بلادٍ لم تعد كالبلاد، عن ماضٍ صار رماداً وانتهى؟
مهما قيل عن الكتابة الروائية وعن أنّ الرواية السورية في زمن الثورة أو الزلزال العاصف بسوريا كان للنساء النصيب الأكبر فيه، فإن حكايات الواقع أهم، تلك التي تصنع النبض الحي، أو تمدّ الجيل بنسغ الحياة. وإذا كانت مهنة الحكواتي مهنة اجتماعية ذكورية فإن طبيعة الثقافة الذكورية السائدة هي التي منحته هذا الامتياز، لأن المجال الحياتي للمرأة كان ضمن المنزل، لكن النساء بشكل عام هن الأبرع بالسرد وحبك الحكايات، والحكّاءة الأشهر في التاريخ شهرزاد الساحرة التي خلبت لب أعتى جبّار فروّضته بالحكاية والدهشة.. حكايات قبل النوم التي ترويها الجدات بعد تقاعدهن من الخدمة البيتية أهم من الروايات التي يؤلفها الأدباء في عمر النضج، فهي المنبع الثري لخيال يتشكل، وهي الحامل المعرفي والقيمي الأول، وغالباً ما تحكي الأمهات أو الجدات قصصاً من نسج خيالهنّ، يخترعن شخصياتٍ وأبطالاً ويؤسسن لهم عوالم ومدناً وأحياءً وبيوتاً ويمزجن الغرائبي بالواقعي ويمررن من خلال تلك القصص المفبركة قبل نوم الأطفال قيماً جمالية ومعرفية وأخلاقية وتربوية وغيرها. وغالبًا تُبنى الرواية على الأمكنة المعروفة للطفل، وعلى عناصر بيئته التي يألفها مع تطعيمها بالفانتازيا التي تثير فضول الطفل وتستثير مخيلته.
هل ستصمت النساء السوريات؟ وماذا ستحكي الجدّات لأطفالٍ ولدوا في زمن الحرب، أطفال كبروا بدون ذاكرة غير التشرد واليتم والعوز والفاقة والشعور باللا انتماء؟ أطفالٌ في مخيمات اللجوء، أطفال في مناطق النزوح؟ أطفال خارج العصر، بلا مدارس ولا ألعاب ولا شاشات ولا أجهزة ذكية؟
هل ستقول الأم لابنها والغصّة تخنق صوتها، أو الجدة وصوتها يرتجف: كان يا ما كان، في قديم الزمان، كان في خيمة ساكن فيها أم وأب وأولادهم؟ أم ستعيد قصة البيت الذي هناك، البيت الذي صار بعيداً، أبعد من الممكن، البيت الذي صار أطلالاً فأربكت صورته الذاكرة، وعن الحارة ورفاق اللعب وبيوت الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، فيرتاب الطفل وهو يستدعي القرائن في باله، أين الحارة وساحة اللعب وبيوت الأقرباء؟
ما هي القيم التي ستحملها الحكايات؟ هل تعيد عليهم قصة المرأة التي راحت تغلي الحصى في القِدر لتوهم أطفالها بأنّ طعاماً ينتظرهم فيناموا على الوهم وبطونهم خاوية؟ عن أيّ جمال وعن أيّة أخلاق ستحكي الجدّات؟ وأيّ خيال سيحرضن في بال أطفال بطونهم خاوية وعقولهم معطّلة؟ وعن أي بلادٍ سيتحدثن؟ عن بلاد بعيدة لا يطالها الخيال؟ وفي المستقبل؟ ما هي حكايات المستقبل؟
عن أيّ وطنٍ ستحكي الجدّات وأحفادهن تبددوا في بقاع الأرض، لا وطن يحملونه في ذاكرتهم، ولا آخر يتشكّل في وعيهم وهم يكبرون ويدركون الحقائق بالتتالي، يدركون أنهم ليسوا أكثر من لاجئين مرشّحين لخصومة الأمكنة والقوانين والحقوق والمجتمعات التي ستحاول إقصاءهم إلى هامش الحياة التي صنعوها.
هل ستصمت جدّات المستقبل ويغلقن صدورهنّ على ما تراكم فيها من جروح وندوب وفواجع وخيبات وويلات؟ هل ستنسى الجدّات السوريات نسج الحكايات وتصير جملة: كان يا ماكان، طلاسم تحاصر لياليهن وتملؤها بالكوابيس؟
لا يكفي تأليف الروايات عن سوريا في مرحلة الثورة أو الحرب، لا تكفي الشهادات ولا السير، ولا التوثيقات، لتعيد إلى المجتمعات السورية نبض الحياة، لا بد للحكاية من أن تعود، الحكاية التي تؤسس للوعي والخيال منذ الطفولة، لكنها المهمة الأصعب إذا لم تلتزم الجدّات السوريات الصمت.