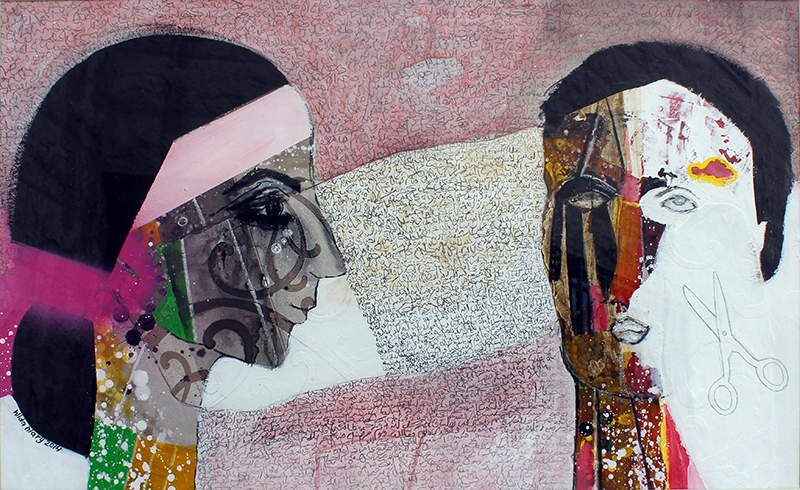هاجر الريسوني/ عربي بوست- دائماً أتساءل: لماذا يصاحبني إحساس بأن مجتمعاتنا العربية تكرّس للتمييز بين الرجل والمرأة، رغم أن الكثير من الأصدقاء حاولوا إقناعي بأن المرأة هي نفسها التي تروّج أنها «مسكينة» و»ضعيفة» وليس المجتمع؟ إلا أن هذا الإحساس ينمو داخلي، كلما تعرفت على «عوالم النساء»؛ أتأكد من أن طبيعة مجتمعاتنا تحرّض المرأة على تقديم التضحيات ويربيها على أنها شمعة يجب أن تحترق ليتقدم المجتمع ويزدهر.
لست من أنصار التغني بخطاب المظلومية، وأومن بأن الحقوق تُنتزع لا تُعطى، إلا أني أومن بأن الإنسان الذي تربى في محيط يبخس كل عمل يقوم به، لا يشجعه، يتلذذ بإذلاله، صعب جداً أن يثور على مجتمعه وعلى كومة مشاعر الاستسلام والخنوع والخضوع التي زُرعت فيه، خصوصاً إذا لم يكن سبق له الخروج عما يحيط به، لهذا يحتاج لمن يأخذ بيده ويدلّه على طريق وأن يساعده حتى يضع خطوته الأولى نحو اكتشاف الذات واستقلاليتها.
كل هذا الذي ذكرتُه ينطبق على المرأة، فالمرأة كائن ضعيف بطبيعتها الفسيولوجية، والتربية التي تتلقاها تسهم في ترسيخ هذه الفكرة، فالمجتمع يحاول في كل موقف تأكيد أن في ضعف المرأة قوة، وأن دموعها كفيلة بتحقيق رغباتها، ولو صاحبتها بقليل من الغنج وإبراز أنوثتها فستعيش «ملكة»، لكن لا أحد فسّر لها أنها قبل أن تمتلك الأنوثة، كان العقل هو الذي صاحبها منذ صرختها الأولى.
المرأة لا تقلُّ كفاءة، ولا يقل ذكاؤها وقدراتها ومهاراتها عن الرجل في شيء، لكن كيف يمكن إخراج هذه الطاقة منها؟ أعود دائماً لتأكيد أن التربية هي المحدد الأساسي لما ستكون عليه الأنثى حين يشتد عودها، أحببنا أم كرهنا فالدور البيولوجي للمرأة، الذي هو الإنجاب، يشكل أولى العُقَد التي تصاحبها مدى الحياة، فتربية المجتمع لها على أساس أن أسمى مهماتها في الحياة هي المحافظة على النسل، يجعلها تعيش في ضغط دائم، تنتظر فقط متى تشرع في تنفيذ المهمة.
لي زميلات دراسة، اليوم أغلبهن مهندسات، وكنَّ متميزات في الفصل، لكن ما إن تخرجن واستأنفن العمل انتهى لديهن هاجس الدراسة وتطوير مهارتهن وبدأ هاجس الزواج والإنجاب والسيارة والشقة.. بخلاصة المتطلبات الاستهلاكية لـ»الحياة السعيدة» التي رسموها لنا بدقة؛ لكن ولا واحدة منهن فكرت في أن يكون زواجها انطلاقة جديدة نحو أهداف أكبر، والعكس صحيح، لي أصدقاء جلهم أيضاً مهندسون، الزواج كان بالنسبة لهم عامل الاستقرار للانطلاق في المسار المهني والانتقال من نجاح لنجاح، وهنا يكمن الفرق بين تربية المرأة وتربية الرجل في مجتمعاتنا، فالمرأة تنتهي حياتها بالزواج والرجل تبدأ حياته بالزواج!
لست ضد كل ما ذكرته سابقاً، لكني ضد الفراغ الذي يجد طريقه لحياة المرأة بعد سنوات من الحياة الروتينية، وقد تكون استنزفت كل ما كانت تصوره على شكل أهداف تحققها وهي فقط متطلبات لتأثيث الحياة، ربما لو كانت المرأة منذ بداياتها عملت على أن تصاحب زوجها في كل خطوة يخطوها وتتشارك معه المسؤوليات لتتفرغ هي أيضاً لتحقيق أهدافها وخلق مساحة شخصية لها، ليس بالضرورة في المجال المهني؛ لأن هناك نسبة كبيرة من النساء اخترن أو اضطررن إلى أن يكنَّ ربات بيت؛ بل في العمل الجمعوي، والقراءة، وتطوير هوايات معينة، وتعلُّم القراءة والكتابة للاتي حُرمن من التعليم..
لكن، كل هذا كيف يمكن تحقيقه؟ سيقول البعض إن المرأة هي التي صدقت سيمفونية ظلم المجتمع لها، وبإمكانها تحقيق كل ما ترغب فيه نحن في زمن المساواة، غير أن لي طرحاً مغايراً لهؤلاء، فالمساواة التي يتحدثون عنها حبر على ورق، ومجتمعاتنا العربية ما زالت تضع قيوداً وعراقيل، ونجاح المرأة هو استثناء نحتفل به ونصفق له، هذا ما أكده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يعد مؤسسة رسمية حول النشاط الاقتصادي للمرأة.
إذ كشف عن تعرّض النساء بكيفية أكبر للبطالة، لا سيّما في صفوف الحاصلات على شهادات، فضلاً عن كوْن نسبة البطالة في صفوف النساء الحضريات تشكّل ضِعْف نسبة الرجال، 20.6% مقابل 11.5%.
وليس هذا فقط، فمشاركة النساء في مراكز «القيادة» واتخاذ القرار ضعيفة؛ لأنهنّ يصطدمن، سواء في القطاع العامّ أو الخاص، بـ»السّقف الزّجاجي» الذي يُعد كمجموعة من «الحواجز المُصْطنعة وغير المرْئية. ففي القطاع العام حيث تصل نسبة النساء إلى 40% من الموظفين، فإن نسبة النساء المسؤولات لا تتعدى 16%.
وفي القطاع الخاص، نسبة النساء اللاتي يحتللن مركز قرار في المقاولات الخاصة التي تعمل في مجال التجارة والصناعة والخدمات لا تتعدى 0.1%. فضْلاً عن ذلكَ، فإنّ تمثيليّة النساءِ في هيئات الحَكامة داخل المُقاولات تظلّ ضعيفة، بحيْث لا يمثّلن سوى 7% فقط من نسبة مديري كبرى المقاولات العمومية، و11% فقط منْ مديري الشركات المشهورة.
هذه الإحصاءات هي فقط نقطة في بحر التقارير التي تؤكد باستمرار أنه رغم التقدم والتطور النسبي للمجتمعات التقليدية فإن وضعية المرأة لم تتحسن إلا بشكل طفيف، وهناك دائماً عراقيل تعود بنا خطوتين للوراء كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام، وهذا دليل على أنه رغم أن لدينا أحدث التكنولوجيات، وعماراتنا تنطح السحاب فإن مجتمعاتنا ما زالت تنتج العقليات نفسها باطنياً؛ لأن أغلب مدَّعي الحداثة بداخلهم ما زال يعيش «أبوجهل».
لا أقول إن المرأة مظلومة وإنها مسلوبة الإرادة، وإن المجتمعات الذكورية تتآمر عليها، لكني أقول إن المرأة ونحن في القرن الـ21 لم تُتح لها فرصة الخضوع لاختبار الاختيارات من دون ضغط من رواسب التربية ومن قيود العادات والتقاليد المجتمعية، وأهم شيء من دون ضغط الأنا القرينة بها والتي قتلت داخلها الإرادة.
ماذا لو أن كلّ امرأة أتيحت لها هذه الفرصة؟ هل سيبقى المجتمع على حاله أم أننا سنعيش ثورةً في كلّ شيء؟