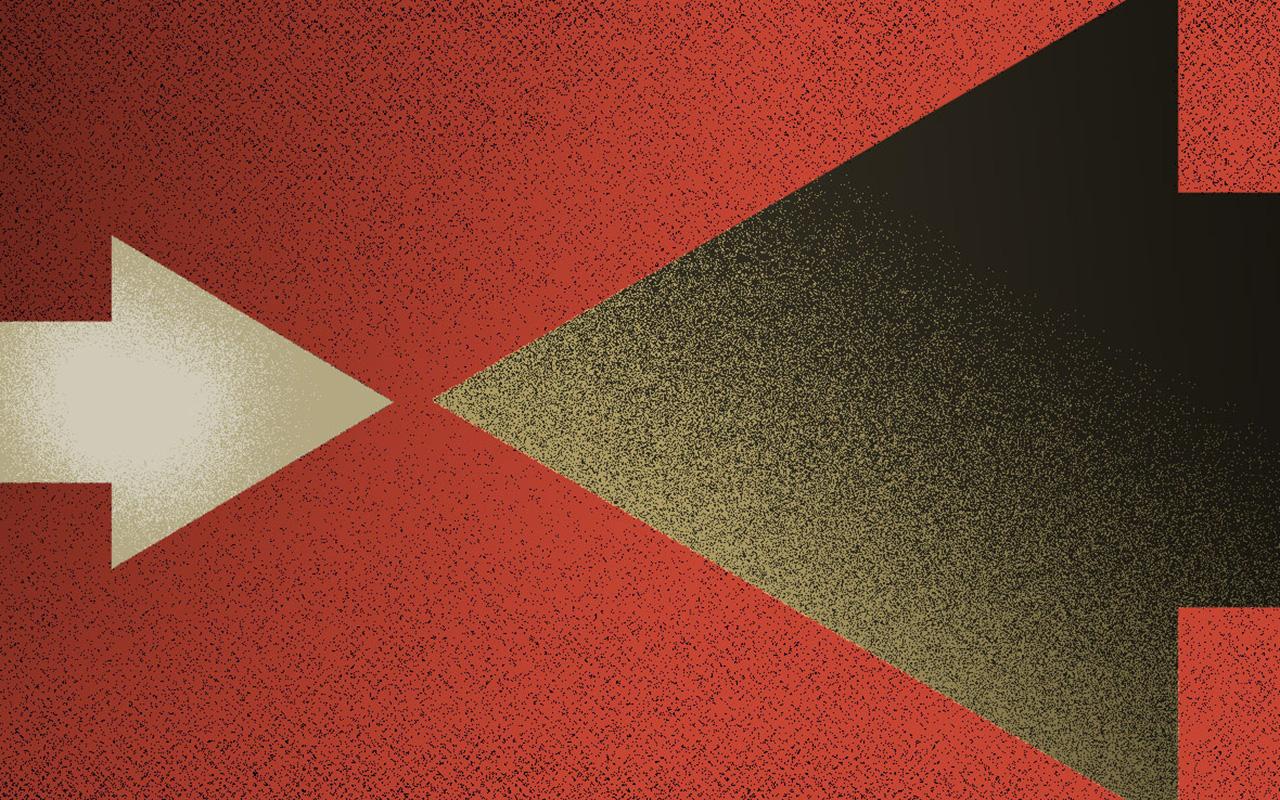ليلى العودات/ aljumhuriya- تُعدُّ الأحزاب السياسية أحد الأطر التقليدية الأساسية لتنظيم وإشراك الأفراد ضمن منظومة الديمقراطية التمثيلية، وتعتبرها كثيرٌ من المجتمعات، التي تملك حداً ما من الضوابط الديمقراطية، أداةً حتمية للربط بين الأفراد الذين تجمعهم رؤية سياسيّة معينة وبين نظام الحكم والسلطات الثلاث. ولا يمكن في هذه المجتمعات تخيّلُ نظامٍ سياسي فعّال بدون أحزاب سياسية منظمة.
وعليه، يُقبِلُ كثيرٌ من الأفراد على الانضواء تحت مظلّة الحزب، والالتزام بنهجه والدفاع عن ممثليه؛ حتى لو خالف في بعض الأحيان مواقفهم/ن الفردية، إذ تصبح مقاطعة الأحزاب بمثابة الخروج الطوعي من الحياة السياسية. وقد يصبح ذلك، خصوصاً في أوقات المخاطر السياسية الجمّة، بمثابة ترك الساحة السياسة والفضاء العام للقوى الشعبوية. أما في الدول التي تفتقد للضوابط الديمقراطية وفصل السلطات، فتصبح الأحزاب السياسية ذات طابع اختياري، أو رمزي في بعض الأحيان، ويفقد دورها التنظيمي حتميته، تاركاً للأفراد مساحة التفكر في فعالية الأداة وفي فعالية الديمقراطية التمثيلية المتهاوية ككل.
تفترض الديمقراطية التمثيلية بالتعريف أن بعض الأفراد قادرين/ات على عكس اهتمامات وأولويات مجموعات بشرية كاملة، والدفاع عن مصالحهم/ن ومحاربة مخاوفهم/ن، وتنظيم المجتمع في سبيل أن يؤخذ كل ما سبق في الحسبان. وبالرغم من كونها تقدم حلاً تنظيمياً لوضع المبادئ الديمقراطية موضع التطبيق عبر مؤسسات رسمية، فإن الممارسات السياسية في القرون الماضية وتجلياتها الحالية تبيّن أن تصميم المؤسسات السياسية التقليدية وآليات عملها وقفت عائقاً في وجه تحقيق القيم الديمقراطية؛ من حرية وعدالة ومساواة. ويتضح هذا الفشل، بشكلٍ خاص، في غياب العدالة الجندرية ومناهضة تحرير النساء والفشل في حمايتهنّ من الاجحاف التاريخي والتمييز والانتهاكات.
الأثر المُجحِف لشكل المؤسسات الديمقراطية الحالي على النساء
لا يعطي التصميم التقليدي لآليات الديمقراطية التمثيلية فرصاً حقيقيةً لتحقيق المساواة والعدالة، سواءً الجندرية أو الاجتماعية؛ كمناهضة الفقر والتمييز العنصري وغيرها، فقد بنيت هذه المؤسسات والهيكليات في فترةٍ سابقة لظهور الحراك العالمي لتحرّر النساء، والذي قام على مبدأ بسيط؛ مفاده أن النساء بشر، وأن الإجحاف الذي يتعرّضنَ له بسبب كونهنّ نساء لا يقل عن أية مظالم أخرى. و ربطت الموجة النِسوية الأولى هذا الإجحاف بغياب النساء عن المؤسسات السياسية الرسمية، وطالبت بتمثيلهنّ، ناخباتٍ ومرشحات، كحلّ مُقترح لهذه المشاكل.
وبُنِيَت هذه المؤسسات السياسية في ظلّ نظامٍ أبوي وطبقي مُهَيمِن، جعل الفضاء العام حكراً على الرجال، وقد طُوّرِت أدواتُها من قبل أجيالٍ متتالية من الرجال الذين، وإنْ كان كثيرون منهم يؤمنون بفهمهم الخاص (وربما الضيّق) للقيم الديمقراطية، لم تترك لهم امتيازاتهم الذكورية أيّ مساحة لفهم تجارب الآخرين والأخريات، وخاصةً تجارب النساء اللواتي غُيّبن عن الفضاء العام وحُصِرن في الفضاء الخاص المحدود.
في المحصلة، فإنّ أجيالاً من السياسيين والعاملين في الشأن العام عملوا من أجل تغييرٍ يحمي امتيازاتهم، أما أولئك الذين حاربوا من أجل الحقوق والعدالة، فقد فعلوا ذلك وفق فهمهم لهذه القيم عادةً، ومن مواضعهم وتجاربهم الضيقة كرجال من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المهيمنة في المجتمع. كما وضعت كثيرٌ من الأحزاب والتجمعات السياسية برامجها السياسية بناءً على افتراضها أنّ ما تريده النساء هو ما يريدونه هم، وأن آمال النساء تقتصر على رجالٍ مُمّكّنين وأحرار، وعلى أطفالٍ أصحّاء ببطون ممتلئة.
ومن الأمثلة الأكثر وضوحاً على ذلك توجّهُ العديد من الأحزاب اليسارية التقليدية في الدول العربية إلى تشكيل «اتحادات وروابط نسائية» على هامش الحزب، وذلك أُسوةً بالحزب الشيوعي الروسي في الاتحاد السوفياتي، حيث لم يؤدِ النضال والالتزام بالرؤية الحزبية وسنواتٌ طويلة من العمل (ومعدّلٌ أقل من الكلام عن الإنجازات مقارنةً بالرفاق) إلى حماية النساء من هذا الإقصاء والفصل المنهجي المهين. وأدى هذا الفصل إلى نتيجتين حتميتين؛ الأولى هي أن المنهج العام للجسم الأساسي للحزب خلا تماماً من قضايا النساء التي تُرِكت للكيان النسائي الرديف، والثانية هي أنّ وجود أجسام رديفة، كتلك التي تخصّ الشباب والشابات، عنى أن الجسم الأساسي للحزب هو المكان المنطقي للرجال كبار السن أصحاب الامتيازات، ويكاد يكون حكراً عليهم، وأن الآخرين والأخريات ممن لا يملكن/ون هذه الامتيازات هم دخلاء لا نُظراء.
بالإضافة إلى ذلك، في معظم الأحيان أُعطيت النساء في الأحزاب والمؤسسات السياسية أدواراً نمطية رعائية، تعكس فهم الرجال أصحاب الامتيازات لدور ومكانة النساء في المجتمع ككل. ولكن في الوقت نفسه طولبت الرفيقات اللاتي رفعنَ أصواتهنَّ لردّ المظالم الواقعة عليهنَّ وعلى باقي النساء بالانتظار حتى تنجح الثورة، أو إلى أن تسود الرؤية الحزبية أو المعركة التحرّرية، وذلك بافتراض أن العدالة والحرية والمساواة التي يريدها الرجال ستنساب بالتعدّي إلى فضاءات النساء الخاصة المحكومة بالصمت والتهميش، والمبعدة بالكامل عن القيم الديمقراطية والحماية والحقوق. كما اعتقدت القيادات السياسية أن واجبها، إلى أن يتحقق ذلك، مقتصرٌ على إتاحة مساحات نسائية على هامش الحراك أو الحزب أو المجموعة.
وهنا تظهر التساؤلات المعتادة: ألا تُهمّش المؤسسات والآليات الديمقراطية الرجال أيضاً؟ ألا تلعب الامتيازات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية والقبلية والجسدية وغيرها دوراً واضحاً في حظوظ التمثيل السياسي، تاركةً تعتيماً وتغاضياً عن تجارب كثيرٍ من الرجال كما النساء؟
الجواب هنا أنّ هذا صحيحٌ طبعاً، إلا أنّ تهميش الرجال يكون بالرغم من جنسهم، وليس بسببه. فلا يُقال للرجال الفقراء، مثلاً، إنهم لا ينتمون إلى المساحات السياسية لأنهم رجال، بينما تواجه جميع النساء، وبغض النظر عن الطبقة والمستوى الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي وغير ذلك من العوامل، كل ما يتعرض له الرجال من إجحاف، مُضافاً إلى طبقة أخرى كاملة من الإجحاف والإقصاء والتشكيك بالقدرات سببها الوحيد هو أنهنّ نساء: يقال لهنَّ إنه لا مكان للنساء في الوسط العام، وتُعزى مواقفهنّ المُحقّة لغيرهم، أما مواقفهنّ الخاطئة فتُردّ إلى كونهنّ نساء. ويُهاجمنَ بأسوأ الطرق وأكثرها بذاءةً وتهديداً وانتهاكاً، وتصبح حياتهنَّ الخاصة وحياة أسرهنّ مساحة مشروعة للعنف النفسي واللفظي والفيزيائي.
وبينما يندد الرفاق، أحياناً، بالعنف الذي تواجهه النساء في الفضاء العام حين يصبح أكبر من السكوت عنه، فإنهم يتغاضون في معظم الأحيان عن العنف الأقل تجلّياً، وكذلك عن اختلاف تجارب النساء في الوسط العام عن نظرائهنّ من الرجال. ويمكن الاستقصاء من سلوكهم العام أنهم يرون أن هذا العنف والعدائية هو ثمن طبيعي لاختراق النساء للفضاء العام، وهم لا يتساءلون لماذا يدفعون هم أقلّ من هذا الثمن بكثير!
تبدأ تجارب النساء المختلفة بالحدّ من مساحاتهنّ في فترة مبكرة من حياتهنّ في الفضاء الخاص الذي تشيع فيه الممارسات التمييزية وعلاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل، التي يفرضها النظام الأبوي ويحميها القانون والعرف والممارسة. ومن أكثر صور هذا التمييز وضوحاً هو التقسيم الاجتماعي غير العادل للعمل، حيث تقوم النساء تقريباً بكامل العمل الخدمي والرعائي غير المأجور داخل المنزل، بخلاف عمل الرجال المأجور دوماً.
وبدوره، يحرم هذا التقسيم النساءَ من الاستقلال المادي وحرية القرار الشخصي، ولا يضمن لهنّ عملهن الدؤوب والمضني هذا أي إجازات أو تعويضات أو ترقية أو تقاعد أو مكانة اجتماعية. ويقتصر التقدير المعنوي الناتج عنه على تكريم فردي خجول يرتبط دوماً بمكانة مُحدّدة في أسرة تقليدية (أم، جدّة، زوجة)، ولا يتعداه ليضمن أيّ نوع من الحماية في حال تغيّر شكل العلاقة مع مصادر هذا التقدير؛ أي الرجال أصحاب الامتيازات (زوج، أب، أخ أو ابن).
بالإضافة إلى ذلك، تحرم هذه المسؤوليات غالبية النساء من حقهن في الاستقلالية وحرية الخيار، وتضيّق مساحاتهنّ الفيزيائية لتقتصر على بيوتهنّ وبيوت الأقارب، أي على الفضاءات التي اعتُبر فيها العنف شأناً خاصاً لا يستدعي تدخّل الدولة حتى تسعينيات القرن الماضي. وينعكس ذلك أيضاً على عدم تمكن النساء من اقتحام المؤسسات السياسية التقليدية، فالوقت والجهد المبذولان في العمل المنزلي غير المأجور، وفي الخبرات والمهارات التي يتعلمنها لتأدية هذا العمل، لا يتركان الوقت أو المساحة المطلوبة لتنمية رأس المال الاجتماعي، أو لتطوير المهارات اللازمة للمشاركة في صنع القرار عبر المؤسسات التقليدية في الفضاء العام، مما يؤدي بالنتيجة إلى تقييد قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي في إمكانية جلب تجاربها وخبراتها إلى الوسط العام؛ من أجل أن يشمل التغيير المرجو المظالمَ الواقعة عليها لكونها امرأة.
يستدعي كسر النمطية السائدة في عمل المرأة في المنزل تغييراً على مستوى الدولة والمجتمع معاً، وتثبت التجربة أن الانتظار والاعتماد على مكارم من يملؤون الوسط العام لن تجلب هذا التغيير، وكذلك فإنّ الاعتماد على تغيّر سلوكي فردي أو جمعي تلقائي لن يحدث ببساطة. وقد يشارك بعض الرجال في بعض المهام المنزلية (قد نرى استثناءين هنا أو هناك، ونسمع عنهما إلى ما لا نهاية)، لكنّ الحقيقة أن تغيير هذا الإجحاف يتطلب أن تقوم كل جهة لها أثر مجتمعي، وعلى رأسها المؤسسات السياسية، بتغيير جذري لا مساومة فيه على صعيد القوانين والممارسات، وكذلك بفرض إجراءات إضافية جبرية من شأنها تحقيق توازن الفرص وعدالتها، واعتبار أي مكان يخلو من النساء غير صالح لاتخاذ قرارات حول أي مجتمع أو مجموعة، مهما كبر حجمها أو صغر.
نظرة مُعمَّقة في التحدّيات الواقعة على النساء في الفضاء العام
لا تقتصر العوائق أمام مشاركة المرأة في الفضاء العام على التقسيم الاجتماعي للعمل، بل تتعدّى ذلك إلى شيوع وقبول الممارسات التمييزية المتعصّبة للذكورة. وترى كثيراتٌ من النسويات هذه الممارسات أسلوباً واعياً وممنهجاً لإقصاء النساء وإرهابهنّ، ولردعهنَّ حتى عن محاولة المشاركة في الفضاء العام. ويتجلى هذا الأسلوب في فرض تكلفة نفسية واجتماعية ضخمة على النساء اللواتي يفكّرن بشغل مناصب سياسية، أو حتى القيام بمشاركات خجولة في الفضاء العام. وتتضاعف هذه التكلفة على النساء الحاملات لمظالم إضافية؛ سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو فيزيائية أو هوياتية.
وإذا كانت بعض النساء من ذوات الامتيازات والمتمتعات بحاضنات اجتماعية حامية قد وجدن حلولاً فردية لمواجهة أو تخفيف أثر العنف الذكوري الفادح الذي يصيبهنَّ في الفضاء العام، فإنّ العبء الواقع على النساء اللواتي لا يحملن هذه الامتيازات يصبح بمثابة الانتحار الاجتماعي. أذكر هنا أمثلة عن نساء في الفضاء العام يتم الهجوم على خياراتهنَّ الشخصية وانتهاك حرمات حيواتهنّ الخاصة، ويُهدَّدنَ بالاغتصاب علناً، ويواجهن سخرية بطابع جنسي، وتُقيَّمُ أشكالهنّ وملابسهن وأصواتهن بتنميطٍ مزرٍ يقترح أنّ النظرة العامة الذكورية لا تزال تنظر إلى النساء كأدوات جنسية، لا كندّ أو خصم أو حتى إنسان. بالمقابل تُوضع لهن معايير أعلى من الرجال بكثير للكفاءة والقبول والتمثيل.
من المثير للسخرية أن الفضاء العام المليء، حدّ التخمة، بالرجال أصحاب الامتيازات بكافة اشكالها، يستخدم أي امتياز لدى النساء كتهمة لاستبعادهنّ من المؤسسات السياسية، ولنعتهنَّ بالفشل في تمثيل عامة النساء في مجتمعاتهن المحلية، على الرغم من أن العنف الذي تُواجه به النساء بالذات هو ما يبعد أولئك الأكثر «تمثيلاً» عن الفضاء العام انتحاريّ الطابع. ومن نافل القول أنّ استبدال خطاب الحقوق بخطاب التمثيل يفترض، خطأً، أن النساء، على عكس الرجال، يشكّلن كتلة واحدة متجانسة لديها غايات متماثلة، وأن هناك نساء بقدرات سحرية، يستطعن الإلمام بها جميعاً وتمثيلها بتجانس واتقان، ويمكنهنّ جمع النساء، كل النساء، على رأي واحد، وجلب هذا الرأي بهدوء وأدب الى فضاءٍ عام لا يراهُنَّ أصلاً حاملاتِ حقوق. في الوقت نفسه لا يُسأل أيٌّ من الرجال إذا ما كانوا يمثلون جميع الرجال، ولا كيف يعملون بدورهم لجلب قضايا النساء أيضاً إلى الوسط العام الذي يحتلونه.
لا يقتصر العنف الواقع على النساء على من يشغلنَ المناصب الرسمية، فشيوع وسائل التواصل الاجتماعي عكسَ العنف والانتهاكات اللفظية المستشرية ضد النساء، وأعطاها منابرَ جديدة ووصولاً واسعاً. ويهدف هذا العنف إلى تعزيز الاستحقاقات والامتيازات الذكورية، وإلى تعزيز الصور النمطية المُقصية للنساء، والتي تحافظ على هيكليات القوى التقليدية، وتؤدي على المدى القصير إلى قيام النساء برقابة ذاتية شديدة، وإلى اللجوء للصمت الكامل على المدى الطويل.
ولا يقتصر هذا العنف والتهجم على الخصوم السياسيين، كما هو الحال بالنسبة للرجال، بل يتعداه ليصل إلى نساء يشاركن المهاجمين بالرأي السياسي، وقد يأخذ أشكالاً متفاوتة في الشدة؛ من التهديد بالاغتصاب والانتهاك والعنف الفيزيائي إلى الهجومات اللفظية ذكورية الطابع والتهكم والسخرية. والذي يجمع بين هذه الأشكال المختلفة أنها تصب جميعها في غايات متشابهة: هي تعزيز الاستحقاق الذكوري وثني النساء عن احتلال أي حيز من الفضاء العام، وعلى البقاء متأهباتٍ وخائفات في الحيز الضيق الذي يحتللنه بالرغم من كل ذلك.
ولا يظهر إلى العلن من التهديدات والانتهاكات والعنف المبني على النوع الاجتماعي وذي الطابع الجنسي الذي تواجهه النساء في الفضاء العام، بما في ذلك داخل أحزابهنّ، إلا ما ندر. وتكاد تنعدم آليات الرقابة والمساءلة حول هذه القضايا برغم تفشيها، وحتى عندما تُستحدث آليات للرقابة والمحاسبة، بعد قيام النساء بالتبليغ عن الانتهاكات، تفشل هذه الآليات في إيجاد مساحات آمنة لمن يجرؤْن على التبليغ بالرغم من معرفتهنَّ بأنهنَّ سيدفعنَ الثمن الأكبر لمقاومتهّن منظومات ذكورية تتوقع من النساء التحمل والصمت إلى أن تُحَلَّ «القضايا المصيرية الكبرى». وتبقى آليات حماية المُدّعيات وإنصافهن من الاتهامات والتعنيف والوصم والتهديد المُمارس من قبل أعضاء الحزب نفسه أو مواليهم السياسيين قاصرة أو معدومة.
ولا يختلف الوضع، للأسف، داخل الأحزاب التقدّمية التي تضع المساواة في مركز أجندتها السياسية. وأحد أحدث الأمثلة هو تعامل حزب العيش والحرية المصري مع إدّعاء التحرّش المرفوع من إحدى العضوات ضدّ مرشحه الرئاسي، وكذلك مع ادّعاءين آخرين بالاغتصاب رُفعا ضدّ أحد أعضاء الحزب. أستخدمُ هذا المثال فقط لحداثته، وللألم المضاعف الذي تركه في قلوبنا؛ لأن الحزب بدا يوماً مثالاً جيداً، ورفع في بعض مواقفه أجنداتٍ نسوية، وكذلك أَستخدمُهُ تقديراً لنضال الرفيقات النسويات المصريّات من أجل بيان قصور آليات الحزب، وذلك على الرغم من كل ما واجهنه من اتهامات بالتواطؤ والتقصير وخذلان الحزب.
لكنّ هذا المثال، على أي حال، ليس أسوأ الأمثلة، ولن يكون آخرها. ومن السهولة بمكان أن يوضح أي حديث في فضاءٍ آمن مع نساء منخرطات في العمل السياسي مدى التفشّي المريع لظواهر كهذه، وكذلك كمّ التجاهل والتعتيم المُمَنهَج عليها من قِبل الرفاق قبل الخصوم.
ولا أطلب هنا، بأيّ شكل، أن تكون النساء مُحصّنات من النقد والجدل والخلاف، بل أن يكون هذا النقد ندّياً وعادلاً، وألا يُعرّج على جنسهن، أو أن يترك المساحة لتحويلهن الى أدوات جنسية، وأن يأخذ بعين الاعتبار أيضاً مساحاتهنّ المختلفة، وأن يحاول فهم تجاربهنّ، ويترك مساحةً للوقوف إلى جانبهنّ في حال تعرّضن لعنف بسبب كونهنّ نساء، وذلك حتى لو كنّا نختلف معهنَّ في الرأي.
خيارات بديلة توجّهُ النساء إلى مساحات العمل المدني والحوكمي
بينما تستمر المؤسسات السياسية التقليدية في قصورها الواضح عن استيعاب واحتواء نضالات النساء وأدوارهنّ، ظهرت مساحات مدنية جديدة تحمل، من حيث المبدأ، قيم الديمقراطية ومبادئها، ولم يصلها بعدُ عقم هياكلها ومؤسساتها وأدواتها.
وشكّلت هذه المساحات فرصةً لاستيعاب محاولات النساء في جلب قضاياهنّ واهتماماتهن إلى قائمة مطالب التغيير في الفضاء العام. وجلبت النساء أيضا خبراتهن ومعارفهن والكثير من الطاقة والشغف والوقت والجهد، ووضعن على الطاولة تصوراتٍ مغايرة لهياكل القوى الحالية التي قد تترك المجال لتفشي العنف والظلم والعسكرة، وحققن نجاحات كبيرة وهامة، ولا تزلن.
إلا أنّ عولمة المجتمع المدني، وهيمنة الآليات الغربية بمفاهيمها المتأثرة بالاستعمار والرغبة في «إنقاذ» شعوب الجنوب و«توريد الحضارة» لهم على آليات تمويل وإدارة واستمرار المجتمع المدني، أدت على المدى الطويل إلى نزع التسيّس والفكر التحرري عن عمل المؤسسات القاعدية، وإلى زجّها في دوامات مفاهيم ضيقة للحياد والمهنية، أّدت إلى تحجيم دور النساء مرةً أخرى، ووضعهنّ أمام خيارات صعبة، وأعاد المساحة إلى صور نمطية عن نساء غير مسيسات، ونحّى العمل المطلبي في سبيل العمل الإغاثي؛ ليترك مرةً أخرى فراغاً لا يملؤه إلا إعادة نظر كاملة في المؤسسات السياسية والاجتماعية والإدارية.
ما الحلول؟
لا يوجد حلٌّ سحري ينزع عن الكوكب ذكوريته ويغيّر تجارب النساء فيه غداً، لكنّ إدراك المشكلة وأبعادها وهول أثرها هو خطوة أولى ضرورية، فلا شيء يتغير من دون كسر الصمت، وسيبقى رفع الصوت قولاً وكتابةً وتعزيز النقد الذاتي والجمعي عنصراً أساسياً في التغيير، وكذلك تبقى العرائض والبيانات والنقاشات والحملات العامة والمظاهرات أدواتٍ هامة لنقد الواقع المجحف والبدء بتغييره.
لكنّ التغيير لا يكتمل إلا بقرن القول بالفعل، والفعل هنا هو وقوف صارم لا لبس فيه في وجه الامتداد الذكوري المُتعصب، الذي سيخنق قيم العدالة والمساواة والحرية بالنسبة للجميع، لا بالنسبة للنساء فقط.
أما بخصوص تمثيل النساء في المؤسسات السياسية التقليدية تمثيلاً عادلاً، فهو شرطٌ لازم، ولكنه غير كافٍ لجعلها أداةَ لتحقيق العدالة الجندرية، فإضافة بعض النساء إلى آلية قاصرة ومجحفة لن يكون له أثر سحري لجعلها عادلة ومنصفة. ولا بد من قرن التمثيل العادل بتغيير جذري مستمر. وبدل أن ننقل قصور المؤسسات السياسية إلى المجتمع المدني، علينا أن نجلب انفتاح وحرية المجتمع المدني إلى الوسط السياسي، وأن نعزّز مساحاتٍ تسمح للجميع باعتياد التقاليد الديمقراطية والتعلّم المستمر والوصول إلى المحافل السياسية، وكذلك العمل على حثّ المؤسسات السياسية لقبول المعارف الجديدة، وتثمين المعارف القادمة من الفضاء الخاص أو من الفضاءات الأخرى المتاحة للنساء.
المحاسبة أيضاً هي عنصر هام في تغيير هذا الواقع، ولا أقصد فقط المحاسبة القانونية التي تقوم بها الدولة، والتي حصلنا على جزءٍ منها بفضل نضال النسويّات عبر القرون، بل أتحدّث أيضاً عن المحاسبة الاجتماعية، وعن وضع معايير جمعية حقيقية إزاء ما هو مقبول أو مرفوض اجتماعياً.
أفشل، رغم محاولاتي الكثيرة، في إيجاد مثالٍ واحد عن رجل بذيء عنيف ومعنّف ومتحرش أقصته أفعاله هذه عن المساحات العامة أو أبعدت عنه الرفاق أو أدّت إلى عزله اجتماعياً؛ إذ لا يزال هناك مزاجٌ عام من التسامح مع الذكورة العنفية المتعصبة.
هذه المحاسبة واجبنا جميعاً، ولا يجوز أن تقتصر على النسويّات اللاتي يُنعتن بالفاشيّة والهيستيريا، وغير ذلك من النعوت، كلما حاولنَ الوقوف بوجه هذه المهازل.
في الحقيقة، يجب أن يقع معظم العبء على الرفاق الرجال الذين يرفعون قيم الحرية والعدالة والمساواة؛ ليأخذوا مواقفَ واضحةً لا لبس فيها، أو لكي يتحمّلوا المسؤولية الأخلاقية لوقوفهم على هامش هذه القضايا الأساسية، ويُقرّوا بدورهم في تحوّل الفضاءات العامة إلى ما يشبه «مقاهي منتصف القرن الماضي».
من أجل أن نكون في ديمقراطية تقودنا نحو العدالة والمساواة، علينا إيجاد آليات يكون فيها حضور النساء عاملاً مؤسساً لا إضافة لاحقة، وأن يترافق ذلك مع وجود نقابات ومؤسسات تنظيم عمالية تثمّن العمل غير المأجور والعبء الاجتماعي الواقع على النساء، وتحمي القائمات به، وتخلق الفرص لتعميم هذا النوع من العمل وجعله عبئاً متساوياً مع الرجال، وتعويضه وتقدير الخبرات المبنية داخله وعكسه في الأجور والاستحقاقات. ولا أتحدث هنا عن النقابات الهزلية التي حُوِّلَت إلى جزء من أدوات هيكلية القمع، بل عن أدوات التنظيم العمالي القاعدية التي تنشأ لتحسين أوضاع العمال والعاملات وتنظيم الأجور والاستحقاقات وتحدي انتهاكات أصحاب العمل والدولة.
ولا بدّ أيضاً من إتاحة المساحة وتقديم الدعم للنضال النسوي الطامح لتغيير جذري في المجتمع، وإعادة تشكيل آليات وأسس ومنهجيات العمل السياسي بطابع نسوي، وليس فقط العمل النسائي الذي انحسر تحت سقف القبول الاجتماعي المنخفض. ويستدعي ذلك وجود عدد كافٍ من النسويات والنسويين في الفضاء العام ليفرضن/وا إعادة نظر جذرية لفهم القيم الديمقراطية بكماليتها، ومناهضة هرميتها الضمنية أو المعلنة، وإعادة تحديد الأولويات السياسية لتشمل أولويات الجميع.
الخاتمة
لا يحاول هذا المقال الهجوم على القيم الديمقراطية من حرية ومساواة وعدالة، بل على العكس: هو مطالبة بأن نُعيد النظر في قصور الآليات والمؤسسات السياسية، وذلك إلى أن نجد وسائل ومؤسسات وأنظمة بديلة تحقق القيم الديمقراطية في جوهرها.
وحتى يتحقّق ذلك، لا بد أن نعمل جميعنا، وعلى اختلاف مواضعنا ومساحاتنا وامتيازاتنا، من أجل قراءة أوسع للقيم الديمقراطية؛ حتى تصل الحرية للجميع، ولتكون المساواة كاملة والعدالة حقيقية وشاملة.
ويستدعي ذلك عملاً دؤوباً على المستويين الشخصي والجمعي، ومواقفَ واضحةً لا لبس فيها من الظلم بكافة أشكاله، ومن ضمنه تلك التي لا نختبرها في مواضعنا الحالية، ومساءلة حقيقية عن فهمنا لتجارب الآخرين، وتسامحنا، المقصود أو غير المقصود، مع اضطهادهم الظاهر أو الخفي.
ويستدعي ذلك أيضاً إعادة نظر أجسام التنظيم السياسي، سواء كانت أحزاباً أم غيرها، إلى تمثيليتهم وكفايتهم للاحتياجات، وإلى نظرة تاريخية للتخاذلات الكثيرة التي قاموا بها أو تجاهلوها، وإلى رؤى واضحة ومسؤولة لتفاديها والتعويض عنها.
وأخيراً يستدعي ذلك كسر حاجز الخوف من كل ما هو نسوي؛ فالنساء بشر، والمنظومات الإيديولوجية التي تضع هذه الحقيقة البسيطة في صلبها، وإن كانت غير مريحة ولا معتادة لكثيرين ممن نشأوا على امتيازات أنهم البشر الوحيدون، هي منظومات محقة وعادلة وتؤسس لمجتمعات صحية، وهي ليست بأي حال «هيستيريّة» أو «فاشيّة» أو «بيضاء».
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.