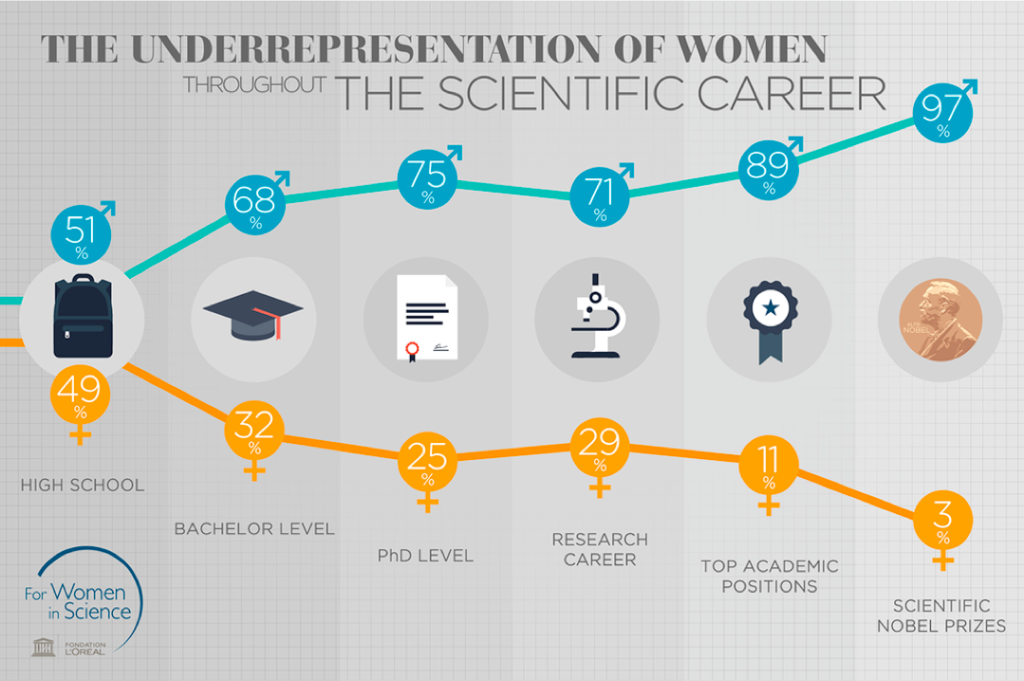ڤيندا جلبي/raseef22- في مدينة صغيرة عند أقصى شمال شرق سوريا، في مدينة عامودا، أو مدينة الشعراء والمجانين كما يحب أهلها تسميتها، ثمة حائط لا يتجاوز ارتفاعه متراً ونصف، كان يفصل بين حديقتَي بيت جدّي وبيت عمّي. كسائر الأطفال في العائلة، كنا نسلك الطريق المختصرة عند انتقالنا بين البيتين، ونقفز على الحائط وسرعان ما كان يتحول الأمر إلى لعبة أو سباق بيننا.
بالرغم من أن عمري لم يكن قد تجاوز العشرة أعوام عندما قفزت آخر مرة عن ذلك الحائط، إلا أن تلك المرة كانت كفيلة بأن أكتب هذا النص عن الحائط حتى بعد مرور أكثر من عشرين عاماً.
عندما قفزت إلى الطرف الآخر من الحائط، صرخت في وجهي امرأة بالكاد أعرفها، كانت جالسة في حديقة بيت عمي. هرعت إليّ توبخني على الفعل الذي اقترفته. لا أذكر كلامها بدقة لأنني حينها لم أفهمه أصلاً، كلمات غير مترابطة عن زوجي المستقبلي وعار للعائلة والمسكين أبي.
لكن ما أذكره، إنها سألتني ذات مرة إن كنت قد رأيت دماً بعد إحدى المرات التي قفزت فيها عن الحائط؟ نظرت ببداهة إلى يديّ وركبتيّ باحثة عن آثار دماء وجروح قديمة، لكنها أشارت إلى منطقة أخرى. أغضبتني وقاحتها حينها، وقلت لها: “ما دخلك! وأصلاً أنا ما رح أتجوز”، أجبتها وكانت بي رغبة أن أركلها في بطنها، وركضت مسرعة محاولة أن أنسى كلامها.
عُدتُ إلى الأطفال لأكمل اللعب، لكن شيئاً في داخلي منعني. خوفٌ ما بات ينتابني، شيءٌ في جسمي قد يتسبّب بكارثة وعار لي ولعائلتي إذا ما قفرتُ عن حائط! لم أفهم، لكنني بحدس طفلة شعرت بخطرٍ يتربّص بي!
لم ينتظر مجتمعنا كثيراً حتى بدأ يعطيني الدليل تلو الآخر. ومن منا لم يسمع بفتاة قُتِلَت لأنها جلبت “العار” لأهلها؟ أو امرأة طلب زوجها من أبيها وأخيها قتلها وغسل عارهما؟
كان الحديث عن الجريمة يجري بكل وضوح وبأدق التفاصيل، حتى أمامنا نحن الأطفال، والفعل الذي أدى إلى القتل أيضاً أمر مفروغ منه بالنسبة للجميع، دون أي كلمة أو تعليق أكثر من “الله يستر علينا”، وتساؤل إن كانوا قد مسكوها بالجرم المشهود أم لا.
برعبٍ كنت أستمع لتلك الأحاديث، وما الذي قد يخيف فتاة أكثر من اكتشاف أن أكثر إنسان يُشعرها بالطمأنينة قد يتحوّل إلى وحش ويقتلها؟
أبي الذي طالما كانت رؤيتي له في مكتبه مساءً مستغرقاً في كتاباته تُشعرني بسلام وأمان، هل يعقل أن يقتلني؟
حاولتُ أن أفهم من أمي وأن أحدثها عن خوفي، لكنها لم تخض في التفاصيل، كانت تجيبني: “لساتك صغيرة كتير على هيك مواضيع”، وأكّدت لي أن أبي يحبني ولن يقتلني أبداً، كما أنني لن أخطئ.
وكل ما في رأسي كان: “والفتاة التي قُتِلَت البارحة ألم يكن والدها يُحبُّها؟ ومن قال إنني لن أخطئ؟ ماذا لو نسيتُ وقفزتُ عن الحائط؟”.
في المدرسة أخبرتني صديقةٌ أنها كانت تريد أن تقود درّاجة أخيها لكن أمها أخبرتها أنه خطرٌ عليها كفتاة، وأن ذلك قد يتسبّب بتمزّق شيء ما، فكانت الفرصة أن أبوح لها بسرّي عن الحائط.
أثار الموضوع استغرابنا… لماذا لا يجوز أن أقفز أنا عن الحيطان ولا يجوز هي أن تقود درّاجة؟
وكانت الإجابة الوحيدة التي شكّلت لنا مبرّراً، بعد نقاش طويل كمحاولة لفهم الأسباب: أنا من عامودا وهي من القامشلي، وهناك اختلاف عادات لأن القامشلي تبعد عن عامودا مسافة 29 كم.
كنتُ طالبةً جامعية في العشرين من عمري، أدرسُ في دمشق، عندما سافرتُ إلى عامودا لأحضر عرس صديقتي، في ليلة الحنّة (الليلة التي تسبق العرس) كنّا جميعاً مجتمعين نغني ونضحك ونرقص، لاحظت توتّراً غريباً على صديقتي فسألتُها ما بها، فأسرّت لي أنها خائفة من المُصيبة التي ستحلّ بها وبأهلها إذا لم يَسِر كل شيء على ما يرام.
نظرتُ إلى خوفها وسألتها: “متى حصل هذا؟”، استغربت هي سؤالي، وقالت: “لا راح فكرك لبعيد كتير… خايفة يكون صار شي ونحنا عم نلعب لما كنّا صغار. خايفة كتير.. نسيتي كم مرة نطّينا على هداك الحيط”.
كانت جملتها الأخيرة كالصفعة التي أعادتني عشر سنوات إلى الوراء، لكنني ضحكتُ بتصنّع لم أتقنه في حياتي كتلك اللحظة، وقلتُ لها باستهزاء: “معقولة إنت؟ شو هالخرافات”.
لكن بنفس الوقت، عندما عدتُ إلى البيت ذاك المساء وأنا في حيرةٍ من خوفي: ما هذا الخوف؟ وأنا الفتاة الجامعية التي تدّعي الثقافة والانفتاح.
في برلين، عندما كانت صديقتي الألمانية ترقص وتغني وتضحك في عُرسها، تذكّرتُ الحائط وصديقتي في عامودا، تذكّرتُ كل تلك العرائس الجميلات اللواتي بدل أن يقضين أيامهنّ بسعادة وغبطة، يقضينها بإعادة شريط حياتهنّ، ليتأكّدن إن كان شرف العائلة في خطر أم لا، وإن كنّ قد ارتكبن جريمةً ما… كالقفز على حائط “متر ونص”!
أنا لم أُقتَل ولم تُقتَل صديقتي تلك، ولا صديقاتي الأخريات، ولا قريباتي، لكننا كلّنا عشنا ذلك الخوف، خوف أن نخطئ أو ننسى، الخوف على أنفسنا وعلى العائلة ومنها.
اليوم، أنا المرأة المتزوجة والأم لطفلين، أُعيدُ صياغة هذه المقالة أكثر من عشر مراتٍ، أحذف تفاصيل وأغيّر تعابير وكلمات لجعلها أقل استفزازاً… فأنا على ما يبدو، ما زلتُ خائفة.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.