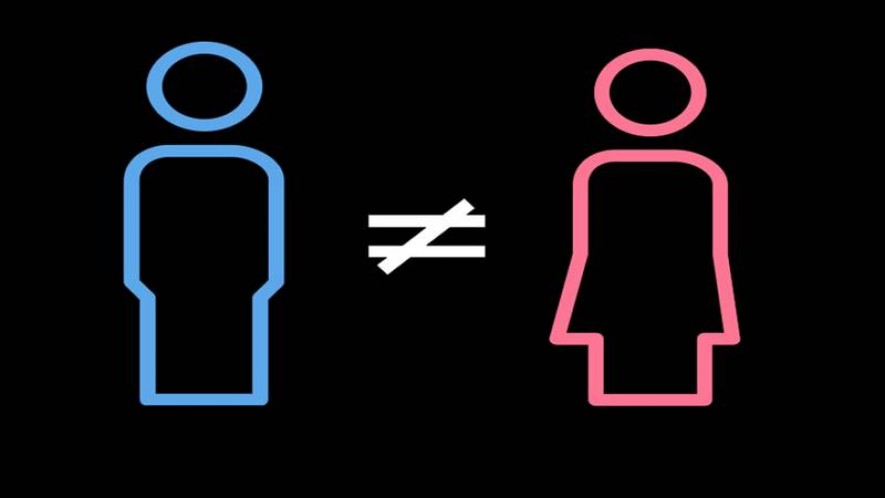مرح ماشي/ جريدة الأخبار- في عام 2008 قال «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» إنّ نسبة النساء المعيلات لأسرهنّ في سوريا وصلت إلى 11.2% تقريباً، اليوم تضاعفت النسبة مرّات في ظل الحرب واضطرار النسوة إلى تعويض غياب «الذكر المعيل». ازدياد المسؤوليات والأعباء لم يترافق مع تحسّن واقع المرأة في التشريعات السوريّة، من دون أن يشكل وصولها إلى «مناصب رفيعة» أيّ فارقS يُذكر..
تنهض صبا إلى عملها متثاقلةً كلّ يوم، فهي لم تألف بعد رطوبة الساحل رغم إقامتها فيه ثلاث سنوات. لا يمنعها ذلك من الحفاظ على ابتسامة عريضة ترافقها فيما تهتمّ بتفاصيل المنزل الذي تعمل مدبّرةً له. منذ سنوات هجرت السيدة الثلاثينية حلب محمّلة بالخيبات والمصائب، إلى اللاذقية حيث الأمان نعمة افتقدها الحلبيون طويلاً. قبل ذلك، كانت قد نزحت عن منزلها في أحد أحياء حلب الشرقية، لتستقر مع عائلتها في حي «أبعد عن الحرب». لكنّ القذائف عرفت طريقها إلى اثنين من أطفالها، فأذاقتها وجع الفقد والثكل.
«كيف تقف على قدميها، وتمضي إلى عملها بهذا التفاؤل»؟ يتساءل من يعرفونها، ويؤكد بعضهم أنّ «الابتسامة قناع. أحياناً تفقد توازنها النفسي، وتبدو كما لو أنها تنظر في وجهك ولا تراك». لا يمكن تجاهل حديثها عن منزلها الذي زارته بعدما وضعت الحرب في حلب أوزارها، فرأت أجزاءً متهالكة من طبقته الثانية فوق الطبقة الأرضية. إذاً كان لدى المرأة بيت من طبقتين، قبل أن تجد نفسها عاملة منزلية في مدينة أُخرى!. تُنهي جاراتها الحديث عنها بالقول «الله لا يجرّبنا».
إحدى أولئك الجارات زوجة شهيد مدني، وأم لأربعة أولاد، بلا معيل سوى راتب وظيفتها الزهيد. الثانية أم لطفل ضرير من ضحايا أحد التفجيرات، أما الثالثة فهي من محرّرات ريف اللاذقية. تقول إحداهن «منيح بعدنا بعقلنا. اللي الله عطاه عقل ما حرموا شي».
فلسفةٌ عصيّة على الفهم لدى من تصاب بالكآبة إن فاتها السفر احتفاءً بإجازتها السنوية، أو من فشلت في الحصول على هدية العيد الذهبية من زوجها الثري. ولكن أولئك النسوة «المتواضعات» يعتبرن أنفسهن متفوقات بالعقل والصبر، وهو ما قد تفتقده نساءٌ أُخريات لم يخسرن معيلاً أو ولداً.
«جندرة» غير مقصودة!
أثبتت السوريات قدراتهنّ على التوازن رغم كل شيء. لكنّ النتائج التي تمّ تحقيقها اقتصرت على النهوض من جديد لإعالة الأسرة، أو مواجهة المصائب بدموع أقل وابتسامة مواربة وتشجيع ذكور العائلة على المضيّ نحو حياةٍ جديدة، من دون انتزاع أيّ تشريعٍ أو قانونٍ يمنحهنّ حقوقاً أو امتيازاتٍ جديدة.
الظروف الطارئة كسرت تقاليد سابقة تحصر دور المرأة بالزواج والإنجاب والأعمال المنزليّة، واضطرّت البيئات المحافظة إلى القبول بعمل النسوة والسماح لهنّ بالاختلاط، بهدف إعالة أسرهن وتعويض غياب الذكور.. لكنّ «كسر المحرمات» هذا لم يأتِ بفضل ناشطي «النسوية» وناشطاتها، بل بفعل الحاجة إلى تعويض غياب الذكور عن سوق العمل، ببساطة.
أمّا وصول عددٍ من السيدات إلى مناصب عليا في البلاد، فلم يُثمر عن أيّ تقدّم مدني، فلم نسمع مثلاً عن مساعٍ حقيقيّة لتعديل قانون الأحوال الشخصية أو تغييره، رغم كلّ ما فيه من إجحافٍ بحقّ المرأة السورية.
قيادات نسائية «شكلية»؟
مع وصول هدية عباس إلى رئاسة البرلمان السوري قبل سنوات، تعالت الأصوات المتفائلة أول الأمر. لا يلزم تفكيرٌ كثير لمعرفة أن هذا التفاؤل لا يستند إلى أسسٍ حقيقيّة، لأنّ وصول المرأة السورية إلى أعلى المراكز، مقارنةً بدول الجوار، لم يؤثر إيجاباً على واقعها.
ورغم أن سوريا كانت سبّاقة في المنطقة لجهة وصول نسائها إلى مناصب نائب الرئيس، والمستشارة الرئاسية، ورئاسة مجلس البرلمان، فإنّ نسبة الأميّة في صفوف السوريات هي ضعف نظيرتها في صفوف الذكور، كذلك فإن المناصب نادراً ما أُسندت إلى مناضلين حقوقيين أو ناشطين أو منتمين فكرياً إلى تياراتٍ تهتم بانتزاع حقوقٍ مدنية ضرورية للنساء، بما يكفل النهوض بهنّ قبل الحرب وبعدها، فيما بقيت العلاقة بين النساء الحاصلات على مناصب قيادية والقاعدة الشعبية التي تضمّ السواد الأعظم من نساء البلاد شبه محدودة، رغم اعتناق بعضهن «الفكر النسوي» شكلياً، وبما يلزم الاستعراض في مناسبات شتى، الأمر الذي يوحي باستخدام المرأة من قبل السلطات السورية كواجهةٍ دعائية لتلميع صورتها أمام الرأي العام العالمي، بما يدعم موقفها في الحرب السياسية والدبلوماسية القائمة، والتي تضاهي شراستها الحرب العسكرية.
لا يتعدَّى حضور المرأة في مجلس الشعب نسبة 12%، أما حضورها الوزاري فلا يتجاوز 10%، وفي القضاء 18%. نسبٌ تفصيلية تحدّثت عنها الدكتورة إنصاف حمد في دراسةٍ موسّعة لصالح مركز «مداد» للأبحاث والدراسات، بناءً على سعة اطلاعها في هذا المجال، بعدما شغلت مناصب عدّة سابقاً، من بينها رئاسة «الهيئة السورية للأسرة والسكان»، ومشاركتها في عضوية المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الأممي ستيفان ديمستورا.
«أريد حلّاً»!
تلفت حمد إلى أن حضور المرأة وزارياً يتمثّل في إسناد حقائب تقليدية إليها، كالثقافة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بينما تبلغ نسبة مشاركتها في السلك الدبلوماسي 30%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد السفيرات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وتطرح حمد مشكلة الحساسية السورية من ارتباط قضايا المرأة بأجنداتٍ خارجية، وسط محاولات وكالات التنمية الدولية فرض أجنداتها وتمويلها «غير الشفاف». وتشير إلى أن نقاط الضعف البنيوية التي سادت عمل منظمات المجتمع المدني أنتجت فراغاً هائلاً تم سدّه بتجمعاتٍ نسائية دينية كـ«القبيسيات»، والتي تعيد إنتاج الثقافة التقليدية حول المرأة، بل وتضفي عليها طابعاً دينياً يؤبّد تلك الثقافة ويسم الخروج عنها بـ«الطعن في المقدّسات».
سيناريوهاتٌ مقترحة وفق آلياتٍ منظّمة هي أهم ما يميّز الدراسة المطروحة من قبل الدكتورة حمد، إذ إنها تطرح فكرة إنشاء وزارةٍ لشؤون المرأة، أو تعديل مهام «الهيئة السورية للأسرة والسكان» وتوسيع صلاحياتها، بحيث تصبح هيئة «المرأة والأسرة والسكان»، لافتةً إلى ما يتطلبه هذا الاقتراح من إعادة تبعية الهيئة إلى رئاسة الحكومة بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، لما في الأمر من ضمان استقلاليتها.
ومن مقترحات حمد إنشاء «اللجنة الوطنية للمرأة»، لتضمّ عدداً من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال النسائي، وإلحاقها بشكلٍ مباشر برئاسة مجلس الوزراء أيضاً.
وتختم حمد مقترحاتها لتحسين واقع المرأة بإحداث منصب مستشارة لشؤون المرأة في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة كخيارٍ أقل قوةً، لكن ذي فاعلية على أرض الواقع.