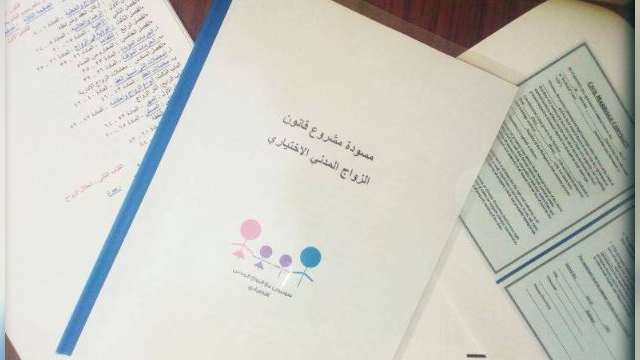هل هناك مقايضة بين حماية صحتك النفسية كناشطة حقوقية وبين الأداء الجيد لعملك؟ مساهمة من الحوار المفتوح الذي أطلقه منتدى openGlobalRights حول الصحة العقلية والرفاه النفسي لمدافعي حقوق الإنسان.
يـارا سـلاَّم/ أوبن ديموكراسي- بينما أتأمل ما قمت بالعمل عليه في مجال حقوق الإنسان، أتذكر أني تلقيت نصيحة بفصل مشاعري عن مهام عملي، بدون أي دليل أو إرشاد عن كيفية تطبيق هذا بشكل عملي. كيف يمكن للناشط الحقوقي أن يكون منخرطاً ومتحمساً في عمله وفي نفس الوقت لا يدع لمشاعره أي مجال للتدخل ويبقيها بمعزل تماماً؟ وهل هناك نقطة عند وصولها نصبح بمعزل عاطفي تماماً غير قادرين على التعاطف إنسانياً مع من ندافع عنهم؟
تخرجت في عام ٢٠٠٧، وحالفني الحظ بالعمل مع إحدى أساتذتي في مشروع بحثي متعلق بمرور النساء بتجربة اللجوء إلى المحاكم للحصول على الطلاق. وتطلب ذلك إجراء مقابلات مختلفة، سواء مع محامين أو مع نساء يلجأن لجمعيات حقوق المرأة، لعجزهن عن دفع التكاليف المادية للطلاق. لا أتذكر أنه تم تحذيري مما سأواجهه من مشاعر وقصص شخصية قد تؤثر عليَّ. في نهاية هذا العام، بدأت العمل في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في أول ملف لي هناك- حرية الدين والمعتقد. ولكن مجدداً لم ينبهني أحد إلى الثقل الذي سوف أشعر به لاحقًا. فلم أتلق أي تدريب أو نصيحة عن كيفية فصل نفسي ومشاعري عن مهام عملي، عدم الإعداد وقلة الوعي ظهرت آثارهم عليّ في سنين لاحقة.
تركت عملي في ٢٠٠٩ لاستكمال دراستي. رحلت من مصر محملةً بأول تجربة من الثقل الناتجة عن عملي؛ لقد كرهت تكرار نفس الاعتداءات الطائفية مرارًا وتكرارًا بنفس الشكل، وانتهائها بنفس الشكل الذي لا يحقق أي إنصاف للضحايا. تباعدت المسافات بيني وبين كل الشعائر الدينية التي كنت أقوم بها، والتي كانت تربطني بالمعتدين دائمًا. ونتيجة لكل هذا بدأت أفقد الصلة التي كانت تربطني بمشاعري الدينية. أصبحت مثقلة بالمكالمات والمقابلات التي تصف تكسير وحرق الكنائس، وطرد مجموعة من البهائيين من قريتهم.
ولكني عدت إلى مصر بعد بدء الثورة. وعملت في “نظرة” للدراسات النسوية. كان عليَّ أن أبدأ أول برنامج للمدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط . أتذكر حماس العمل على ملف جديد، ليس بالنسبة لي فقط، وإنما بالنسبة للمجتمع المدني في مصر، وشاركت الكثير من لحظات السعادة والأمل، والألم، مع فريق أعتز إلى الآن بعملي معه. إلا أنه سرعان ما بدأ العمل يتخذ منحًى آخر مدفوعًا بالإحساس بالذنب، وعدم كفاية ساعات اليوم للتعامل مع الانتهاكات التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان في عز انفتاح المجال العام وتواجدهم فيه. وتحولت الامتيازات التي نحملها إلى ذنب يجب التكفير عنه، بالاستمرار في العمل، ونتيجة للضغوط التي وقعت علينا من قِبل الإدارة أهملنا أي جانب يتعلق بالحياة الشخصية، سواء الصحة، أو إعطاء الوقت والمجهود لدوائر الدعم الحميمة كالأسرة والأصدقاء. وبسبب هذا الانهماك والإجهاد الشديد في العمل سرعان ما فقدت قدرتي على العمل في هذا المناخ السام، وقررت الرحيل. ولا أزال أشعر بالتقصير، المهني والشخصي، تجاه الفريق الذي عملت معه. فلم تكن لديَّ الأدوات ولا المعرفة الكافية لنتمكن جميعنا من تخطي ما سمعناه من شهادات، ولنحمي أنفسنا من تأثيرها على حالتنا النفسية وعلى حياتنا الشخصية. وكل عزائي هو أنني لم أستمر في هذه الحلقة المؤذية التي تُركت لتتفاقم، ورحلت كما رحلت بعدي العديدات نتيجة لنفس المشكلة.
بعد ذلك اختبرت وسيلة جديدة للتكيف: حاولت أن أتخذ مسافة واضحة وكبيرة بيني وبين مقابلة الضحايا والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر. ولكن هذا أثّر على عملي. عدت للعمل في المبادرة المصرية مرة أخرى، هذه المرة على ملف “العدالة الانتقالية”. ظننت أنني لن أضطر إلى سماع أشخاص يتحدثون عن أحداث مؤلمة مروا بها. إلا أن صيف ٢٠١٣ بموجات العنف التي قادتها الدولة والهجمات الطائفية لم يمهل أحداً.
أتذكر رفضي في بدء الأمر لقبول ما كان يحدث – فالإنكار والانفصال من آليات التكيف. وصل بي الإنكار أني حضرت حفل زفاف مغلاة في عدم تصديق أنني أعايش هذه اللحظات الدامية. لكني لا أستطيع التحديد بشكل حقيقي ما إن كان ما قمت به من توثيق في هذه الفترة كان جيدًا بالشكل الكافي، أم أن خوفي من ألم ما سوف أسمعه قد أثر على جودة عملي. فلم أستطع النزول، مثل باقي زملائي، لتوثيق أحداث العنف في أماكنها، بل اكتفيت بمن استطعت الوصول إليه عن طريق الهاتف. أعلم جيدًا أن ذلك لم يكن نابعًا من الكسل، أو عدم القدرة على الوصول إلى الأشخاص ومقابلتهم؛ بل كان نابعًا من الخوف من ربط هؤلاء الأشخاص بآلامهم في ذاكرتي، كما حدث من قبل.
أحسد بشدة من يستطيعون التعامل مع “حقوق الإنسان” كمجال عمل فقط، أو كموضوع خاص بالدراسة والعمل الأكاديمي بشكل بحت. وأكاد أجزم أنهم أقل معاناةً، ولديهم قدرة أكبر مني على الاستمرار في العمل. إلا أنني لا أستطيع إلى الآن فصل نفسي عن ما أعمل عاطفياً أو نفسياً. وربما لهذا السبب لا أزال أحاول الابتعاد عن توثيق شهادات الضحايا والناجين.
قابلت منذ عدة أشهر إحدى الزميلات للحديث عن عمل مشترك، لم نتمكن في النهاية من القيام به، بسبب تأثير عملها عليها، واحتياجها للتعافي من تأثيره. هذا هو الجانب الآخر للصورة: أن نقع تحت تأثير الصدمات العنيفة فنفقد قدرتنا على العمل بشكل لائق. إذن أين الحل الوسط؟
ليست لديَّ إجابات بعد، لكن لديَّ رصيدًا من التجارب السيئة التي تسمح لي بطرح الأسئلة ومحاولة البحث عن إجابات. وأعلم أن آخرين وأخريات يبحثون أيضًا، على أمل أن نستطيع إيجاد مساحة آمنة نعمل بها بدون أن نفقد ارتباطنا الإنساني بما نقوم به.