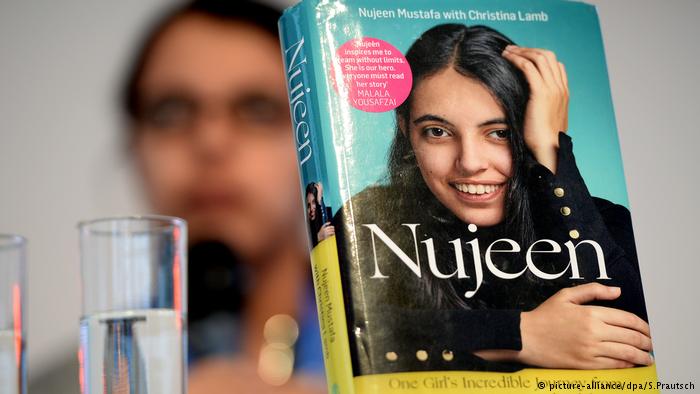زينة السلماني/ raseef22- أكتب رسالتي هذه، وأنا في الثلاثين من عمري، إلى بعض المعلمين الذين عرفتهم في طفولتي وتركوا أثراً لا يمكن محوه.
عندما كنت صغيرة، كان من العادي في المدرسة أن نُضرب بسببٍ أو بدونه.
وعندما أتذكر أسباب الضرب، أجد تقريباً أنه لا ناقة لي ولا جمل.
ضُرِبتُ مرةً لأنّ كل الفصل كان يتحدّث، دون أن يتمّ التأكّد إذا كنت قد شاركتهم التشويش أم لا.
وضُرِبتُ مرةً لأنني لم أُكمل كلَّ الواجب.
وضُرِبتُ مرةّ لأنني لم أحضر معي نقود صندوق التبرّعات. إذا كانت التبرّعات تطوُّعاً، لماذا أُضرَب إذا نسيت إحضارها؟
وضُرِبتُ مرةً لأنني كنت أنظر لزميلةٍ كانت بصدد تناول نصيبها من الصفعات.
لكن أكثر موقفٍ أذكُره، عندما كنت أقف في الطابور أرتجف رعباً من المعلم القادم وماسكةً دفتراً، فبادر بصفعي أمام الجميع. كانت الصفعة قويّة، نزلت على عيني وأذني. أمسكتُ خدّي الذي احمرّ وتورّم، نزلَت دموعي وحاولتُ منعها. غصّةٌ خانقة تكاد تقفز من فمي كضفدعة. طأطأتُ رأسي وأنا أحاول كتم ألمي وأتحاشى نظرات زملائي المُشفِقَة.
تعدّدت وسائل العنف والنتيجة واحدة: مرةً صفعة، عصا خشبية يكون مصدرها أثاثاً قديماً، أو غصن زيتون ثم يُنقَعُ في الزيت ليزداد قساوةً ومرونة، حزامٌ جلديٌّ قديم، ركلٌ بالساق، سلك كهرباء وحبل. تنوّعٌ هائلٌ من أجل تحقيق هدف واحد وهو “تربية الأطفال” الذين عجِزَ أولياؤهم عن ذلك وإرجاعهم للصراط المستقيم.
من المُضحكات المُبكيات أنّ هناك تلاميذ كانوا يبادرون بإحضار أدوات التعذيب للمُعَلّمين ظنّاً منهم أنهم بذلك يتقرّبون إلى السلطة التعليمية. ثم لا نلبث أن نسمع أن التلميذ العميل الذي سلّم العصا للجلاد، نال نصيبه من الإهانة.
لا يوجد إحساسٌ أسوأ من الظلم، ما الذي جناه التعليم من ضرب التلاميذ؟ هل أصبحنا علماء خاصةً في المواد التي كنا نُجلَدُ فيها؟ هل تطوّرت الصناعة؟ هل قفزت الدول العربية إلى مصاف الدول المتقدّمة؟.. طبعاً لا.
الذي حصل أنّ آلاف الأطفال انتُهِكَت كرامتهم وتحطّم كبرياؤهم. أخرجتم جيلاً من المعقَّدين نفسيّاً يظنّون أنّه بالعنف تحلّ المشاكل وتُبنى الحضارة.
هل تعلم عزيزي المعلم، الذي من المفروض أن تكون رسولاً، أنّ العنف هو أنك تقول لشخصٍ ما: أنا أقوى منك؟ لماذا اخترت طفلاً صغيراً لا حول له ولا قوة لتُعلِنَ جبروتك؟ ولماذا منحك المجتمع السلطة المُطلقة لتُعامِلَ الأطفال معاملة العبيد؟
أذكر يوماً أنني سمعت معلّماً يدافع عن ظاهرة تفشّي العنف المدرسي بقوله إنّ المعلم أيضاً يتعرّض لضغوط نفسية ومشاكل جمّة خارج المدرسة وداخلها، ما يدفعه إلى التنفيس عن ضغوطاته على التلاميذ.
كلما أذكر هذه القصة أذكر قصص ألف ليلة وليلة؛ عندما يقال: وضحك الرشيد حتى استلقى.
هل جُعل الأطفال للتنفيس عن غضب المعلّمين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما دور الأطباء النفسيين؟
لربما إخراج الضغوط النفسية على الأطفال هو أكثر توفيراً للنفقات من الذهاب إلى العيادات النفسيّة باهظة الثمن. فعلاً فالرواتب غير كافية لتغطية تكاليف معيشية آخذة في الارتفاع.
أصبحت المدارس رعباً والتعليم عبئاً والمعلّم غولاً يكسر عظامنا باستخدام وسائل متنوّعة: مرةً عصا، مرةً صفعة ومرةً حزام جلدي.
أكثر ما كنت أتعجّب منه هو إحساس الجلَّاد عندما ينتهي من تعذيب ضحيته، كيف يعود إلى منزله؟ وكيف تحلو له الحياة؟ ثم يأتي ليقف بكل ثقة بالنفس ليقول إنّه كان مشرفاً على تربية الأجيال، أجيال من المعقدين نفسيّاً يحملون بين طيّات قلوبهم أوجاعاً لا تُشفى وإهانة لا تُغتَفر.
من المُضحكات المُبكيات أنّ هناك من يبرر للمعلّم ضرب التلاميذ بحجّة تربيتهم وهدايتهم للصراط المستقيم، ويكون الادّعاء: “لو لم تخطئي لما اضطّر المعلّم إلى تأديبك!”… ويبقى السؤال ما هو الخطأ الذي يستَوجِبُ أن تتورّم اليد وتدمع العين؟
مرّت السنوات وظللت أفكّر في هذه الصفعة وكنت أتمنى أن أردّها له إن استطعت، لعلَّه يحسّ بمعنى الظلم.
في كلّ مرة يتم فتح ملف الأطفال ضحايا العنف المدرسي، تتعالى الأصوات الرافضة للتعرّض لهذا الموضوع بحجّة تشويه صورة المعلّم من ناحية، ومن ناحية أخرى، يشيد الكثيرون من ضحايا العنف بدوره في صقل شخصياتهم ودفعهم للمُضي قدماً في حياتهم نحو الأفضل، ويكون المبرّر دائماً: “كنا نُضرَب لسببٍ أو بدونه، وكبِرنا وأنهينا دراستنا وها نحن بخير. دعوهم يعنّفون الأطفال لعلهم يستقيمون ويدركون قيمة العلم. فهذا جيلٌ عنيد وقليل أدب ويحتاج التربية السليمة”. وهل تأتي التربية بالسوط؟
من الأمور التي تدعو إلى الاستغراب هو عزوف الضحايا وأولياء الأمور عن التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرّض لها أطفالهم. بالنسبة للطرف الأول، فالسبب يكمن وراء جدار الخوف الذي نجح المجتمع في بنائه ليكمّم الأفواه، أما الطرف الثاني وهم الأولياء، فيَخشون من ردِّ فعلٍ انتقامي للمعلّمين، سواء بتكرار العنف أو بإسناد درجاتٍ منخفضة للطالب.
ومن يقبّل بالذل والهوان من أجل الحصول على علامةٍ كاملة، هو نفسه الذي يكبر ويرضى بالاستبداد والاستعمار مقابل فتات.
وهذا الخوف أدّى إلى تفاقم هذه الظاهرة وإلى توسّعها وانتشارها لتشمل أشكالاً أخرى من العنف، كالتحرّش والاعتداءات الجنسيّة، فمتى ستستيقظ الشعوب العربية النائمة لتُدرك خطورة الجرائم التي تنتهك حقوق أطفالها؟ ومتى ستعلم أنّ من يدّعي أنه بجَلْدِه للتلاميذ يربّيهم ويؤدّبهم، إنما هو يقوم بإنشاء جيلٍ قابلٍ للذلّ والمهانة والاستعباد؟
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.