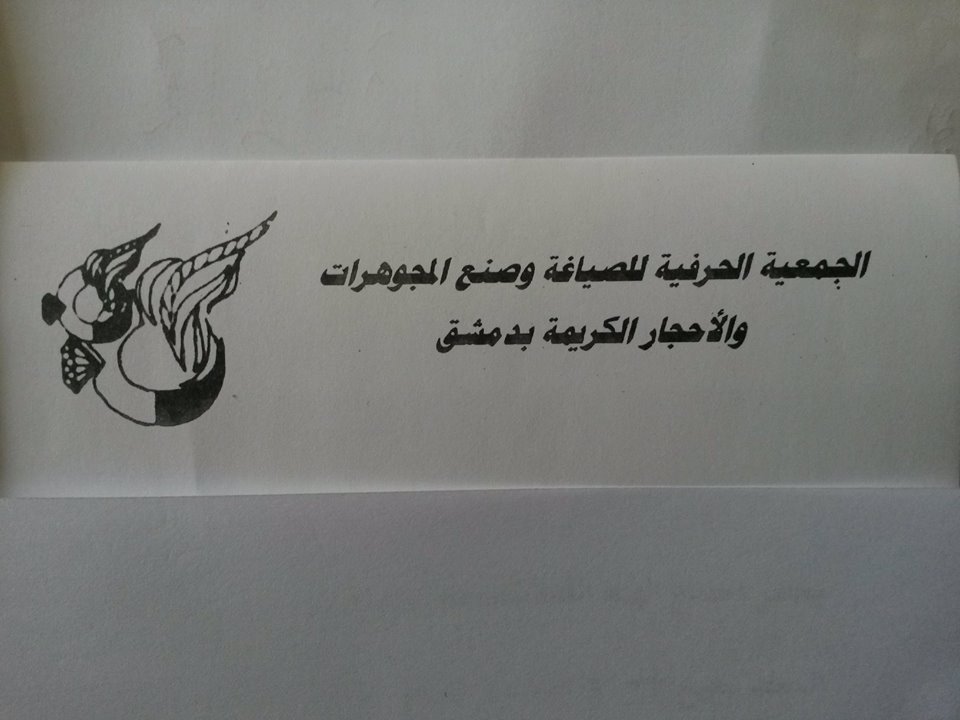رشا عمران/diffah.alaraby- حين انتهيت من قراءة الكتاب البديع للشاعرة المصرية إيمان مرسال “في أثر عنايات الزيات” (صادر عن من منشورات كتب خان 2019 في القاهرة وصدرت منه لاحقًا عدة طبعات، وصدر أخيرًا بترجمة فرنسية عن دار أكت سود بترجمة ريتشارد جاكمون)، تحفزت ذاكرتي بقوة، في محاولة لتذكر كاتبة سورية قد تكون حكايتها شبيهة بحكاية عنايات الزيات، تلك السيدة التي اقتفت إيمان أثرها بإصرار مثير. فكرت بداية بالشاعرة السورية سنية صالح (1935/ 1985، ماتت في باريس إثر معاناة مع السرطان) لكنني تراجعت عن الفكرة سريعًا، فسنية صالح هي زوجة الشاعر السوري محمد الماغوط، وشقيقة الناقدة خالدة سعيد زوجة أدونيس، وصدرت لها عدة مجموعات شعرية، كما صدرت أعمالها الكاملة قبل أعوام قليلة عن دار المدى للطباعة والنشر، ورغم أن موهبة سنية صالح قد لحق بها الإهمال والتهميش أثناء حياتها لصالح زوجها (الماغوط) ومورست عليها بطريركية ثقافية بشكل واضح، (تقول في إحدى قصائدها: “إنك من الزرنيخ يا سيدي/ أفتح فمي كل صباح وأبتلع جزءًا منك/ ولم تنته/ قلت سيأتي يوم أتوحش فيه/ وأفترسك/ ثم استريح”؛ في تماه صريح بين الرجل /الذكر والمرض الذي عانت منه)، إلا أنه تم إنصافها لاحقًا إلى حد كبير، من قبل النقاد والشعراء، لا سيما الأجيال الجديدة المتخففة كثيرًا من أثر الثقافة الذكورية والفحولة الشعرية لصالح الشعر الهامشي والعذب واليومي، هكذا لم أتمكن من تطبيق الفكرة المذهلة لإيمان مرسال على سنية صالح، فسنية لوحقت آثارها وأنصفت ومنحت بعض حقها أو كثيره، بينما عنايات الزيات لم يعرفها سوى قلة قليلة جدا أحيتهم إيمان مرسال في كتابها الممتع، بعد أن أصبحت ذاكرتهم عن عنايات الزيات في المقابر أو في أرشيف جرائد يشبه المقابر.
حين استبعدت سنية صالح فكرت بشاعرة سورية أخرى قالت عن نفسها ذات يوم: (أنا من تحمل الزهور إلى قبرها وتبكي من شدة الشعر)، غير أن دعد حداد (1937/1991)، مثل مواطنتها سنية صالح، أعاد لها شعراء الأجيال الجديدة حقها في الحضور الشعري السوري والعربي، بعد تغييب طويل لها من قبل مجايليها من فحول الشعر السوري، ورغم أن سيرتها الشخصية وعلاقاتها ضمن الوسط الثقافي السوري، تستحق اقتفاء الأثر، لما فيها من معاناة تركت أثرها الكبير على قصائدها وعلى كتابتها المسرحية (صدرت لها أربع مسرحيات وثلاثة كتب في الشعر كان آخرها بعد رحيلها)، ولكن الأكثر أهمية هو ما في سيرتها من اتهام صريح لمثقفي جيلها، الذين تجاهلوها تمامًا في حياتها، مع محاولاتها الدائمة والفاشلة لإثبات حضورها رغم موهبتها الفذة والخاصة، ثم كتب غالبيتهم عنها بعد رحيلها (ماتت وحيدة ومشردة) متحدثين عن تلك الشاعرة المتفردة، وكأنهم كانوا يريدون تقديم صك غفران لضمائرهم عن تاريخ التجاهل والإقصاء الذي مارسوه بحق دعد حداد، ومثل سنية صالح صدرت أخيرًا أعمالها الكاملة عن دار التكوين في دمشق، في إعادة اعتبار لقيمتها الشعرية وفرادتها كشاعرة أنثى تنتمي إلى جيل سبعينيات القرن الماضي الشعري، الجيل الضائع بين شعراء الستينيات والثمانينيات، الجيل الذي لم يستطع التمرد على ذكورية وفحولة (الستينيين)، وإن كان شعريًا ينحاز إلى الهامش دون أن يلمع (هامشه الشعري) كما الأجيال اللاحقة، (الاستثناءات قليلة)، ومن الغريب أن معظم من بقي من هذا الجيل على قيد الحياة كان له موقف معارض للثورة السورية أو مؤيد لها في صمت، هل هذا مرتبط بحالة المراوحة بين ذكورية جيل الستينيات ونخبويته وتمرد الأجيال اللاحقة؟!
هكذا استبعدت أيضًا دعد حداد من ذهني، وكنت قد بدأت أنسى ذلك الخاطر في البحث عمن يمكن في سورية اقتفاء أثرها من الكاتبات أو الشاعرات على طريقة عنايات الزيات، لولا أنني تذكرت سميرة عزام! نعم سميرة عزام! أعرف أن معظمكم سوف يخطر له، عند قراءة الاسم، القاصة الفلسطينية سميرة عزام، وسوف تستغربون لماذا أعتبرها سورية أو مجهولة، لكنكم سوف تكتشفون أنني لا أتحدث عنها، بل عن شاعرة سورية ماتت شابة وتحمل نفس الإسم: سميرة عزام، والمفارقة أن سميرة عزام الشاعرة السورية ولدت في نفس العام الذي رحلت فيه سميتها الفلسطينية- 1967، وللمفارقة أيضًا أن الاثنتين لم تعيشا أكثر من أربعين عامًا، ماتت الشاعرة السورية في عام 2008، بينما ولدت القاصة الفلسطينية عام 1927 وماتت كما أسلفنا عام 1967 عام الهزيمة الكبرى.
قلة من السوريين سمعوا بها أو قرؤوا ما كتبت الشاعرة سميرة عزام في حياتها القصيرة، ولا أحد يعرف عن سيرة حياتها شيئًا، حتى أن محرك البحث غوغل يحيلنا لدى كتابة اسمها إلى سميتها، القاصة الفلسطينية، ولا يقدم لنا أية معلومات مفيدة عنها سوى مقالة يوم رحيلها مع صورة وحيدة لها، أو عن ديوانها الوحيد (“سيرة الآس”، صادر عن وزارة الثقافة السورية عام 2002)، أو عن تواريها وعدم رغم موهبتها الواضحة، وهو ما يطرح السؤال عن الكثير من المجهولين في الشعر السوري والعربي، ممن لم يلتفت إليهم أحد، أو رحلوا قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منبرًا مهمًا للجميع، ولم يعد بإمكان أحد، معها، الإدعاء بأنه مهمش ولا يهتم بتجربته أحد، إذ استطاعت صفحات العالم الأزرق المساواة بين الجميع من حيث الانتشار والشهرة (الافتراضية)، بل هي حولت أصحاب مواهب شعرية متواضعة إلى نجوم في عالم الافتراض، ما جعل العديد من مواهب ما قبل العالم الأزرق تذهب طي النسيان، خصوصًا وأن أرشيف الجرائد الورقية العربية، في معظمه، قد أتلف، ولم يبق مما دُوّن فيه أي أثر.
يرمز (الآس) في الثقافة السورية المجتمعية إلى المقابر، حيث يوضع نبات الآس/ الريحان، على قبور الأحبة في الأعياد والمناسبات، وهو غالبًا ما يحيل، في الاستخدام الأدبي، إلى سردية الموت. عانت الشاعرة سميرة عزام من الشلل النصفي المفاجئ، كانت “في طريقها لمقابلة الروائي السوري المعروف ممدوح عزام”، حسب ما ذكر في مقال وحيد موجود على غوغل يوم رحيلها، ثم استطاعت التغلب عليه لمدة، لكنها ماتت فجأة أيضًا إثر جلطة دماغية، وربما كانت تدرك أنه مرضها المميت، وأن وجودها على الأرض قصير، وهي القائلة في ديوانها الوحيد: (بين اللقاء والوداع/ يتعلم المرء طقوس المسافة)، ثمة الكثير من سيرة الموت في قصائد الديوان، (حدثني قليلًا عن الأمل/ وعانقني قبل أن يداهمني الليل فجأة/ لقد اقتربنا من خط النهاية/ وعند النهاية فقط يعرف المرء طعم العناق)، هل لهذا أسمت ديوانها الوحيد (سيرة الآس)؟ يمكننا، كقراء لا نملك ما يجعلنا نكتشف سيرة حياة هذه الشاعرة، سوى أن نخمن ذلك، أو أن نفعل ما فعلته إيمان مرسال في اقتفاء أثر عنايات الزيات، بيد أن لا شيء في سورية الآن يتيح أمرًا كهذا، لا مع سميرة عزام ولا مع غيرها، ربما يحدث هذا ذات يوم، حين تتعافى سورية ويتعافى السوريون، سوف يوجد من يقتفي أثر مبدعين سوريين لم تنصفهم أزمانهم، وهو أمر لا يبدو واضحًا في الأفق القريب على أية حال، إذ ما نفعله حاليًا جميعنا هو اقتفاء أثر سورية نفسها بعد أن تكاد تصبح في طي النسيان.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.