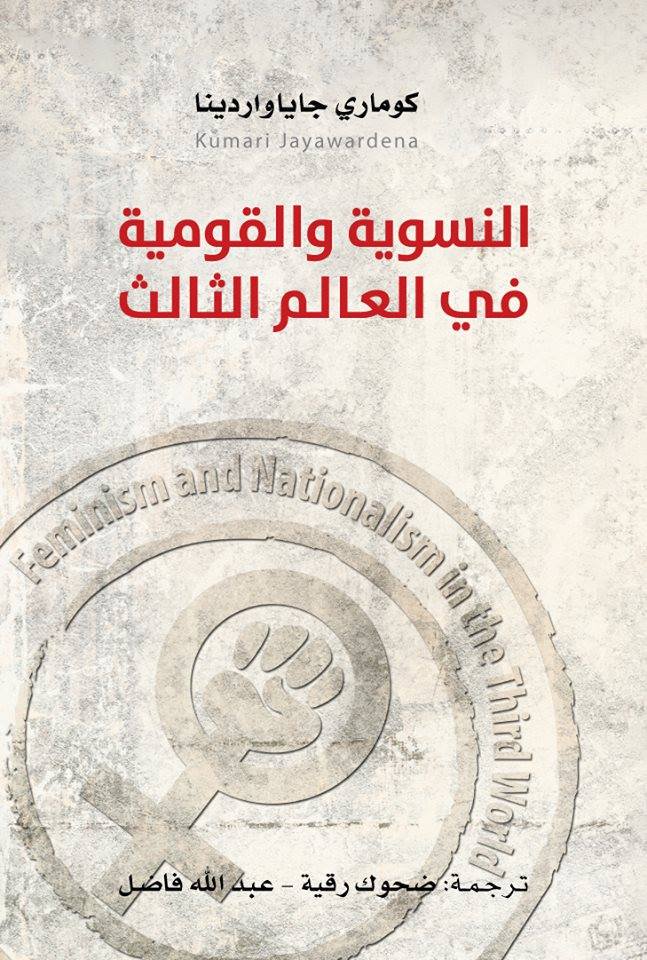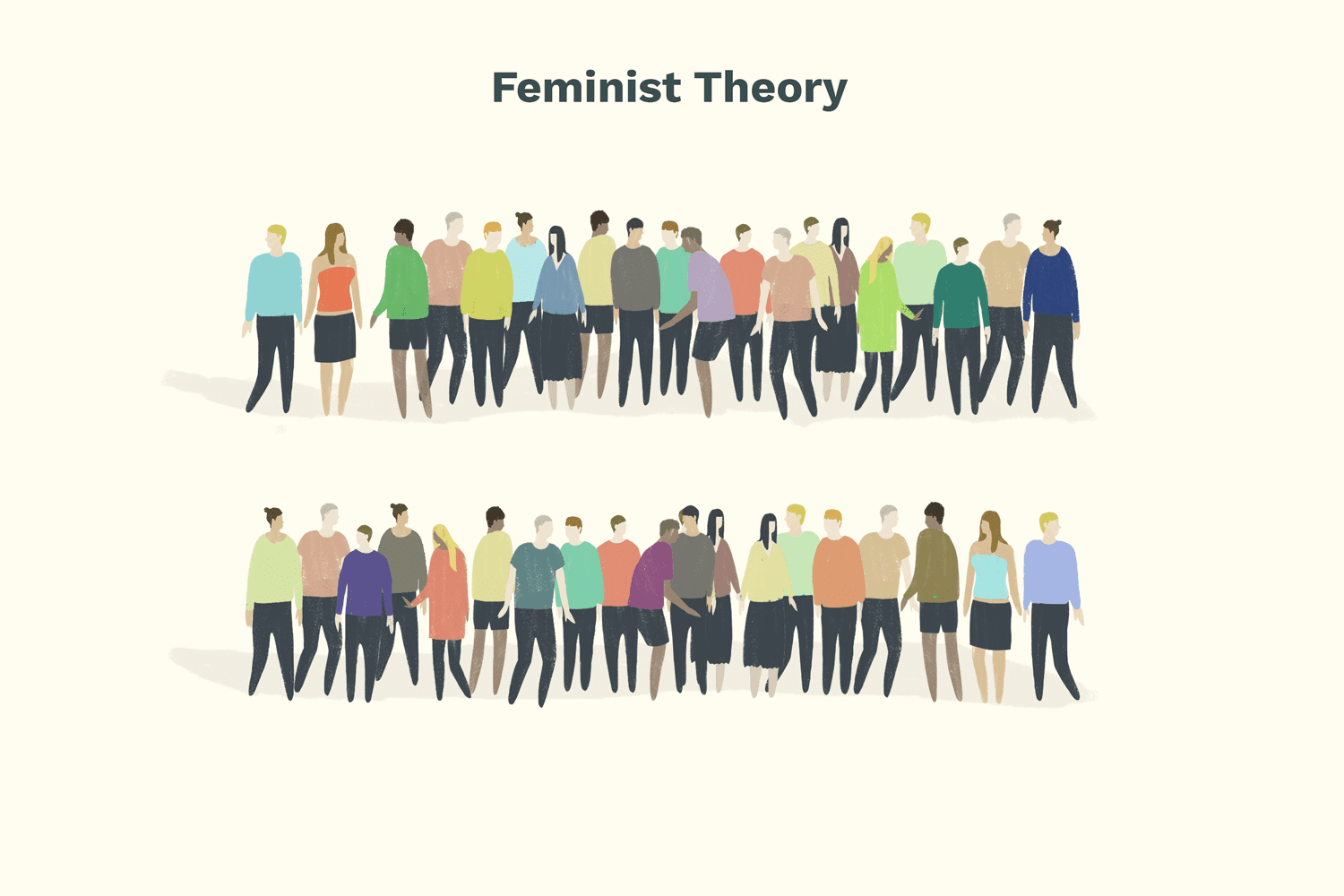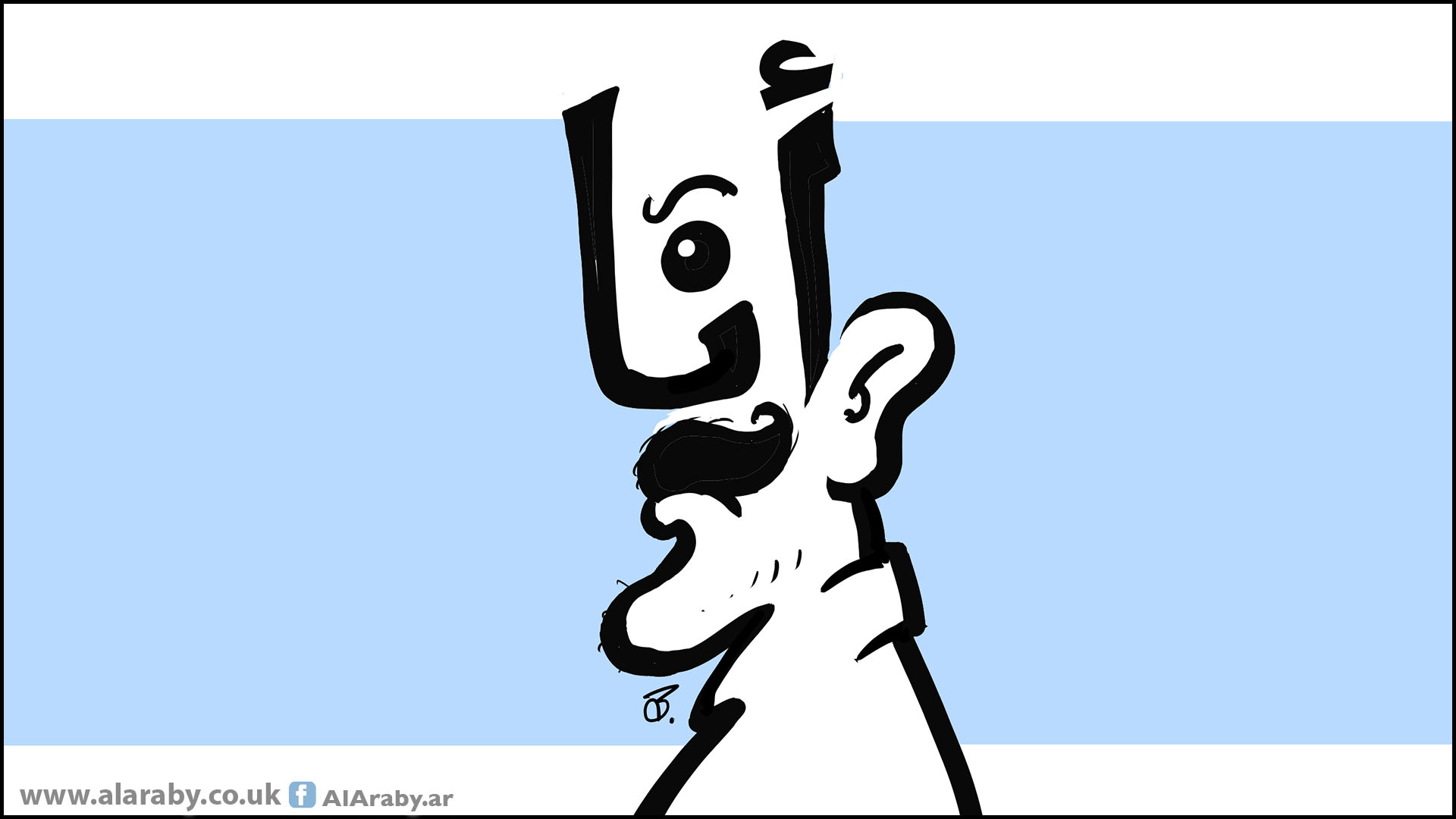خديجة الحربي/ مجلة الفيصل- في الوقت الذي تبدو فيه نظرية كثير من التيارات العربية المحافظة حول المسألة «النسويّة»، وقضاياها، رائجة إلى حدٍّ كبير، وذلك لكونها مسألة مستوردة غربيًّا، وإرث خلّفه الاستعمار بعد خروجه من بلدان العالم الثالث على وجه الخصوص، تُثير الكاتبة السريلانكية كوماري جاياواردينا، قدرًا كبيرًا من الشكوك والأسئلة حول ذلك في كتابها المترجم مؤخرًا إلى العربية: «النسويّة والقوميّة في العالم الثالث»، والصادر عن دار رحبة السورية. هذه الشكوك والأسئلة القائمة على تاريخ ضخم من الحركات الاجتماعية في هذه البلدان سابقة على الاستعمار، بل في أحيان أخرى سابقة على الحركات الاجتماعية الغربية، إن لم تكن في موازاة لها، وذات تأثير متبادل معها، التي من شأنها أن تعيد طرح كثير من الأسئلة حول التاريخ النسوي المُغيب، والنضالات المطمورة في ظلمات التاريخ. هذا التغييب الذي ساهم بدوره، وبشكلٍ آخر، في ترسيخ اعتقادات خاطئة لدى عددٍ من النسويات في هذه البلدان أنهن نتاج لصيق بالمسارات التاريخية الغربية إلى الحد الذي يجعلهن في النقيض مع مكوناتهن الثقافية المحليّة على نحوٍ غير ملائم في تطور حركاتهن ونشاطاتهن، بل في مدى استيعابهن لأهمية سبر أغوار بِنَى الهيمنة البطريركية المتوقدة في أشكالٍ عدة: المحليّة منها في جانب، والاستعمارية، والرأسمالية منها في جانبٍ آخر.
كوماري جاياواردينا، النسويّة السريلانكية والأكاديمية البارزة، التي عملت في جامعة كولومبو في سريلانكا بين عامي 1969 و1985م، إضافةً إلى عملها في تدريس برامج الماجستير، التي تناولت قضايا المرأة والتنمية في معهد الدراسات الاجتماعية في لاهاي بين عامي 1980 و1982م، وقد لعبت دورًا فعالًا في منظمات الأبحاث النسائية وفي حركات الحقوق المدنية وغيرها من قضايا المرأة والطبقات والقضايا الإثنية، ساهمت من خلال كتابها: «النسويّة والقوميّة في العالم الثالث»، وهو من أحد المراجع ذات الأهمية في مجالات الكتابة والنقاش النسوي، في ألا يجري إعادة التفكير وحسب على نحوٍ يتعلق بنظرية التيارات المحافظة بخصوص المسألة النسويّة العربيّة، إنما في إعادة النظر بشكلٍ أوسع أيضًا حول التجربة النسويّة ذاتها ابتداءً، ومن ثم ترابطاتها البينية، والطبقية، وصولًا إلى علاقاتها مع الحركات الجماهيرية الأخرى، والقوى الوطنية التحررية، وفي مواجهة الإمبريالية، والاستعمار. وهو ما قدمته الكاتبة في عدة فصول مختلفة تستعرض فيها تجارب الحركات النسويّة ضمن سياقات عددٍ من دول العالم الثالث، وعلى وجه الخصوص الدول الآسيوية: «تركيا، وإيران، وأفغانستان، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، والفلبين، والصين، وفيتنام، وكوريا، واليابان». والتجربة في مصر كأحد الدول العربية المهمّة، وذات الإرث الكبير والمتواصل في التاريخ النسوي.
القاهرة وحركات التحرر
إن من أهمية الحديث عن التجربة النسويّة في مصر، هو ما أثارته الكاتبة عن: «أن القاهرة تحتل موقعًا إستراتيجيًّا بين أوربا وآسيا، وبما أنها تعرضت لتأثير حركات التغيير الراديكالية بما فيها الثورة الفرنسية، فقد أصبحت مركزًا عالميًّا للحركات والأفكار الجديدة»؛ الأمر الذي بدا واضحًا في ارتباط: «حركات الإصلاح والنسوية في مصر بالمحاولات التي قام بها الحكام المتعاقبون لتحديث بِنَى البلاد التعليمية والثقافية والإدارية، وكذلك بنمو الوطنية ومناهضة الإمبريالية في ظل الاحتلال البريطاني في حقبة ما بعد عام 1882م»، وهو الذي أشارت إليه في ضرورة: «تقييم النقاشات المبكرة التي جرت بشأن حقوق المرأة وظهور الإصلاحيين الذكور الذين ناصروا تلك الحقوق، ودور النساء الجديدات، اللائي كنّ رائدات أفكار المساواة بين المرأة والرجل». إن مناهضة الإمبريالية، والاحتلال الأجنبي الذي كان يخيّم على مصر، كان من أحد أهم مبادئ الحركة النسويّة المصرية، تلك التي استشهد فيها عدد غير يسير منهن في مواجهة الاستعمار: «ومنهن الشهيدة شفيقة محمد، التي قتلها الإنجليز يوم 14 مارس 1919م، وحميدة خليل، من كفر الزغاوي بالجمالية، وسيدة حسن، وفهيمة رياض، وعائشة عمر، وغيرهن من مئات المصريات الفقيرات المجهولات»؛ الأمر الذي لفت انتباه الكاتبة إلى إعادة النظر في شأن عاملين مهمّين في تطور الحركة النسويّة، وتثبيت قاعدة رئيسة نحو التمييز بين: «النمو الرأسمالي في هذه البلدان»، وإن كان: «قادرًا على أن يرخي قبضة بعض أغلال التبعية التقليدية بين النساء من جميع الطبقات، ليمنحهن شيئًا من القدرة على الحركة والتعلم، وليخرجهن من مجالهن المنزلي إلى المجال الاجتماعي. لكنه استمر في تقييدهن في نظام من الهيمنة الذكورية العامة، على الرغم من تغيّر بعض ملامح الهيمنة»، وبين: «الدافع إلى توكيد هوية وطنية عمل على مستوى أعمق نوعًا ما»، وذلك في سبيل أنه: «كان من الضروري العودة إلى الجذور الدينية والثقافية، ولتعديلها أو إعادة تفسيرها بالتوافق مع حاجات الأزمنة، ومن ثم لتطوير هوية وطنية يمكن أن تعمل بوصفها أساس التطلعات الوطنية»، وهو: «ما يبقيهن وصيّات على الثقافة الوطنية وناقلاتها».
تحديات نحو المسألة النسوية
على الرغم من أن الكتاب حمل على عاتقه التصدي من عدة زوايا مهمّة لأطروحات محافظة ويمينية، ضد المسألة النسوية، إلا أنه في الوقت نفسه، ينطوي على تحديات نحو المسألة النسوية ذاتها، واليسار كذلك، وهو ما حملت فيه الكاتبة نقدًا يتعلق بمدى تشظي الوعي النسوي إزاء مسائل أكثر تجذرًا ذات صلة بالبِنَى التقليدية، وتوقفت أطروحاتها على أبواب «المساواة»: «كما حدث في سريلانكا والفلبين»؛ حيث «لم يتجاوز نضال المرأة المرتبط بكلا النوعين من حركات المقاومة نطاق إصلاحات مختارة ومحددة: المساواة للنساء ضمن عملية قانونية وإلغاء الممارسات التمييزية الواضحة، وحق التصويت والتعليم والملكية، وحق المرأة في دخول حقل السياسة والمهن» التي بدورها ساهمت في أنه: «لم يكن لتلك الإصلاحات أثر يذكر في الحياة اليومية لجمهور النساء، كما أنها لم تعالج القضية الأساسية المتمثلة في تبعية المرأة في داخل الأسرة والمجتمع. حتى عندما انخرطت نساء الطبقات العاملة، فإن الطبيعة الخاصة للصراعات تحددّت بطبيعة الصراع الأكبر، وكان موضوع الأجر المتساوي، ومطالب مماثلة في العادة، هو هدفها الأساس». الأمر ذاته الذي يوضح حقيقة «أن الأحزاب اليسارية القائدة للنقابات العمالية لم تأخذ في الحسبان، في حالات كثيرة، «قضية المرأة»، باعتبارها جزءًا من النضال الطبقي ضد أرباب العمل»، وفي حالات أخرى، فإنها كانت تعدها: «مشكلة ثانوية ستحل مع تحقيق الاشتراكية».
إن ما بذلته الكاتبة في الكتاب هو سابقة في تاريخ النسويّة بالعالم الثالث. وجهد كبير يوضح أثر الحركات النسويّة في تلك البلدان، وعن مدى عمق نشاطاتها في التأثير في حاضر ومستقبل أوطانها بشمولية غير محدودة. وهو ما عبرت عنه إليزابيث فوكس جينوفيز بأن «هيمنة الرجال على النساء تتمثّل في لبّ طبقات وأعراف ومجموعات إثنية وشعوب معينة. إنها تتشابك مع جميع أشكال التبعية، ولا يمكن فهمها بعيدًا منها». وما أضافته الكاتبة: «التاريخ الذي لم يكتب بعد، والذي يجب أن يكتب».