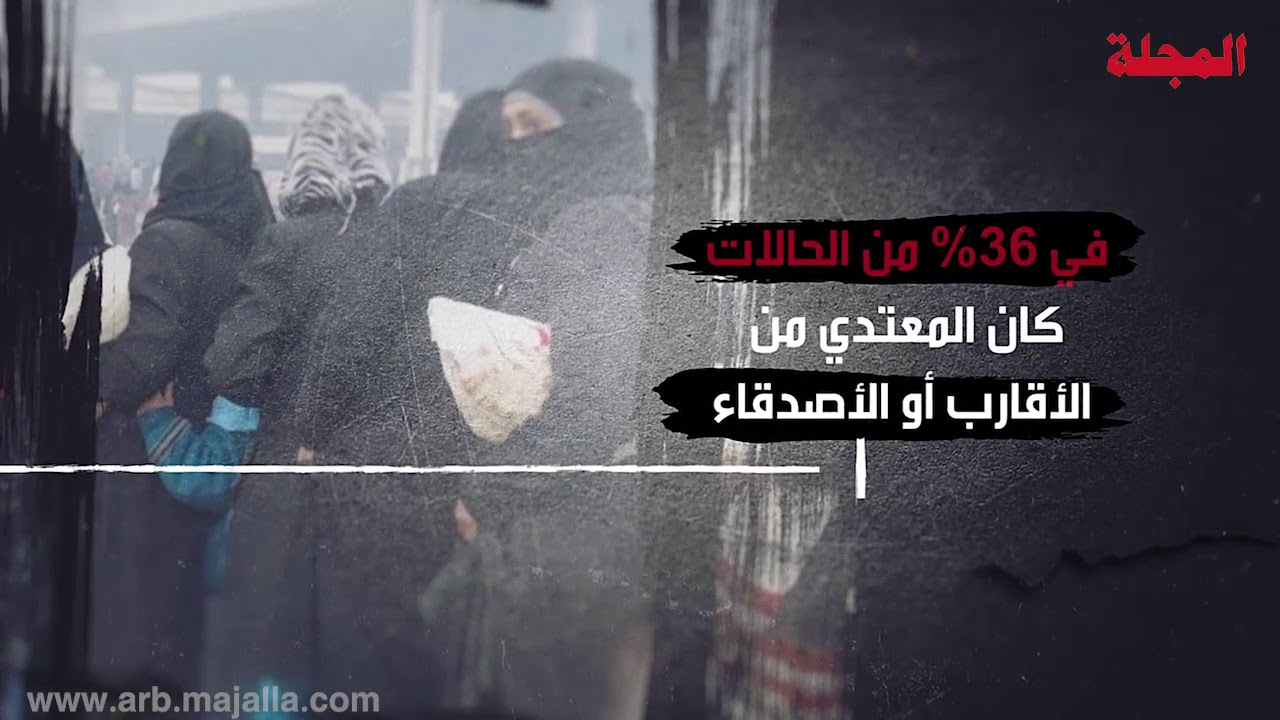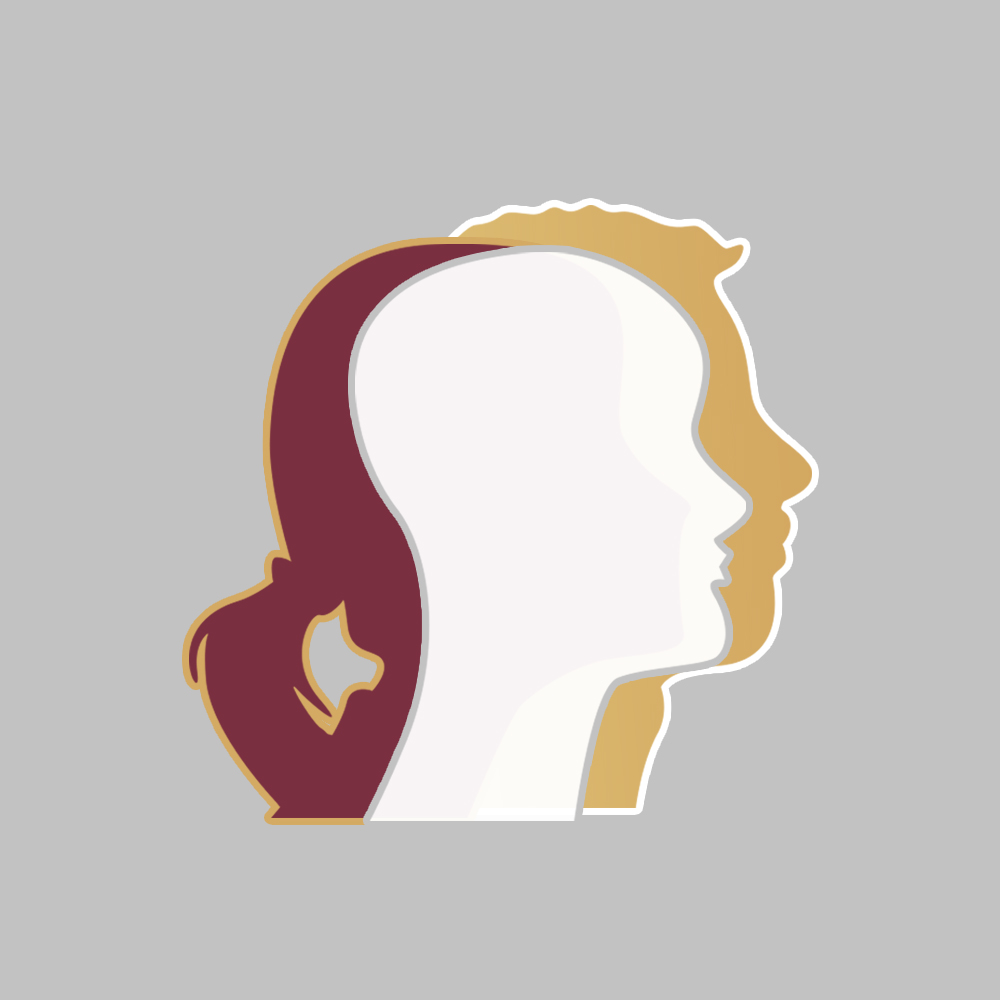حنان الحبش/arb.majalla- تتذكّر بيسان طفولتها بكثير من الألم والغضب، وتروي قصة تعرّضها للتحرّش الجنسي من أقارب من الدرجة الأول، ضمن مجتمع جاهل جنسياً، رغم أنها من أسرة مثقّفة، ووالديها طبيبان، لكن ذلك لم يجعل منها طفلاً يعي ما يحصل حوله أو يعرف كيف يتعامل مع المعتَدِي.
تقول بيسان: «أول مرة كنتُ في الرابعة أو الخامسة من عمري، لستُ متأكّدة تماماً، عمل والداي اضطرّهما للغياب عن المنزل لفترات طويلة، وكنا نسكن في بناء واحد مع أقاربنا، ما جعلنا في لقاءات دائمة مع ابنَي عمّي المراهقَين. كنّا دائماً ما نلعب سويّة، وفي إحدى المرات اقترح عليّ ابن عمي أن نلعب الغميضة فاختبأتُ في قبو البناء»… تصمتُ قليلاً: «عندما دخل إلى القبو اقترب مني وتحرّش بي بطرق متعددة، فهمتُ لاحقاً حين كبرتُ أنّ ما قام به كان تحرّشاً جنسياً، ولم أعِ خطورته حتى تزوّجتُ… تكرّر التحرّش، وكان يخبرني في كلّ مرّة أنّ عليّ أن لا أُخبر أحداً، حتى تحرّش مرة بأختي، وهو ما أحسسني بالمسؤولية تجاهها، ودفعني لأن أُخبر أُخته التي كانت في مثل سنّه ووعدتني أن تمنعه عن ذلك، وأعادت عليّ التنبيه بأن لا أُخبر أحداً، وحذّرتني من مشاكل عائلية في حال أخبرتُ والدتي… لكنه عاد لتكرار فِعلته مرة أخرى، لكن هذه المرة أطفأ سيجارَته بجسدي..»،وتصمتُ «سألتني أمي عن آثار الحرق؛ فأخبرتُها. وتسبّب ذلك في مشاكل كبيرة مع أسرته ووالدي، اضطررنا على أثرها للانتقال إلى السكن في مكان بعيد».
لكنّ ذلك لم يحمِها تماماً!
تستطرد: «كنت في السابعة حين بدأ خالي العشريني بالتحرّش بي بطرق غير مباشرة، إلى أن اختلى بي مرة، لكن والدتي كانت مختبئة تُراقبه وهو يحاول الاقتراب مني فيما يخلع ملابسه، فتدخلَت وصرخت ودخل جدي وحاول قتله لكنه هرب، وتسبّب ذلك أيضاً بقطيعة بينه وبين والدتي، لكن الصدمة أن ذلك لم يدُم طويلاً، فقد نسيت أُسرتي القصة بعد فترة، وعادت العلاقة والمياه إلى مجاريها، رغم أنني لم أنسَ، وعودة والدتي للتعامل معه مجدداً، جعل تحرّش خالي بي أبشع وأكثر إيلاماً من تحرّش أولاد عمي».
ولدى سؤالنا عن أثر ذلك على حياتها لاحقاً، قالت: «بالطبع، أصبح لديّ قناعة أنّ المشكلة فيّ وفي جسدي، اعتقدتُ لفترة طويلة أنني مخطئة، وكرهتُ جسدي، وهذه الاعتداءات آذت علاقتي بزوجي لاحقاً».
الثقافة الجنسية غائبة
تعرّف الأمم المتحدة التحرّش الجنسي بأنه أي مبادرة جنسية غير مرغوب فيها، أو طلب خدمة جنسية، أو فعل لفظي أو جسدي أو إيماءة ذات طابع جنسي، أو أي سلوك آخر له طابع جنسي يُتَوقّع أو يُتصوّر، بشكل قد يتسبّب في شعور شخص آخر بالإهانة والإذلال عند تداخل هذا التصرّف مع العمل أو عند جعله شرطاً للتوظيف أو أن يخلق بيئة ذات طابع ترهيبي أو عدائي أو تهجّمي. وقد يكون على شكل نمط سلوكي أو حدث منفرد.
هل قرأت تعريفاً كهذا في أي من كتب الدراسة؟
لن تحظى بثقافة جنسية مدروسة وحقيقية في سوريا- إلا إذا كنت محظوظاً- حتى وإن وُلِدَت لأُسرة مثقّفة، فهنالك هالة من الرعب والعيب تحيط بكلمة «الثقافة الجنسية»وتجعل الحديث فيها بشكل علمي، أو تضمينها في المناهج الدراسية العربية شبه مستحيل، فيما تقتصر ثقافة العرب الجنسية على الأحاديث المخفية والمشفّرة والبحث عبر شبكة الإنترنت، واستنتاجات ساذجة، وإيحاءات جنسية في الأفلام والمسلسلات، لكنها وفي حال كانت قد وُجِدَت في حالة بيسان وكثيرات ٍغيرها؛ لا بدّ جنّبها اعتداءات لاحقة، وأذىً نفسياً كبيراً.
في سوريا، أصدر الائتلاف الوطني المعارض والحكومة السورية المؤقتة، منهاجاً دراسياً خاصاً به، ليتم استخدامه في تدريس الطلاب في المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة السورية، وهو منهاج مختلف عن المستخدم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وكذلك عملت «الإدارة الذاتية»على إصدار منهاجٍ خاص، لتدريس الطلاب في مناطقها، دون تضمين الثقافة الجنسية بأي طريقة في المناهج الثلاثة.
الشبكة السورية للإعلام المطبوع في تحقيقٍ حول الثقافة الجنسية في المناهج السورية، أكّدت أن المناهج الثلاثة لم تحتوِ أي ذكر للثقافة الجنسية، سوى معلومات طفيفة في كتب التربية الدينية مرتبطة بالطهارة فقط، لا التوعية الجنسية.
«المجلة»فتحت الباب أمام ضحايا التحرّش الجنسي في الداخل السوري لمشاركة قصصهنّ، باستخدام تقنية تمنع التعرّف على هويّاتهنّ، فكانت الصدمة بإقبال عالٍ، حيث استقبلنا مئات القصص عن التحرّش والاعتداءات الجنسية خلال ساعات قليلة.
وظُلمُ ذوي القربى أشدُّ مضاضةً
تقول إحدى الضحايا في شهادتها: «حدث ذلك في دمشق. كنت في الثانية عشرة من عمري وكما جرت عادة الناس في رمضان كنا نتبادل أطباق الطعام مع جيراننا وأصدقائنا، فذهبتُ مع خالي لإيصال طعام لصديقةٍ للأسرة. ثم عرض عليّ الذهاب إلى حديقة قريبة، وطلب مني الجلوس في حجره، ثم امتدت يده تحت ثيابي، ولم أفهم ما الذي كان يحدث رغم أنني متأكّدة أنه كان خاطئاً، ما جعلني خائفة ومستسلمة، لكنني عرفتُ في سن متأخرة أن ذلك كان تحرّشاً جنسياً، وحين أخبرتُ والدتي اتهمتني بقِلّة الشرف وقلّة الحياء وأنّ أحداً لن يصدّقني».
وفي شهادة ثانية:«تعرّضتُ للتحرّش مرّات عدّة، إحداها من زوج عمتي حين كنتُ في السادسة من عمري، ومن جدّي حين كنتُ في العاشرة ومن صديق للعائلة حين كنتُ في الرابعة عشرة».
وتقولّ أُخرى «تحرّش بي عمّي أخو والدي، حين كنتُ في السابعة، ولم أفهم أن ما فعله كان تحرّشاً حتى كبرتُ». وأخرى تحكي: «كنتُ في الخامسة حين تعرّضتُ للتحرّش من أحد أفراد أسرتي، في منزل جدّي، حاول الاقتراب مني عدّة مرّات، ولم أفهم حقيقة ما كان يفعله، ولم أخبر أحداً»، وأُخرى: «كنتُ أرتادُ الدكان القريب من منزلي يومياً بعد المدرسة، وكان مالك الدكان يقترب منّي ومن صديقاتي كلّ مرة، ويقوم بممارسات غريبة، كبرتُ وتعلّمتُ أن ذلك كان تحرّشاً جنسياً».
وفي شهادة أخرى: «تعرّضتُ للتحرش مرتين، والسبب كان غياب التوعية من قبل أهلي، كان جسدي أكبر من عمري، وكانت الحادثة الأولى حين كنتُ في الصف السادس الابتدائي، حين حصرني أستاذي في زاوية الصف وتحسّس جسدي، لم أعِ ما يحدث أبداً لكنني كنتُ غير مرتاحة وأشعرُ بالقرف».
«البيدوفيليا»هو الانجذاب الجنسي للأطفال، تمّ تصنيفه اضطراباً طبقاً للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية منذ عام 1968، والصادر عن الجمعية الأميركية للطب النفسيAPA ، وقد أخذت منظمة الصحة العالمية ذات الموقف واعتبرته اضطراباً جنسياً ونفسياً.
أغلب الاعتداءات الجنسية لمرضى «البيدوفيليا»تحدثُ من الذكور، ويكون الضحية أقل من 14 سنة في الغالب، وهذه الحوادث جميعها تدحض النظرية التي تتهم المرأة بالتسبّب بالتحرّش الجنسي لنفسها، فجميع الحالات المذكورة أعلاه هي للتحرّش بأطفال دون سن الرابعة عشرة، وإذا كان التحرّش مبرَّراً بمشية المرأة ولباسها، فكيف يبرّرون البيدوفيليا؟
تكرّرت في كافة الشهادات عن حوادث الاعتداء في سنٍّ صغيرة «الجهل بما يحدث»، وعن ذلك تقول الاختصاصية النفسية دينا سالمة أنّ الثقافة الجنسية قد تمنع نسبة كبيرة من الاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال خاصة تلك التي تستمر لسنوات، وهي تحمي الأطفال من آثار نفسية مدمرة تلحق بالاعتداء الجنسي، وشدّدت على ضرورة تعليم الأطفال أسماء أعضائهم الخاصة، الأمر الذي يساعدهم في التعبير عن أنفسهم بشكل جيد، ولفتت إلى عادة خاطئة لدى الكثير من الأهالي وهي إجبار الطفل على العناق أو الاقتراب من أشخاص قد لا يكون الطفل مرتاحاً مع الاقتراب منهم، وإجبار الطفل على هذه الأمور قد يجعله معتاداً على تنفيذ أمور أخرى تحت التهديد.
وبحسب اليونيسيف، فإنّ العنف الجنسي يُمكن أن تكون له عواقب خطيرة قصيرة الأجل وطويلة الأجل وتأثيرات بدنية ونفسية واجتماعية، ليس فقط بالنسبة للبنات أو الأولاد، ولكن أيضاً لأُسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وهذا يشمل تزايد مخاطر الأمراض، والحمل غير المرغوب فيه والضغوط النفسية ووصمة العار والتمييز ومواجهة صعوبات دراسية.
تحدّثوا إلى أطفالكم!
إحدى الشهادات لـ«المجلة»: «علّمتني والدتي منذ صغري أنّ لمس جسدي ممنوع من أيٍّ كان. وفي إحدى المرات حين كنتُ في الثالثة من عمري، ذهبتُ مع والدتي لزيارة أحد أقاربها، وبينما ألعب مع الأطفال هناك شدّني ابن عمّ والدتي إلى إحدى غرف المنزل وأغلق الباب وحاول خلع ملابسي عنّي بالقوة والضرب، لكنّني أدركتُ سريعاً أن ما يجري خاطئ فصرختُ وبدأت بالبكاء والمقاومة مما أرعَبه وأجبرَه على فتح الباب لي، أخبرتُ والدتي حالاً، التي أخبرَت الجميع أنها ستلجأ إلى القانون ولن تسكت عن حقّي، لكنّهم استطاعوا إقناعها بالعدول عن رأيها بشرط أن تُقاطعه العائلة، وقد حدث هذا بالفعل. موقف والدتي جعلني أروي القصة بثقة، بدل أن تكون القصة وصمة عار في حياتي، لكنها لم تكن كذلك أبداً بفضل والدتي».
شهادة أخرى: «نزلتُ لشراء حاجيات من بقّالة قريبة من المنزل في دمشق، وكنتُ في العاشرة من عمري، حين ركبتُ المصعد دخل المُعتَدي سريعاً خلفي وأمسك الباب، ووضع يده داخل ثيابي، لم أتفوّه بحرف، لم أفهم ما حدث، وقال لي حينها «لا تخافي عمو»، ثم غادر المصعد، لم يكن مني سوى أن صرختُ وضربتُ الباب بعد أن تأكّدتُ أنه غادر، ودخلتُ إلى المنزل لأخبر أختي، وأذكرُ أنني طلبتُ منها عدم إخبار والدتي، لأنني اعتقدتُ أن الذنب ذنبي، لكن أختي أخبرت والدتي التي سارعت إلى مرافقتي خارجاً للبحث عن المُعتَدي وسألتني مراراً عن شكله. أعتقد أنني لو لم أحدّث أُسرتي عن الموضوع حينها أو لو كان ردّ فعل أسرتي مختلفاً، لما كنتُ بصحة نفسية جيدة اليوم ولم أكُن لأتصالح مع الحادثة، أثقُ أن في حياة كلّ واحد منّا تجربة مشابهة وجميعنا نذكر تفاصيلها».
يبدو أنّ الدور الأكبر الداعم أو المدمّر في هذه الحالات يعود إلى المنزل والأسرة، ولربما تعوّل الكثير من الأسر على حسن مراقبة أطفالهم، أو صدق الأطفال وحديثهم بعفوية عن كلّ ما يمرون به، لكن ذلك قد لا يكون دقيقاً دائماً، تقول الاختصاصية النفسية دينا سالمة أنّ الثقة التي يوليها الطفل للأم والأب ليست مختلفة كثيراً عن الثقة التي يوليها لقريب أو صديق، خاصة إذا كان الوالدان يثقان به أيضاً، وحين يخبره شخص ذو ثقة أن لا يخبر والديه عمّا يجري، فقد ينفذ الطفل الأمر بحسن نيّة، لكنّ التنبيه الواضح والصريح من الوالدين لخطورة الاقتراب إلى جسد الطفل، وضرورة التصريح عن أي فعل غير محبّب أو مرغوب سيكون فوق أيّ تحذير آخر، وشدّدت على أهمية توعية الطفل لحُرمة جسده بمصطلحات واضحة وصريحة لا إيحائية وخجولة.
أظهر استبيان «المجلة»الذي شاركت فيه 700 فتاة، أن 36 في المائة من حوادث الاعتداء كان فيها المُعتَدي صديقاً أو ذا صلة قرابة، نصفهنّ التزمن الصمت تجاه الاعتداء، 8 في المائة فقط من ضحايا اعتداء القربى استطعن مواجهة المتحرّش، 10 في المائة فقط حصلن على تعاطف من الأسرة، بينما واجهت 16 في المائة من الضحايا ردود فعل سلبية من الأسرة، بين لائم ومكذّب ومشكّك أو حتى معتدٍ بالضرب.
الأرقام مرعبة، والشهادات أكثر رعباً، أكّدت بيسان وهي ضحية تحرّش وناشطة ومدافعة عن حقوق المرأة أنّ العادة جرت للشكّ بذي القربى الذي يسعى للاهتمام بالطفل، بينما شكّل أقاربها، الذين لم يُظهروا اهتماماً واضحاً بها أمام أُسرتها، الخطر الأكبر، أي إنّ الخوف من التحرّش لا يمكن أن يكون مركّزاً تجاه من «تُثار حوله الشكوك»، بل العكس تماماً هو الصحيح!
بحسب اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)؛ يشكّل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل، ومع ذلك فهو يمثّل أيضاً واقعاً عالمياً في كافة البلدان وبين جميع الفئات الاجتماعية. وهو يأخذ شكل الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو التحرّش الجنسي أو الاستغلال في الدعارة أو المواد الإباحية.
ويمكن أن يحدث الاعتداء في المنازل أو المؤسسات أو المدارس أو أماكن العمل أو مرافق السفر والسياحة، وداخل المجتمعات المحلية. ويساهم الإنترنت والهواتف النقّالة، بشكل متزايد، في تعريض الأطفال لمخاطر العنف الجنسي، ذلك أن بعض البالغين يبحثون على الإنترنت سعياً وراء إقامة علاقات جنسية مع أطفال.
وأشارت دراسة لمنظمة الصحة العالمية عام 2006 بشأن العنف ضدّ الأطفال إلى أنّ مرتكبي العنف الجنسي ضدّ البنات غالباً ما يكونون من أعضاء الأُسرة الذكور (الإخوة والأعمام والأخوال)، ويليهم في هذا الصدد أزواج الأمهات والآباء وأعضاء الأُسرة من الإناث.
وتشير الدراسة إلى أن 150 مليون فتاة و73 مليون صبي دون سن 18 سنة قد تعرّضوا إلى أحد أشكال العنف الجنسي التي تنطوي على اتصال جسدي. وترجّح اليونيسيف أنّ هناك ملايين آخرين يتم استغلالهم في الدعارة أو المواد الإباحية كلّ عام، وفي أغلب الأحيان يتم إغراؤهم أو إجبارهم من خلال الوعود الكاذبة والجهل بالمخاطر.
ورغم ذلك فإن الحجم الحقيقي للعنف الجنسي ما زال مخفياً، بسبب طبيعته الحساسة وخصوصية المجتمع العربي. كما أنّ معظم الأطفال والأُسر لا يبلّغون عن حالات الإيذاء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف وانعدام الثقة في السُلطات، وكذلك يُسهم عدم التسامح الاجتماعي وانعدام الوعي في ضعف الإبلاغ.
أكّدت 63 في المائة من المشاركات في استطلاع «المجلة»، أنهنّ لم يكنّ يَعرِفن المُعتَدي، نصفهنّ أيضاً التزمن الصمت حيال الحادثة، لكنّ نسبة اللاتي واجهن المتحرّش ارتفعت إلى 22 في المائة، مقابل اللاتي واجهن متحرّشاً معروفاً لهنّ، كما انخفضت نسبة ردّة فعل الأسرة السلبية إلى 12 في المائة . ويبقى التحرّش الجنسي في الشوارع جزءاً من الحياة اليومية..
إحدى الشهادات: «كنتُ أركبُ الباص مساءً، وبينما أحاول الدفع للسائق اقترب منّي شاب وحاول الالتصاق بي بشدّة، فسارعتُ إلى النزول من الباص، وركبتُ في باص ثانٍ، بينما كنتُ أرتجفُ وأبكي فسألني سائق الباص إن كنتُ بحاجة إلى مساعدة، فأخبرته بما حدث، طلب منّي الانتظار واتصل بالشرطة وتقدّمت ببلاغ ضد الشاب».
وشهادة أخرى: «كنتُ أسير وحدي في الشارع ورغم الازدحام لاحقني طوال الطريق وهمس لي بالكثير من الكلمات المقرفة، حتى اقترب مني كثيراً، فاستدرتُ إليه وضربتُه وصرخت، ما أرعَبه واضطره إلى الهروب». وأخرى: «في طريقي إلى المنزل مشياً، وصلتُ إلى شارع غير مضاء فمرّ بجانبي شاب ووضع يده عليّ، فما كان مني إلا أن ضربته وأوقعته أرضاً، الأمر الذي فاجأه ودفعه إلى الهروب بسرعة، وحين أخبرتُ أُسرتي شجّعوني واعتبروا ما فعلتُه بطولة».
التحرّش في القانون
يُعاقب القانون السوري بموجب المادة 505 من قانون العقوبات، مَن لمَس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من 15 سنة، دون رضاهما عُوقِب بالحبس مدّة لا تتجاوز السنة والنصف.
والمادة 506 من قانون العقوبات تنصّ على ما يلي: من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجّه إلى أحدهما كلاماً مخلّاً بالحشمة عُوِقب بالحبس التكديري من يوم إلى ثلاثة أيام، أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
ويقول أحد المحامين في العاصمة دمشق، فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ على الفتاة أن تعي أهمية فضح المتحرّش في لحظة الاعتداء لكي يساعدها القانون، وإذا حدثت الواقعة في مكان عام، عليها أن تصرخ وتلفت النظر إليها، وفي حال استطاعت الحصول على مساعدة من المارّة للقبض على المعتدي وتسليمه للشرطة، فإنّ القانون يحكم لصالحها لأن ذلك يعتبر مساساً بالآداب العامة، وهو أمر يسهّل عليها وعلى النيابة والقانون التعامل مع القضية وإنصاف الضحية.
خجل ووصمة عار
الشهادات أظهرت أنّ لجوء الضحايا أو أُسرهنّ إلى القانون كان خياراً مستبعداً أو ضمن آخر الخيارات، وكثيراً ما تختار الضحية السكوت، أو تلجأ أُسرتها إلى تعنيف المعتدي وحلّ المشكلة فردياً أو التكتّم عليها.
الحقوقي والناشط في المجتمع المدني أُبي كردعلي يرى أن المشكلة الأساسية في آلية إثبات تعرّض الفتاة للاعتداء، والتي من الممكن الطعن بها بطرق ملتوية، وهو أمر بحد ذاته يمثّل إشكالية في الوسط الاجتماعي السوري، ويذكر حادثةً في دمشق عن فتاة تعرّضت للتحرّش من زميلها في اتحاد الطلبة، فتقدّمت بشكوى طلبت منها الشرطة بناءً عليها «إعادة تمثيل الحادثة»، مما دفعها للتراجع، وسحب الشكوى.
ولفت المحامي كردعلي إلى غياب الوعي لدى أفراد الشرطة بكيفية التعاطي مع هذه الحالات، فليس هنالك مناهج ثقافية دراسية أو تدربيات لكوادر الشرطة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع ضحايا اعتداءات كهذه، ما يجعلهم عاجزين عن التعامل بشكل صحّي مع الحالات، وفي حالات كثيرة قد يؤدّي هذا الجهل إلى التعامل مع الموضوع بقِلّة اهتمام أو بطرق هزلية، ما يجعل الإجراءات القانونية بحدّ ذاتها فضيحة، الأمر الذي قد يضطر الضحايا إلى التراجع.
ومما لا شك فيه أنّ حديث ضحايا التحرّش عن تجاربهنّ كما التثقيف الجنسي يبدو محرجاً للضحية وأُسرتها، وفي حالة اللجوء إلى الشرطة والقانون؛ فإنّ ذلك الإحراج يبدو مضاعفاً، خاصة ّلاضطرارها لشرح تفاصيل الحادثة مرّات عدّة أمام رجال غالباً لا ثقة مبنية بينهم وبين الضحية، وقد يُرافقه وصمة عار مجتمعية لأنها «خريجة حبوس»، حتى وإن كانت ضحية.
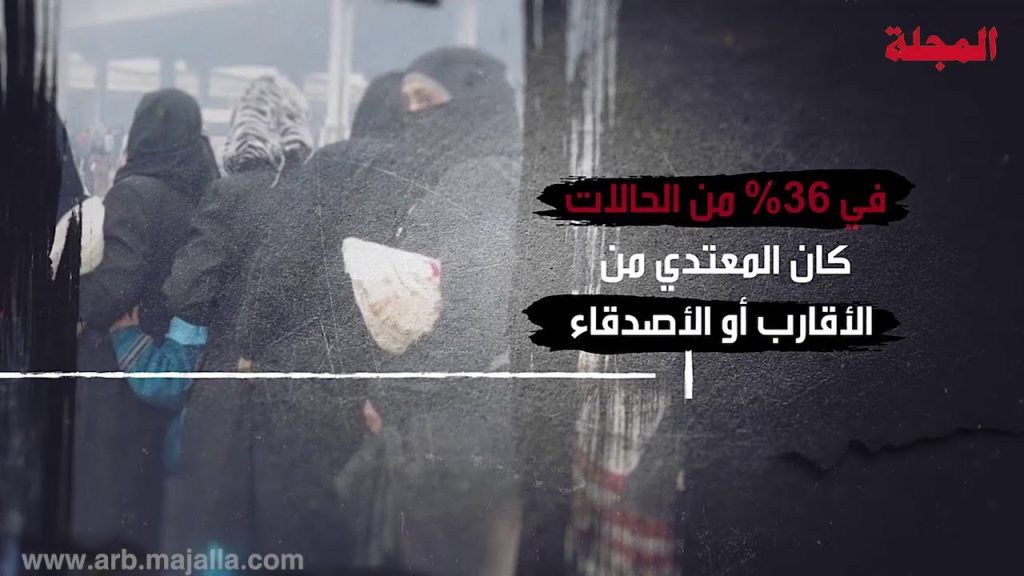
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.