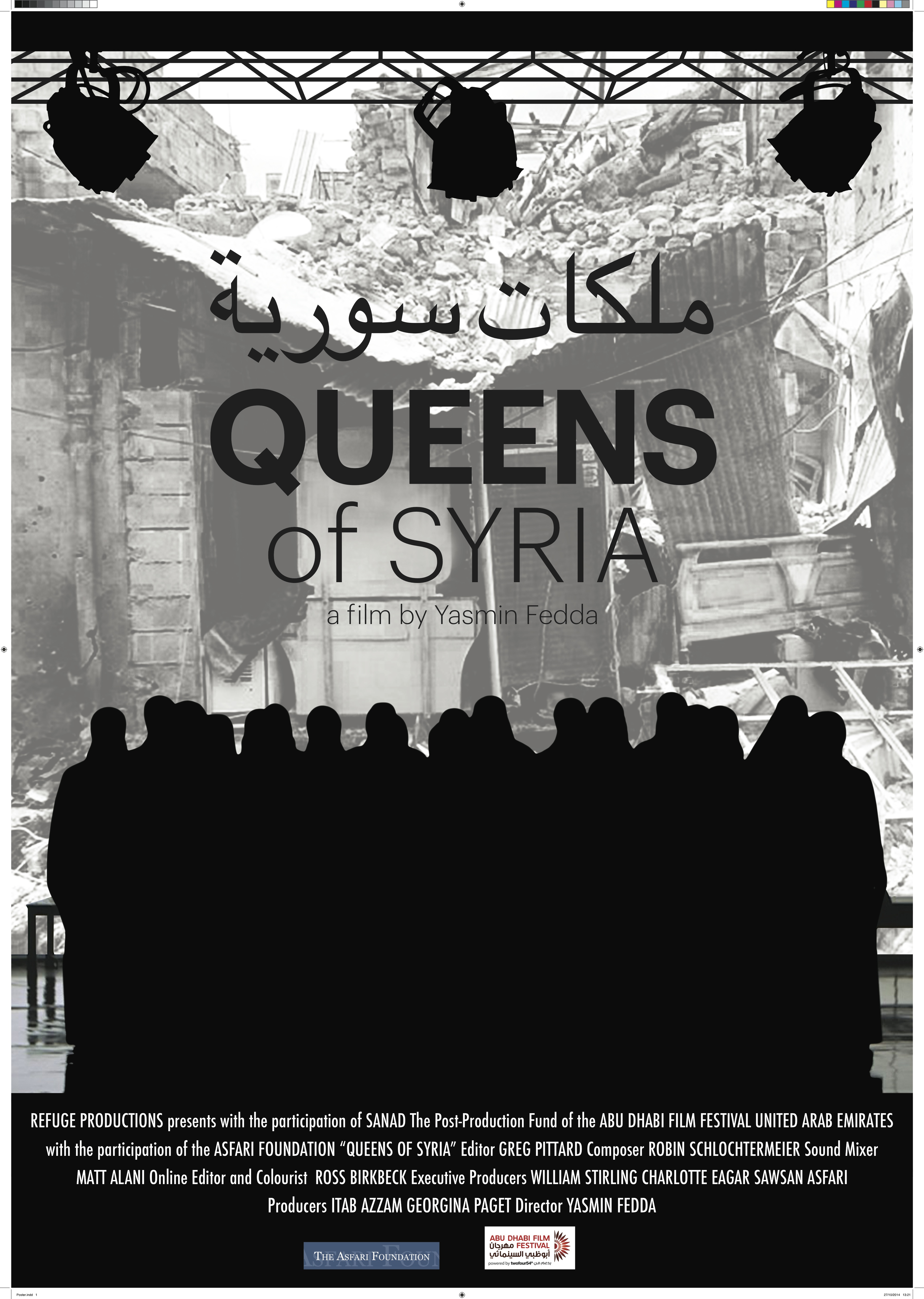أميرة حسن الدسوقي/raseef22- بعد زواج استمر ثلاث سنوات، اضطر زوجي أن يسافر وحده للمرة الأولى. في تلك اللحظة طرأت لي فكرة، وهي أن أقضي فترة سفره في منزلنا، بدلاً من بيت أمي. ومع أول يوم قضيته وحدي في منزلي، اكتشفت أمراً مهماً، هو أنني في هذا العمر، حيث أخطو خطواتي الواثقة نحو الأربعين، وعند اللحظة التي أغلق فيها زوجي الباب في طريقه إلى السفر، كانت أول مرة في حياتي الطويلة التي يكون لي فيها منزل خاص بي وحدي، ولو لفترة مؤقتة. كان إحساساً لم أختبره من قبل في حياتي. كانت مشاعري مضطربة بين الفرح الشديد، والخوف الشديد. بين الرغبة في فعل كل شيء، والرغبة في الاختباء فوق أريكتي المفضلة في المنزل بلا حركة. تلك حياتي، تلك هي مساحتي الشخصية، وهي ملكي تماماً لمدة أسبوع، من دون تدخل أي طرف خارجي.
ما هذا البراح، وكيف حُرِمت من هذا الاحساس طوال عمري؟
في طفولتي، وداخل جدران منزل أسرتي الكبير، كنت أتشارك وأخي، الذي يكبرني بستة أعوام، غرفة نوم واحدة، وإن كبيرة. وبعد أن كبرت بالقدر الكافي الذي لا يسمح بأن أشارك أخي الذكر غرفة واحدة، “عشان خلاص بقيتي آنسة”، كما قالت أمي، لم يكن الحل في توفير غرفة خاصة بي، لأن نظام الشقة، و”ديكورها”، سيفسدان إذا أغلقنا إحدى غرفها، وفقاً لرغبة والدتي.
مع العلم أننا كنا نعيش في شقة مساحتها واسعة، وتسمح بتوفير غرفة خاصة للـ”آنسة” كي تتمتع بخصوصيتها. لكن “الكنبة” كانت البديل. نعم، الكنبة في غرفة المعيشة كانت مساحتي “غير” الشخصية طوال فترة مراهقتي، وحتى وفاة والدي حين شاركت أمي غرفة نومها. أريكة في غرفة المعيشة هي ما حصلت عليه كأنثى في أكثر فترة حساسة في حياتي؛ فترة المراهقة، بينما يغلق أبي وأمي باب غرفتهما، ومثلهما يفعل أخي.
صديقتي المقربة في ذاك الوقت كانت تعاني من الأمر نفسه، حتى أنها وضعت ستاراً حزيناً لا يخفي شيئاً من المكان الذي تنام فيه، ونتشارك فيه الدراسة للثانوية العامة. كنت فتاة مجتهدة لم تسعَ إلى مساحتها الشخصية لتمارس فيها التدخين، أو أي شيء آخر. كنت أريدها حتى أدرس بهدوء. ومع ذلك، وعلى الرغم من انعدام تلك المساحة، حصلت على مجموع عالٍ في الثانوية العامة، وكذلك صديقتي، بعد أن قضينا ساعات دراستنا في غرفة معيشتي، وفي غرفة السفرة في منزلها، وراء هذا الستار الهزيل، والكنبة التي تُفتح لتكون فراشاً نسرق فوقه ساعتين من الراحة بين ساعات الدراسة.
أنا لا أتحدث عن مأساة شخصية مررت بها. بل أتحدث عن حالة عامة تعيشها معظم النساء في مصر، وربما في الوطن العربي كله، حيث تعيش المرأة، وتموت، من دون أن تختبر مساحتها الشخصية. هي طفلة في بيت أسرتها، حتى لو كانت لها غرفتها الخاصة؛ فإغلاق باب تلك الغرفة يُعدّ أمراً مريباً، ويوحي بكل ما هو فاسد. ثم تخرج المرأة من بيت أسرتها إلى بيت زوجها حيث يشاركها غرفة النوم، والمنزل بالكامل. وعادة ما تُفرض إرادة الرجل في إدارة اليوم، وفقاً لظروف عمله، ونظامه اليومي. وهذا ليس من باب الظلم، ولكن من باب العادة، حتى أن المرأة إذا أرادت لليوم أن يسير وفقاً لرغبتها، فلن تدري ربما ماذا يمكن أن تفعل بعد أن عاشت سنوات طويلة كل تفصيل في يومها، وفي مساحتها الشخصية، بتحديد من قبل الآخرين.
وهذا بالضبط ما أدركته بعد أن أغلق زوجي باب المنزل وراءه في طريقه إلى السفر؛ أدركت أنني لا أدري ما الذي يمكنني أن أفعله في تلك المساحة الواسعة من الحرية. وأول ما صدر مني هو محادثتي لصديقتي عبر الهاتف طالبةً منها أن تأتي إلي حتى لا أكون وحدي. لم يكن الأمر سهلاً كما تخيلت: سأطير فرحاً، وسأرقص في المنزل، وأسهر ليلاً خارجه. مربّو الطيور كلهم يدركون جيداً أن الطائر لا يخرج من القفص بمجرد أن تفتح له الباب. هو يحتاج إلى الثقة. يحتاج إلى أن يدرك أين سيذهب إذا خرج. بعد مرور يومين برفقة صديقتي، قررت أن أخوض التجربة، وبعد رحليها استنشقت هذا الرحيق للمرة الأولى، رحيق المتع الصغيرة التي تمنحها لنا المساحة الشخصية.
أخذت إجازة من عملي حتى تتوافر أركان الحرية جميعها، والمساحة الشخصية. جرّبت إحساس الاستيقاظ وحدي من دون أن يوقظني أحد لأفعل شيئاً. جرّبت إحساس الخفة. والشيء الذي وضعته على المنضدة، لم يتحرك من مكانه إلا حين التقطته أنا. لن أفكر في الطعام اليوم، ولا في الطهي، وسأطلب أي طعام عبر الهاتف حين أجوع. قد تبدو تفاصيل تافهة لك، ولكنها كانت عالماً جديداً ورائعاً بالنسبة إلي. لم أخرج من المنزل طوال الأسبوع، كي “أتمرمغ” في براح مساحتي الشخصية.
صديقتي تلك، اضطرت إلى دفع آلاف الجنيهات بعد انفصالها عن زوجها، لتجد مكاناً تعيش فيه قططها، لأن والدتها تخاف من القطط. أما صديقة المراهقة التي حادثتها قبل أيام، فكانت تبكي لأنها بعد زواجها، وبعد أن رُزقت أطفالاً، لا تجد المساحة الكافية لنفسها ولا حتى داخل دورة المياه، حيث لا تفارقها طفلتها حتى وهي تقضي حاجتها، أو وهي تستحم. صديقة أخرى عاشت في القاهرة مع ثلاث طالبات، حيث كانت تدرس بعيداً عن محافظتها حيث ولدت. عايشت معها ذكريات تنمّر صديقاتها إذا تأخرت ليلاً نظراً لأنهن “ملتزمات”، ولا يردن أن تكون سمعة الشقة سيئة. أمي التي تبلغ من العمر ستين عاماً، وكان لها خمسة أخوة ذكور، لم تختبر يوماً ماذا يعني أن تكون لها غرفة يمكنها أن تغلق بابها عليها. وابنة أخي البالغة من العمر سبع سنوات تنام مع جدتها في غرفتها. على مر الأجيال، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، صدقوني، قد تعيش المرأة العربية، وتموت، من دون أن تدرك ما معنى براح المساحة الشخصية.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.