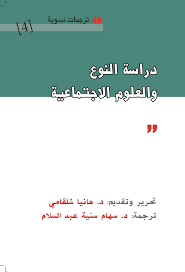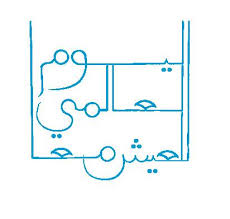باحثات لدراسات المرأة/bahethat- “دراسة النوع والعلوم الاجتماعية”[1] هي ليست بدراسة، وإنما مجموعة من المقالات بلغت أحد عشر مقالاً، انتقتهم محررة الكتاب وهي أستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذات باع واسع في إلقاء محاضرات الدراسات النسوية.
ويُعدّ هذا الكتاب الإصدار الرابع ضمن سلسلة “ترجمات نسوية”، الصادر عن ملتقى المرأة والذاكرة[2] بدعم مالي من مؤسسة “فريدريش إيبرت”[3].
كما تستهدف تلك السلسلة تقديم ترجمات لمجموعة منتقاة –على حد قول محررة الكتاب- من المقالات؛ لترسيخ مفهوم الجندر في علومنا بشتى تخصصاتها؛ كي تصير نصوصاً عربية مألوفة!! فضلاً عن هدف آخر عبرت عنه محررة كتابنا هذا بقولها “تحرير العلوم الاجتماعية من هيمنة صوت واحد عليها”، وبالفعل تمركزت مقالات الكتاب حول فكرة جوهرية هي: إعادة إنتاج المعرفة، وإعادة دراسة المجتمعات من المنظور النسوي.
وعليه يجسّد هذا الإصدار فكرة تسييس العلوم الاجتماعية، حيث لم يعد البحث غاية في حد ذاته، بل أصبح وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية للنسوية، وإحداث التغيير الاجتماعي الذي ينشُدنه على نطاق واسع، فهو يسعى إلى أمرين:
- محاولة ترسيخ مقولة أن المجتمع وليس الحتمية البيولوجية هو الذي يحدد دور المرأة، ويربطها بالطبيعة مقابل الثقافة للرجل، وبالخاص مقابل العام، مع اتهام المجتمعات بطبيعة الحال بنظرتها الدونية للأول مقابل رفعة الأخير.
- إعادة إنتاج المعرفة: فالكتاب يُجري عملية تفكيك تدريجية لمقولات تم تعريفها عبر التاريخ الإنساني، وفي إطار المرجعية الإنسانية لتحل محلها تعريفات جديد لـ “المرأة”، “الأم”، “الأم – الطفل” وفك هذا الارتباط، والذي لن يتم إلا من خلال برنامج ثوري يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء: التاريخ، واللغة، بل الطبيعة البشرية ذاتها.
وهذا البرنامج الثوري يبدأ بإعادة إنتاج المعرفة على المستوى النظري، وإعادة ترتيب النظم على المستوى التطبيقي.
وهذا المستوى الأخير يبدو جلياً في مطالبات واردة بالكتاب من هذا القبيل “تمنحنا تحليلات شتراوس وفرويد خرائط أولية للنظام الاجتماعي الذي لابد أن نعيد ترتيبه”[4] وفي موضع آخر “… وباختصار، لابد أن تدعو النسوية إلى ثورة في نسق القرابة “كذلك” لابد من إعادة تنظيم نسق الجنس/ الجندر عن طريق تحرك سياسي”[5].
وعلى المستوى النظري، ناقشت صفحات الكتاب ظهور “علم الأنثروبولوجيا للنساء” و “علم اجتماع للنساء” بل وإفراد مقال بعنوان “هل توجد طريقة بحث نسوية“؛ لشرح السبل التي على النسويات أن يسلكنها للتغلب على التحيز حيث “صوت العلم ذكوري” وكذلك “أن نظريات المعرفة التقليدية قد استبعدت على نحو نظامي إمكانية أن تكن النساء عارفات” ومن ثم تقول ساندرا هاردينج: “نحتاج لكي نمسك بزمام أعماق واتساع التحولات المطلوبة في العلوم الاجتماعية كي نفهم الجندر…؛ لتقويم اعوجاج ما في التحليلات التقليدية من نزعة التمركز حول الذكور”[6].
وما يعيب هذا الاتجاه:
- الانطلاق من ثنائية تضادية صراعية تفترض التحيز الذكوري كنقطة انطلاق، بما يعني ضمناً أن النسويات سيسلكن ذات المسلك الذي ينتقدنه وهو “التحيز التحليلي” بما يشكك في صحة النتائج.
- أن النسويات أنفسهن وإن حاولن الاستناد إلى دراسات لنساء فهي غير كافية، لذا اضطررن للاستعانة بدراسات لرجال، ولاسيما في مناهج البحث الميداني، بما يدحض زعم الاستقلال والانفصال.
- وثمة تساؤل مشروع، لمصلحة من شق صف العلم بهذا الشكل بأن يكن هناك علم تاريخ نسوي مقابل علم تاريخ ذكوري، علم لغة نسوي …؟ فهذا الجدال العقيم لا طائل منه غير مضيعة وقت الإنسان، والأولى توحيد الجهود للبحث عن أرشد السبل لإعمار الأرض بشقي النفس الواحدة.
- أن العناد النسوي فقط هو الذي يكمن خلف مسعى تحطيم “خرافة سيادة الرجل” فأغلب المجتمعات التي استعنّ بها تؤكد ما اعتبرنَه خرافة، ففي الدراسة لأحد المجتمعات اللواتي زعمن أنها يمكن أن تؤكد نسق الانتساب للأم وجدن فيها السيطرة للذكور أيضاً. ففي ص 88، تقول أودري ريتشاردنز:
“هذا مجتمع يسوده الذكور، حتى ولو كان الانتساب يُحسب عن طريق الانحدار عن سلسال الأم، فإن الزوجة تخضع إلى حد بعيد لتحكم زوجها فيها، حتى وهو غريب يعيش في قرية زوجته”.
كما تؤكّد دراسة المجتمعات المختلفة حقيقة مفادها اختلاف طبيعة النساء عن الرجال حتى في طبيعة السلوك الاقتصادي: “النساء في أرياف البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، يزرعن المحاصيل الغذائية أكثر من زراعة المحاصيل التي تُباع مقابل مال سائل (المحاصيل النقدية) والمحاصيل التي يزرعنها تتطلب مخاطرة أقل، كما أنهن على عكس الرجال يستخدمن الدخل الذي يحصلن عليه من أجل مصلحة جميع أفراد الأسرة، وينفقنه على وجه الخصوص على التغذية والتعليم لأفراد أسرهن[7]“.
أبرز الأطروحات الواردة بالكتاب:
- أولاً: النسب للأم:
في تجاهل تام للشرع الذي أقرّ بنسب الأبناء لآبائهم وليس لأمهاتهم؛ حفاظاً على عدم اختلاط الأنساب، دون أن يكون في ذلك تقليل من شأن الأم أو قيمة دورها في حياة أبنائها. رفعت مترجمة مقالات الكتاب اسمها على غلاف الكتاب باسمها مصحوباً باسم أمها وأبيها (سهام سنية عبد السلام)؛ تعبيراً عن فكر نسوي غاية في المغالاة والتطرف، يرى أن “نسبة الأبناء إلى آبائهم فقط نوع من الأنانية الذكورية”، كما عبرت عن ذلك من قبل نوال سعداوي، وقد أصرت ابنتها أيضاً على أن تحمل مقالاتها توقيع (منى نوال حلمي) لكن لم تستجب مجلة روز اليوسف المصرية؛ تجنباً لاستفزاز مشاعر الناس[8].
ومن المعلوم أن د. سهام عبد السلام ليست فقط ذات باع طويل في الدراسات النسوية ولا سيما الجندر، بل هي عضو كذلك من بين المسؤولين عن مجموعة عربية ضد ختان الذكور.
ثانياً: اتهام اللغة العربية بالذكورة:
تنتهج محررة الدراسة ذات النهج الذي اتبعته في سائر السلسلة، وهو اتهام اللغة العربية بالذكورة، والحل برأيها هو إرفاق تاء التأنيث لكل مفردة، حتى ولم تستقم مع اللغة العربية، أو الإتيان باللفظة المؤنثة بجانب المذكر؛ ظناً منها أن هذا يبرز المرأة في السياق مع البدء بالمؤنث بطبيعة الحال كما في ص10، على سبيل المثال لا الحصر “تشرح المقدمة أسباب اختيار المقالات والسبب الذي يجعلها تنوير وتحدي الباحثة / الباحث الشابة / الشاب ودعاة العدالة الحريصات / الحريصين على دعوتهم”.
- ثالثاً: الاعتراف بعدم وجود تعريف واصطلاح محدد للجندر
تعترف محررة الكتاب بعدم وجود تعريف واصطلاح محدد للجندر، وتسترسل قائلة بأنه كي يتقبله العربي ولا يشعر بالغربة تجاهه كان على الناقل ليّ لسانه، والبحث عن بطاقة انتساب له داخل المنظومة العربية، بادعاء عالمية المفهوم. تذكر محررة الكتاب في مقدمته “لقد قيل الكثير عن (السمة الأجنبية) للمفهوم، وعن الأفكار والقيم التي تحملها الحركة نحو المساواة. نعرف أننا لا نمتلك اصطلاحاً محدداً يدل على النوع باللغة العربية، وإننا نميل إلى ليّ ألسنتنا حين نريد ترجمة الأفكار والنظريات التي تكون دراسات النوع”[9] ثم تستدرك المحررة قائلة في الفقرة التي تليها:
“لكن المادة التي يتكون منها مفهوم النوع مادة عامة في جميع أنحاء الكون. ويمكن صياغة الفكرة كما يلي: إن الأدوار الاجتماعية تأتي مصحوبة باستحقاقات مقررة اجتماعياً، فالأدوار الاجتماعية التي تحظى بأكبر قدر من احترامنا تحمل أكثر الاستحقاقات امتيازاً، أما الأدوار التي يُحكم عليها بأنها أقل أهمية لبقاء الإنسان وتنظيم حياته، فلا تضفي على من يعهد إليهم بها إلا قدرا أقل من الاستحقاقات”[10].
إن أمثال هذه المقولات إنما هي لتجميل الوجه القبيح للجندر، وخلط الحق بالباطل، فمضمون مفهوم الجندر ليس مادة عامة في الكون، وإنما وليد ثقافة بعينها، تريد إرسائه كشكل من أشكال الهيمنة، فضلاً عن القول بأن الأدوار الاجتماعية التي تحظى بالاحترام هي صاحبة أكثر الامتيازات والعكس صحيح، وأن المجتمع هو الذي يحدد قيمة هذا الدور بأنه أكثر أهمية أو أقل أهمية، قول يرتبط بالنسق الأفقي المسقط، والذي يختلف تماماً عن نسقنا الرأسي المسقط. حيث يتلقي الأخير معياريته من مصدر علوي متجاوز للطبيعة، بينما تنتمي شجرة المفاهيم الغربية إلى النسق الأفقي المصدر المتمحور حول الذات التي تفرخ الأنا التسلطي الإمبريالي والموجود بذاته ولذاته [11].
كما يقوم النسق الرأسي المسقط على فكرة التباعض بين المرأة والرجل “فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ”[12]، حيث تجاوز دعوى المساواة، والارتقاء بالعلاقة بينهما إلى مرتقى التباعض للكيان الواحد الناشئ بطرفيه من نفس واحدة خلق الله منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. ولا نصير بذلك أمام كيانين متقابلين، بل أمام أبعاض لنفس واحدة يستحيل الحديث عن سمو بعض منها على البعض الآخر، أو تسلط بعض منه على البعض الآخر، فلا قيام للنفس الواحدة إلا بهما معا. ومن علاقة التباعض هذه يقرر القرآن الكريم أن المرأة عليها ما على الرجل، ولها ما له، عدا قوامة الزوج على زوجته، وأن المرأة والرجل سواء في التكليف الشرعي وفي الأهلية للثواب والعقاب في الدنيا والآخرة .
- رابعاً: نظرة النساء لجنسهن بدونية واعتباره عبء:
ترسخ محررة الكتاب مقولة تطفح بالنظرة الدونية من المرأة لذاتها “إن أجساد النساء هي أعباؤهن، فهذه الأجساد موضوع للملكية التي تدعي بحق الوصاية، وبحق ملكية الذرية“ بل فصلت في شرح عبء الجسد وكيف أنه يمثل ضغوطاً على المرأة، حيث (عدم المساواة) و (العبء الزائد)، مستعرضة نماذج توضح ما ترمي إليه، فهذه الضغوط تتمثل في:
“الإجهاض الذي يعبر عن المرأة الكاثوليكية، والحجاب يحدثنا عن الشرقيات”، أما عن “العبء الزائد” فهو: “العبء الزائد هو الإنجاب فعبئه ثقيل وكذلك له وقعه الضار على حسن أحوال النساء، وبالمثل تعاقب النساء على طبيعتهن الجنسية وما يفرض عليهن من عادات الاحتشام..”[13].
رغم أن “حرية الاختيار” التي تتشدق بها النسويات ويرفعنها شعاراً تتجسد في اختيارهن الحشمة، فلماذا تضيق صدور النسويات بهذا الاختيار. أيرضين بنتائج استطلاعات الرأي؟ ففي دراسة لمركز بيو للدراسات -مركز بحثي أمريكي بجامعة ميتشجان الأمريكية يعمل في مجال أبحاث الشعوب والنشر- حول الزي المناسب الذي تراه الفتيات في بلدان العالم الإسلامي مناسبا للارتداء في الأماكن العامة. وقد أجرى المركز الدراسة في (7) بلدان إسلامية، وهي: تونس، ومصر، والعراق، ولبنان، وباكستان، والسعودية، وتركيا، وذلك بسؤال المشاركين في البحث عن تفضيلهم للباس المرأة، وكيف يرغبون أن يرونها. وقد عرض المركز على المشاركين أشكالا مختلفة من الحجاب والسفور، وقد حصلت الفتاة غير المحجبة على أقل نسبة تصويت، حتى في لبنان حيث تتواجد نسبة كبيرة من المسيحيين، لم تتعد نسبتها الـ 50%، وفي مصر كانت النسبة 4% فقط، وهي نسبة تقاربت مع نسبة السعودية التي كانت 3%، وباكستان الأكثر بنسبة 2% فقط[14].
كما طفح الكيل في تحقير جسد المرأة ووظائفه مقابل تعظيم ما يقوم به الرجال في قول شيري ب. أورنتر:
“الذكر يخلق أشياء تتمتع بالبقاء، أما المرأة لا تنتج إلا أشياء فانية: بشراً فانين”[15].
وتتجلى هنا المادية بأبشع صورها، حيث تمجيد الأشياء وتحقير الإنسان، والنظرة الأحادية له في بعده المادي فقط، أي أن الحيز الإنساني يختفي ويبتلعه الحيز المادي[16]. بل إن استمرار النسج على هذا المنوال يستبعد الأمومة وتنشئة الأطفال، فهي أعمال لا يمكن حسابها بدقة كالمصانع والآلات، كما يستبطن إعادة صياغة الإنسان في ضوء معايير المنفعة المادية، والتي تُعد عصب منظومة الحداثة الغربية، حيث الاهتمام بالإنتاجية المادية على حساب القيم الأخلاقية.
- خامساً: آفة التعميم:
على الرغم من أن محررة الكتاب صرحت –حين تناولت إشكاليات الترجمة- بحقيقة ذكرتها: أن “العلوم الاجتماعية مبنية على ما هو خاص وتعتمد بشدة على المرجعيات الاجتماعية”[17] فإن الدراسة عممت مقولة “أن المرأة أدنى من الرجل في كل الثقافات”[18] بناء على معايير ثلاث:
عناصر الإيديولوجيا الثقافية، الأدوات الرمزية (تدنيس المقدسات)، الأدوار الاجتماعية التي يحظر على النساء المشاركة بها. واستعرضت نماذج لتصل إلى تعميم “نجد أن النساء يقعن في منزلة أدنى من الرجال في أي مجتمع من المجتمعات”.
ولو كانت منصفة، أو قارئة جيدة للشريعة الإسلامية لوجدت صورة مغايرة تماماً. فالحيض الذي استشهدت به -على سبيل المثال- لتوضح أن المجتمعات تنبذ المرأة الحائض وتعتبرها مؤذية لمن يلمسها أو يتعامل معها، بل يفرض عليها عدم دخول الأماكن المقدسة… فلتقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئًا من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك”، كما أن حظر الدخول للمسجد يمتد إلى الرجل حين يكون جنباً، إذن ليس المعيار ذكرا أو أنثى، فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحيض والجنابة من رجل أو أنثى في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقول الله سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيل[19]، استثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة، والحائض كذلك لها أن تعبر، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب، أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد: إناء أو كتابًا أو ما أشبه ذلك[20].
- وأخرى تحاول البرهنة على أن كافة المجتمعات تربط بين المرأة والطبيعة (أدوار طبيعية كالأمومة والإنجاب) حيث الدونية، والرجل (الثقافة) حيث الاستعلاء. أتت بنموذج لمجتمع بدائي (جماعة الكاولونج) واستعرضت بعضا من نمطهم المعيشي، وتجاهلت الكاتبة:
- واحد من المجتمعات لا يصح علمياً وبخاصة في الدراسات الإنسانية، تعميم النتائج المستخلصة من دراسته على كافة المجتمعات.
- حتى هذا المجتمع الذي ساقته للبرهنة على فكرتها، فإن النتائج التي توصلت إليها مفتعلة، وتم ليّ الحقائق كي تتناغم مع أطروحتها. فما قصرته على المرأة بزعم أنه دليل على ربطها بالطبيعة يصدق على الرجل فكلاهما مشدود للفعل الجنسي، وكلاهما يتشارك عملية الإنجاب، فلا هي تستطيعه بمفردها وكذلك هو. أي أنهما يرتبطا بالطبيعة سواءً بسواء.
- سلوك هذه الجماعة مع الحائض والنفساء والواردة “في هذه الفترة المرأة مدنسة ومن ثم عليها أن تحرص على ألا تمس أي شيء قد يحدث أن يمسه رجل.. والدنس ينتشر أثناء الحيض والولادة من المرأة إلى من حولها، وهذا يستلزم فصلها مادياً عن كل المواضع والأشياء التي يستخدمها الجنسان كلاهما. نتيجة لذلك، تعزل النساء أثناء الولادة والحيض بعيداً عن المناطق الرئيسية للسكن وفلاحة البساتين[21]“. أهذا نموذج يمكن البرهنة به على تعميم دونية النساء؟ أين هذا من نموذج “حيضتك ليست في يدك”.
- أيضاً عندما تناولت الكاتبة الرمزية الثقافية، عممت فكرتها لتعلن أن الثقافات تنمط الأنثى في رموز هدامة مثل الساحرات والحسد، وإذا كان التراث الغربي يربط بين السحر والمرأة (حرق الساحرات في عصورهم الوسطى) فإن القرآن الكريم حين تحدث عن السحر “ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ”[22]، لم يخص الذكور أو الإناث، وتحدث القرآن كذلك عن سحرة فرعون، بل حين ساقت السنة النبوية الشريفة رواية عن الحسد، كان كلاً من المحسود والحاسد رجلا “مرَّ عامرُ بنُ ربيعةَ بسَهلِ بنِ حنيفٍ وَهوَ يغتسلُ فقالَ لم أرَ كاليومِ ولا جِلدَ مُخبَّأةٍ فما لبثَ أن لُبِطَ بِهِ فأتيَ بِهِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقيلَ: لَهُ أدرِك سَهلًا صريعًا، قالَ: من تتَّهمونَ بِهِ؟ قالوا: عامرَ بنَ ربيعةَ، قالَ: علامَ يقتلُ أحدُكم أخاهُ إذا رأى أحدُكم من أخيهِ ما يعجبُهُ فليدعُ لَهُ بالبرَكةِ ثمَّ دعا بماءٍ فأمرَ عامرًا أن يتوضَّأَ فيغسلَ وجْهَهُ ويديْهِ إلى المرفقينِ ورُكبتيْهِ وداخلةَ إزارِهِ وأمرَهُ أن يصبَّ عليْهِ”[23].
- كذلك عند تناول مفهوم “تمكين المرأة” استعرضت المحررة بعضا من المؤشرات التي يمكن بها قياس التمكين، في تجاهل تام لحقيقة أن مؤشرات القياس تختلف تبعاً للمجتمعات، بل وللظروف التاريخية. ولنأخذ مؤشري العمل، والصوت:
- دخول النساء إلى سوق العمل قد يعتبره البعض مؤشراً للتمكين، بينما قد يكون علامة من علامات القهر في مجتمع آخر، وفي وقت آخر (الثورة الصناعية) الحروب (العالميتين الأولى والثانية) ومع ذلك تقول محررة الكتاب في:
“إن العمل هو الذي يجعل النساء قادرات على المطالبة بالحقوق والكرامة والاعتراف”[24].
- أيضاً اعتبار “الصوت” كأحد مؤشرات تمكين المرأة، يمكن تفنيده من وجهين: فهو يخلط بين مفهوم التمكين والمشاركة من جهة، كما أنه قد يكون أحياناً مؤشراً مضللاً إلى حد بعيد من جهة أخرى، ولاسيما في المجتمعات التي يتم فيها شراء أصوات النساء والرجال لدعم ناخب بعينه، بل وأحياناً بممارسة التخويف والإجبار، وفي المجتمعات الريفية والقبائلية يذهب الصوت سواء كان لرجل أو امرأة أوتوماتيكياً لمرشح العائلة أو القبيلة.
- سادساً: المنهجية غير العلمية:
من بديهيات العلم، أنه للوصول إلى المعرفة على الباحثين اتباع المنهج العلمي، وإلا أصبحت الساحة مفتوحة لكل ناعق يدعي أن أفكاره علماً يُعتد به. وأبرز خطوات هذا المنهج العلمي هو فرض الفرضيات، وتتم هذه الخطوة بعد أن يكون الباحث قد جمع المعلومات، وسعى للتأكد منها، ثم تأتي مرحلة فحص الفروض واختبارها، من خلال الطرق التي تعتمد على دراسة الظاهرة، كاستخدام المنهج التجريبيّ، أو التجريد، ومناهج الاستقراء، والاستنباط، حيث يمكن للباحث فحص هذه الفروض من خلال وضع مقارنات بينها وبين فرضيات علميّة سبقتها، والتأكد من أنّ هناك علاقة وثيقة بين الظاهرة المطروحة للدراسة، وبين الفرضيات العلمية التي سبقتها، وفحصها إذا ما كانت مقبولة من وجهات نظر علميّة أو مجتمعيّة، حتى يصل الباحث إلى حقائق صافية لا تشوبها شائبة، ويستخلص منها نتائج عمليّة وصحيحة لحلّ تلك الظاهرة.
ولكن في الكتاب الذي بأيدينا أمر جلل، حيث تعتبر النسويات ما يرونه كفرضية ينبغي التعامل معها على أنها حقيقة علمية دونما أي إثبات، بل يقع على من يعارضها إثبات رفضه.
تقول شيري ب. أورتنر عبر مقالها المعنون بـ (هل المرأة بالنسبة للرجل كالطبيعة بالنسبة للثقافة؟):
“الوقت قد حان لنقلب الموائد رأساً على عقب. فلم يعد من مسئوليتنا أن نعطي أمثلة توضح أن تدني منزلة المرأة أمر عام في جميع الثقافات، بل صار من يجادلون ضد هذه الفكرة أن يقدموا لنا أمثلة مضادة لأمثلتنا. سأعتبر أن المنزلة الثانوية للنساء في عموم الثقافات أمراً بديهياً، وأنطلق في بحثي من هذه البديهية”[25].
وبالفعل استند مقالها إلى فرضية يمكن نسفها من جذورها، من قبل شريحة أخرى من النسويات، ومع هذا تتحدث عنها وكأنها من المسلمات فتقول:
“صغت فكرتي كالتالي: يمكن تفسير تدني قيمة المرأة بكونها ترتبط بالطبيعة والرجل بالثقافة”، وربط النساء بالطبيعة يتبناه تيار نسوي معروف (النسوية البيئية) وله ثقل في المؤتمرات الأممية المعنية بالبيئة والأرض. وليس ثمة اعتراض على ربط المرأة بالطبيعة، ولكن الفصل تعسفيا. فثمة صلة أيضاً بين الرجل والطبيعة، فآدم عليه السلام أقرب للطبيعة؛ لأنه خلق من تراب، وإذا كانت الدعوى تستند إلى أن المرأة تنجب الجنس البشري ومسؤولة عن استمراره، فهذا تجاهل لحقيقة أن استمرار النوع الإنساني مسئوليتهما معاً، فملايين النساء عاجزات عن إيجاد نفس بشرية دون رجل، وكذلك ملايين الرجال دون امرأة. كذلك يتشاركا في صنع الثقافة بموجب القيام بأمانة الاستخلاف التي عهد إليهما بها الخالق تبارك وتعالى.
كذلك تعرضت ثنائية الطبيعة – الثقافة إلى هجوم من قبل النسويات الأنثربولوجيات، اللواتي درسن مجتمعات ينخرط فيها الجنسين بالعمل بالداخل والخارج، كالصيد والزراعة في إفريقيا جنوب الصحراء والهند.
- سابعاً: سيولة المفاهيم وجعلها ثقافية من صنع المجتمع:
كما حدثت سيولة وتشكيك في ربط دور المرأة بطبيعتها البيولوجية، لم يسلم الجانب السيكولوجي للمرأة أيضاً من هز أوتاده. فليست الجينات أو الفطرة هى التي تجعل المرأة حانية على أطفالها وتميل إلى رعايتهم، وإنما عامل خارجي فرض عليها هذه الطبيعة الأنثوية ، فتقول “إن من خصائص الذات الأنثوية أنها أقل إصراراً على التمييز بين الذات والآخر، وأنها تتسم بالتوجه نحو الحاضر أكثر من المستقبل، وبقدر أكبر نسبياً من الذاتية وبقدر أقل من الموضوعية، إن الرجال أكثر اتجاهاً نحو الموضوع، أما النساء فأكثر ذاتية وأكثر اتجاهاً نحو الأشخاص… إن تلك الفوارق ليست متأصلة في جبلة الأفراد، ولا هي مبرمجة مسبقة في جيناتهم، لكنها تنشأ من سمات هيكل الأسرة”[26].
كذلك انتقلت هذه السيولة إلى المفاهيم التي تتمتع بالثبات لدى كل المجتمعات، لتجعلها النسوية غير ثابتة بل من صنع المجتمع، فتقول إحداهن مقولات من قبيل: “فئة الأم بناء ثقافي، مثلها مثل فئة المرأة”[27]، “بل وتسترسل لفك وحدة الارتباط البديهية (الأم – الطفل)، وتستشهد بكتاب نظيرتها النسوية كارول ستاك الذي تناولت فيه الأمريكيين الحضريين. قالت بأن 20% من الأطفال في دراستها قد تربوا في عائلة غير التي تعيش فيها أمهم البيولوجية، لتصل إلى نتيجتين:
- أن المنزل ليس بالضرورة أن يضم أمهات بيولوجيات لأطفالهن.
- أن مفهوم الأم في أي مجتمع قد لا يبنى من خلال الحب الأمومي ورعاية الأطفال، وأن الحقائق البيولوجية لا تنتج وحدة مكونة من أم – طفل”.
ومن المعلوم أن نسبة 20% تجعل النتيجة استثناء وليست القاعدة العامة التي ينبني عليها حكم، فضلاً عن أنها استثناء داخل مجتمع العينة ذاته، فهي تعبر عن الحضر، والريف الغربي يختلف كثيراً عن حضره، فما زالت به بقية من القيم الإنسانية السوية.
كما أن وجود ملاجئ أو حضانات للأطفال أو حتى مربيات للطفل لا يلغي ارتباط المرأة بالأمومة، أي تظل وحدة الأم – الطفل بلا فكاك، فلن تتحول الأمومة يوماً إلى وظيفة اجتماعية قد يؤديها رجال، وإنما سيظل دوماً رعاية الطفل من نصيب أمه، وإن حالت الظروف دون ذلك تحل محلها امرأة أخرى.
ثامناً: تمييع الهوية لصالح الشذوذ:
تقول جايل روبين: “إن الهوية الجنسية كفئة خالصة لا تعبر عن الفروق الطبيعية، بل تعبر عن قمع أوجه الشبه الطبيعية بين الرجال والنساء. وهي تتطلب الكبت: كبت أي شيء في الرجل له سمات أنثوية، وكبت كل شيء في المرأة يمكن وصفه بأن له سمات ذكورية”[28]، بل يصل الأمر إلى حد اعتبار العلاقة الحميمية بين رجل وامرأة ليست فطرة، فتقتبس روبين في موضع آخر في رأياً تستند إليه:
“يقترب ليفي – شتراوس من القول بأن ممارسة الجنس بين جنسين متغايرين عملية أحدثتها المجتمعات.. إن قمع الجزء الجنسي المثلي للإنسان، وبالتبعية قمع ذوي الجنسية المثلية ناتج عن نفس النسق الذي تقهر قواعده النساء[29]“. ثم تعرب عن رأيها صراحة محاولة إضفاء صفة التنظير عليه، فتقول: “يعتبر المعالجون العلاقات المثلية بين النساء مشكلة في حاجة إلى علاج بدلاً من أن يعتبروها مقاومة لوضع سيء أشارت إليه نظرياتهم”[30].
- تاسعاً: تدجين الرجال أو استئصالهم:
تشرح كاتبة المقال البرنامج النسوي للوصول إلى المجتمع المنشود الذي تحقق فيه الحركة النسوية مرادها بإلغاء التراتب فتقول : “إن تحليل أسباب قهر النساء يُشكل أساسا لما يجب تغييره للوصول إلى مجتمع دون تراتب مبني على الجندر. وهكذا، إذا كان العنف والسيادة المتأصلان لدى الذكور هما منشأ قهر الإناث، فمن المنطقي أن يتطلب البرنامج النسوي إما إبادة الجنس المؤذي، أو مشروعاً لتحسين النسل لتعديل صفات هذا الجنس”[31].
ولا تكتف الكاتبة بهذا، بل تشير إلى أن هناك مهمة أخرى أكثر صعوبة من استئصال الرجال، وهي أي إعادة إنتاج ثقافة بدعوى أن الهزيمة التاريخية للنساء نشأت مع الثقافة، بما يجعل “على البرنامج النسوي أن يشمل مهمة أكثر صعوبة حتى من القضاء على الرجال، إذ عليه أن يحاول التخلص من الثقافة وإحلال ظاهرة جديدة تماماً محلها على وجه الأرض”[32].
- عاشراً: الحلم النسوي:
يخطئ من يظن أن النسوية تسعى إلى تحرير المرأة، أو إزالة الغبن عنها. وما حجة القهر الواقع على النساء من قبل الرجال إلا ذريعة -بدليل أن هناك مسببات أقوى للقهر كالاستعمار والرأسمالية المتوحشة وسياسات تكريس الفقر والتخلف من قبل الشمال للجنوب ..الخ–، فالحلم النسوي يحلم ليس بإنصاف المرأة كامرأة، وإنما يروم تغيير طبيعتها دون أن يكون هناك تثريب، وكما عبرت إحداهن:
“أعتقد أن على الحركة النسوية أن تحلم بما يتجاوز مجرد القضاء على قهر النساء. إذ لابد أن تحلم بالقضاء على فرض الطبائع الجنسية والأدوار الجنسية إجبارياً. وأكثر الأحلام إلحاحاً في نظري الحلم بمجتمع مزدوج الجنس لا يكون فيه التشريح الجنسي للفرد ذا علاقة بمن هي، أو هو، وما تفعله أو يفعله، ومع من تمارس أو يمارس الجنس”[33].
إذن تحرير المرأة ليس نهاية المطاف، ولاحتى المساواة المطلقة، وإنما نحن بصدد مسعى لتغيير شكل المجتمع الإنساني، وحينها سيعم البلاء الجميع، فقد سبق وأن حذر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قائلاً: “… خِصالٌ خمْسٌ إذا نزلْنَ بكم -وأعوذُ باللهِ أنْ تُدْرِكوهنَّ-: لم تظهَرِ الفاحشةُ في قومٍ قطُّ حتَّى يُعْلِنوا بها، إلَّا فشا فيهم الطَّاعونُ والأوجاعُ الَّتي لم تكُنْ مضَتْ في أسلافِهم الَّذين مَضَوا قبلَهم”[34].
من حسنات الكتاب:
كشف الكتاب عن كثير من الحجج والبراهين التي تقلب مقولات النسويات رأساً على عقب، من خلال دراسات النسويات أنفسهن، صحيح أنهن أردنها أن تصل بهم إلى إثبات قناعاتهم، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن تكشف الدراسات عن رسوخ الفطرة السوية، لذا يحمد للكتاب:
- ربطه بين وجود كثير من الأفكار الغربية في المجتمعات الأخرى، وظاهرة “الاحتكاك بالرجل الأبيض”، والاستعمار، والتغريب، بل والتبشير الذي أدى إلى اعتناق الكثيرين للتصورات الكنسية التي تُرسخ دونية المرأة، كما في دراسة ليكوك عن هنود المونتاجنير.
- أيضاً يُحسب للكتاب نجاحه في النفاذ إلى أروقة الفكر النسوي، لنرى كيف تهتز أوتاد المقولات النسوية من جذورها على أيدي البعض منهن. فالنسويات الماركسيات يشككن في صحة فرضيات النسويات الليبراليات، بل ويطالبن بخطأ تبني أطروحاتهن أو تعميمها. ونسويات العالم الثالث يتهمن النسوية الغربية بالتمحور حول العرق الأبيض، ومحاولة إلصاق مفاهيم غربية عن العائلة والعلاقات الاجتماعية بثقافات أخرى، ولا يحق لهن التحدث باسم كافة النساء.
- فضلاً عن كشف الكتاب للاستراتيجيات التي تتبعها الحركة النسوية، ولاسيما الجناح الراديكالي منها؛ لتحقيق أهدافهن، كالانخراط في التشكيلات المؤسسية والتنظيمية للتنمية الدولية، واختيار نوع من الصياغات اللغوية المفهومة، والتحليلات، والصور التمثيلية عند تناول قضايا الجندر، وإبراز أولوياتها[35]، مع تخفيف حدة الخطاب كي يتقبلها القائمون على المؤسسات “التخفيف من حدة الأفكار وتحويلها إلى شعارات ومُثل[36] شرط يكاد يكون ضرورياً لإدخال هذه الأفكار إلى المؤسسات“. تقول أندريا كورونول وإليزابيث هاريسون وآن وايتهيد في المقال الخاتم والمعنون بـ “النضال من أجل قوة التأويل في مجال الجندر والتنمية” في:
“قد يتطلب التأثير على الاقتصاديين براهين وتحليلات في شكل حقائق مبالغ فيها، بينما يتطلب التأثير في النجوم المشاهير المتمتعين بالقوة على المستوى الدولي رسائل موجزة”[37].
ولا مانع في سبيل الهيمنة النسوية على المؤسسات الدولية من تجاوز الخلاف الفكري “قد حدثت نزاعات شديدة بين الشرائح النسوية ولكن ثمة مصالح استراتيجية مشتركة فيما بينها من حين إلى آخر”[38].
أيضاً كما ورد: الاصطفاف على المستوى العالمي ضد ما أسمينه بـ “المحافظون، والمحافظون الجدد” في المؤتمرات الدولية، وعقد التحالفات وتجاهل الاختلافات”، وسيكون على الحركة النسوية العالمية أن تبذل مزيداً من الجهد للتغلب على تقسيمات التنوع، وأن تعقد تحالفات لمواجهة هذا التحدي، والتحالف بين النسويات بشكل يتجاوز الحواجز الجغرافية – السياسية أسهل في مواجهة هذا النوع من التهديدات”[39].
- كما يكشف الكتاب عن جانب خطير في البحوث الميدانية، فهنريتا مور والتي أُفرد لها مقالان بالكتاب جمعت معلومات عن المجتمعات التي عملت بها لدى الأمم المتحدة كمدير ميداني ثم حولت دراساتها –نتيجة اعتمادها لمعايير غربية بالأساس- إلى مجموعة تهم معلبة وجاهزة ومسبقة النتائج ضد هذه المجتمعات[40]. كذلك تتجلى روح الاستعلاء والعنصرية في نظرة الغربي للآخر، في عنوان كتاب يدرس شعب البانتو بجنوب إفريقيا للكاتبة أودري ريتشاردز، والذي عنونته بـ “الجوع والعمل في قبيلة من المتوحشين”[41].
وأخيراً:
إن هذا الكتاب جد خطير، وأدعوكم لقراءته رغم عدد صفحاته التي تجاوزت الثلاثمائة، وصعوبة الأطروحات الواردة به، لكنه جدير بالقراءة؛ لخطورة ما ورد به بدءاً من مقدمة المحررة، مروراً بالأحد عشر مقالاً اللواتي ناقشن طبيعة المرأة إلى الرجل كالطبيعة بالنسبة للثقافة، والخاص إلى العام، والجندر والمكانة، وكذلك القرابة والأسرة لفهم عمل النساء، وطرح سؤال حول ما إذا كانت ثمة طريقة بحث نسوية، وسبل تمكين النساء من: حيازة الموارد والقدرة الفردية على الفعل والإنجاز، والاستعمار ونساء الهند، والدراسات النسوية المعاصرة، وعمالة نساء العالم الثالث، ودراسة النساء والجندر في الاقتصاد وأشكال الاتجار بالنساء والتي عددن منها الزواج، وأخيراً النضال النسوي في مجال الجندر. أترككم في مطالعة صفحات الكتاب، مع رجاء عدم إغفال أي مفردة بدءاً من الغلاف الأمامي، وصولاً إلى الغلاف الأخير.