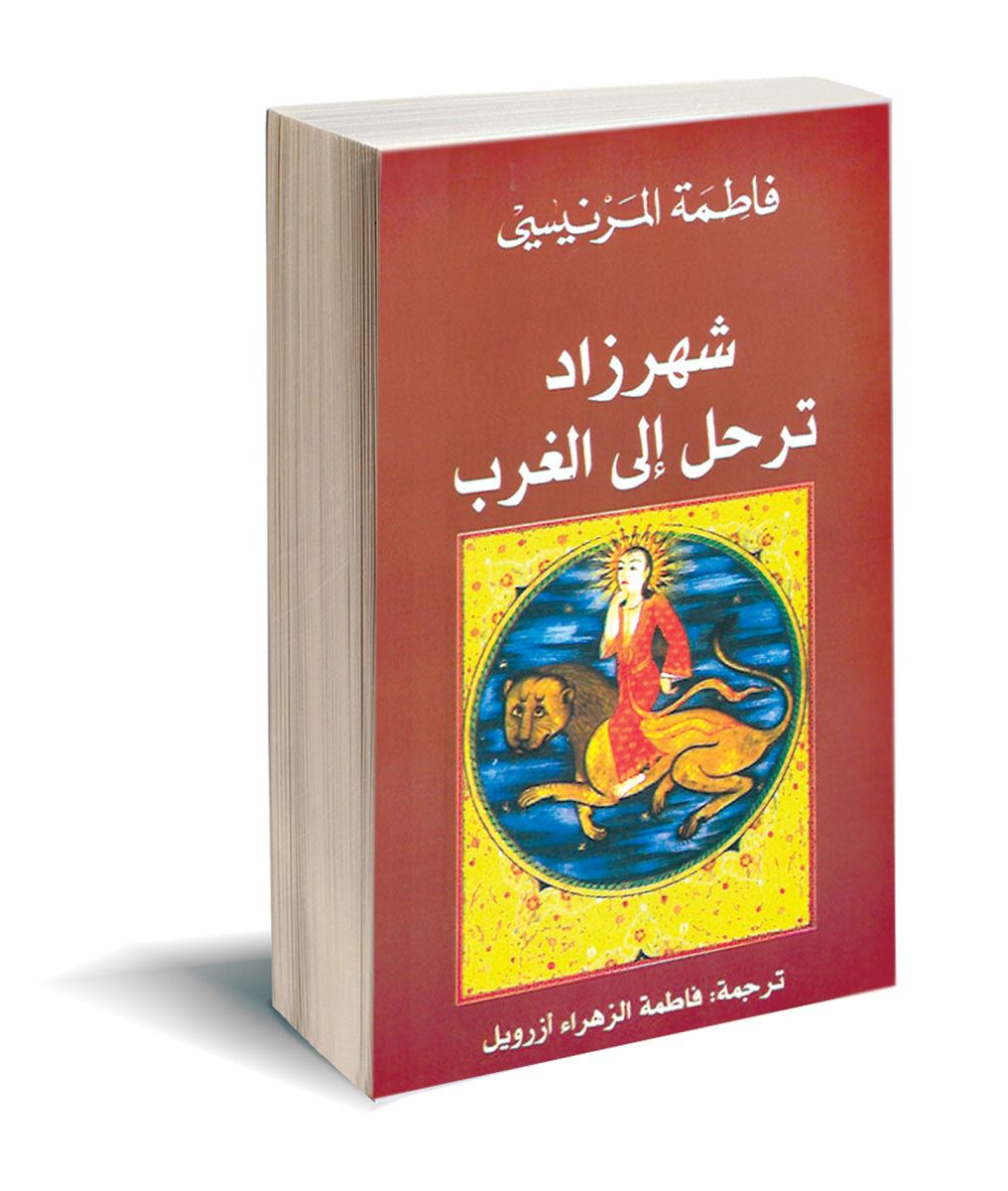سلوى زكزك/swnsyria- يبدو من الصعب جداً نسيان تلك الحادثة، كنتُ في التاسعة من عمري عندما زارتنا ابنة عمتي المقيمة في الكويت، والتي تجاهلت شوقي الطفولي العارم لحظة استقبالها وقالت لابنتها، وهي تشير لأختي ذات البشرة البيضاء والعينين الخضراوين: (شوفي القمر)!
كرهتها، وكرهت القمر الذي لبس وجه أختي حينها، كنت بحاجة لأفهم، لأحد ما يداوي تلك القسوة وذاك النكران، لن أُبرّر أبداً لحدثٍ يظنّه غالبية الناس عابراً وبسيطاً، فيتعمّقون في التمييز ويبالغون في القسوة، وفي المحصلة يطلقون أحكاماً معيارية وهجومية على أي شخص يحاول الإشارة إلى فداحة هذا التصرف، لابل قد يلجؤون لوصفه/ها بالإنسان المعقّد أو المفذلك أو صاحب نظريات فلسفية فارغة لا تستحق إلا الرفض والسخرية.
في العام 2007، هاجمتني شريكتي المنقّبة في مقعد السرفيس وبعد شتائم تصفني بالمنحلّة أخلاقياً، صفعتني بكفّها على وجهي لتؤدّبني بعد أن وصفتها بالمتحجّرة والأصولية، الصفعة والاتهامات كانت بسبب أنني ألبس كنزة بلا أكمام وتنورة في مكان عام.
بيروت، الرابع من آب 2020، رجلٌ يكتب على صفحته على الفيس بوك منشوراً يصف لبنانيةً هاربة من مكان التفجير بقلّة الأخلاق لأنها رفعت طرف فستانها الذي بلا أكمام والطويل كي لا يُعيق حركتها أثناء الركض وقال: “السوريّات يركضن وهنّ يشددن على حجابهن!”
من قال لذلك المتشنّج أنّ كلّ السوريات محجّبات وأنّ كلّ اللبنانيات سافرات؟ من علّمه التفرّغ لمراقبة النساء وملابسهنّ وهنّ يهربن من الموت؟ من أعطاه رخصةً في منح شهادات العِفّة والتقوى لجنسيةٍ على حساب أخرى، ولدينٍ على حساب آخر ولزيّ على حساب زيّ مختلفٍ عنه؟ والأهم كيف سمح لنفسه بالتفرّغ للمراقبة والقذع والرجم في موقفٍ يتطلّب المساندة والمساعدة؟.. فليفعل شيئاً ينتمي للإنسانية أو فليلتزم الصمت! فيُريح ويستريح.
التمييز يتطلّب تعميماً وتكريساً لصورةٍ نمطية في البداية، صورة أنّ الجميلات هنّ فقط بيضاوات البشرة وصاحبات العيون الملوّنة، وأنّ المنقّبات هنّ الوحيدات اللواتي يحفظن أجسادهنّ من الاستباحة وكلّ ما عداهنّ يتوجّب ردعهن، بالشتائم أو بالضرب، لا فرق.
التنميط هو في أن تموت النساء غارقاتٍ في الدم والحرائق، فيتكرّسن كميّتاتٍ عفيفاتٍ طاهرات، إرضاءً للصورة النمطية المطلوبة منهنّ والمحبوسات داخل أطرها الضيّقة، كي لا يلاحظهنّ مهووسٌ أحمق، فيهدر كراماتهنّ ويتشدّق بدونيته وبلصوصيته، ليقدّمها للجموع وكأنها فروسية.
في صورةٍ أخرى، كانت إحدى السيدات تقول لجارتها يجب عدم تصوير أجساد النساء اللواتي تعرّضن لجروح أو حروق في الجسد، حتى لو عرضن إصابتهنّ طوعياً في المشافي أو في أماكن الحوادث، لأنّ اجساد النساء عورة، وعلينا حمايتها من أعين المتلصصين. وأتذكرُ أنّ امرأة قد أُغميَ عليها في الشارع فهوت أرضاً، كانت أولوية الإجراءات الطبيّة لها هو تغطية ساقيها وتأمين شرشف مُرتَجَل كان يغطي بضاعة إحدى البسطات، لستر جسدها الذي تسبّب الحر باختناقه فأضافوا مصدراً إضافياً للحرارة لجسدها، الذي كان ينشد هواء رطباً وتنفّساً مرتاحاً.
مهنياً وأخلاقياً، من الواجب صيانة حرمة الأجساد المصابة نساءً ورجالاً، والمنافي للقيم والأخلاق المهنية، أن تُصوَّر الأجساد وحتى الجثث بقصد التلاعب أو السخرية أو الانتقاص من كرامتها الشخصية أو الانتقام المنهجي المقصود والموجّه.
وينحو التمييز منحىً أكثر تطرفاً وهمجيةً عندما تتم الإشارة إلى البشر المكلومين والمجروحين وربما الميتين بتوصيفاتٍ ساخرة وخاصة إن كنّ من النساء، مثل :(عزرائيل بيُهرب منها)، أو (مسكينة على هالشوفة يغطّوها أشرف) أو (منظرها بيرعّب أكتر من الموت) أو (الموت سترة)، خاصةً لمن كانت مشوّهة المعالم أو من ذوات الاحتياجات الخاصة جسدياً أو عقلياً.
طلبت سيدةٌ من أعضاء إحدى المجموعات على الفيس بوك بعض الإرشادات للتعامل مع الأفاعي في حال فاجأتها إحداها عند سفرها للتخييم، الردود كانت مرعبة وعنيفة لدرجة غير متوقّعة وغير إنسانية، مثل (حيّة ما بتأذي حيّة)، أو (حاكيها عادي بتفهم عليكِ وما بتأذيكِ) أو (قوليلا والله العظيم بس تقربي بمسح المكياج والحيّة ذكية كتير ما بتزت حالها عالموت)، أو (عادي ستات عبعضكن) أو (لاتتصرفي شي بس تشوفك وتشوفيها بيحن الدم).
إن الاستخفاف بالخطاب العام التمييزي العنيف تجاه النساء وتمريره كفكاهة سمجة يتم تداولها باستهتار وخفة، وكأنه ثقافة عامة لا يمكن خدشها ولا نقدها ولا رفضها، هو تأسيسٌ لعنفٍ في الخطاب العام وفي السلوك العام أيضاً، لا يجعل العنف صفة حصرية للخطاب فقط، بل يبرّر العنف في كافة أشكاله ويحوّله إلى سلوك يبدو طبيعياً ومقبولاً. لكنه مع الزمن ينسف العلاقة التشاركية من قاعدتها الجذرية، لتتحوّل الشراكة إلى معتدٍ ومُعتَدَى عليها، فيتحوّل التنمّر إلى خطوة انتقالية تبني على ما سبقها من تأطير وتنميط وتكريس، تتصاعد ليصبّ كلّ هذا في تعاملٍ عدواني، والأصح أنّه اعتداء عُنفي معمّم وغير قابل حتى للتفكيك.
في الحروب والأزمات والخضّات الكبرى، يتصاعد حجم العنف وتتعدّد أشكاله، وعندما يكون العنف قاعدة عامة، يصبح العنف ضدّ النساء حاجةً للشعور بالتعويض عن العنف العام، أو أداة تفريغ تُفرَض وتُمارَس على الفئات الأكثر هشاشة (النساء). والمرعب أن المطلوب هنا ليس فقط إعلان العنف كأسلوب وحيد للتعامل، بل المطلوب هو مضاعفة حجم العنف، ورفع مستواه ليتماشى مع العنف العام المتصاعد، ليشعر المعنِّفون من الرجال الذين يضعون أنفسهم كما يضعهم المجتمع في خانة القرار وفي درجة أعلى من التراتبية، ليشعروا بأن سلطتهم لم تهتز أو تختل بتأثير عنفٍ أعلى لمصلحة فئةٍ أدنى هي النساء.
ومن الجدير ذكره أنّ توصيفاً تمييزياً وعنفياً جديداً لَحَقَ بالنساء السمراوات أو من ذوات البشرة الداكنة أو ذوات الأجسام الضخمة خاصةً، وحين يرتبط الشكل الخارجي بمكان إقامةٍ أو ولادةٍ محدَّدين، بأنهنّ حُكماً من نساء داعش! أو داعشيّات كما يتمّ التعبير عنهنّ في هذا التوصيف المُغرِق في ظُلمه وعدائيته، توصيفٌ ينطلق من التمييز ويتجه نحو التنمّر، ليبلغ مبلغ التعنيف والاتهام نحو التجريم والإقصاء.