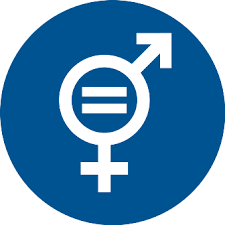فادية أبوزيد/ موقع (جيرون) الإلكتروني- سؤال طرحه أحد المداخلين في نقاش، حول أهمية العلمانية لمستقبل سورية، وهي التي تفترض فصل الدين عن الدولة، والعمل بقوانين المواطنة التي تساوي بين الرجل والمرأة، وإلغاء التشريع الديني، ممثلًا بقانون الأحوال الشخصية الناظم للأسرة السورية الإسلامية ومثلها المسيحية والدرزية، وهو قانون يتعارض صراحة مع الدستور السوري، في نص المادة 25، الفقرة الثالثة التي تنص على المساواة بين كل المواطنين، رجالًا ونساء: “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق”. بينما تتعامل جميع النصوص والتشريعات (الشرعية) مع المرأة كمواطن من الدرجة الثانية، وتعدّها “ناقصة الأهلية”!
ومن ضمن ما يعكسه هذا السؤال: “هل تستطيع العلمانية تزويجي من أربعة؟”، عمق الأزمة المعرفية، الوجدانية، لدى الشريحة العظمى من السوريين، وهم يعيشون مخاضاتهم الموجعة، كنتيجة منطقية لعقود متراكمة من التجهيل وقمع العمل السياسي وحرية الرأي، وغياب المجتمع المدني عن حياة السوريين. لكنه أيضًا يعطي صورة قاسية عن ضعف النخب السورية التي قادت الحراك، وفشلها في صنع القيمة المضافة لدى هذا الشارع العريض من السوريين، على أبسط مستويات الوعي، في سبيل توضيح الرؤية، ليس من أهمها: تشريح المفاهيم الكبرى، كالمدنية والديمقراطية والمواطنة أو العلمانية مثلًا، وهي التي ستصبح لاحقًا في القاموس الشعبي “علمنجية”، كطريقة للتهكم والإهانة ورفض هذا المفهوم، كما مفاهيم أخرى مدنية معاصرة تتعلق ببناء المستقبل، لمصلحة بقاء التشريع الديني!
وبينما سبقتنا كثيرٌ من الدول العربية في فتح ملف المرأة، بين التشريع والقوانين المدنية، ووصلت إلى إنجازات كبيرة في تطور واقع المرأة في قوانين الدولة، على مدى عقود سبقت “ثورات الربيع العربي” كتونس مثلًا، ما زالت النخب السورية (الموالية والمعارضة) تعيش خريفًا قاسيًا، سيكون عائقًا متينًا ضد التقدم في مشروع بناء الدولة والمجتمع السوري القوي، الذي يفترض أنه “هدف الثورة وحلمها”، حين اعتبرت أن فتح هذه الملفات أمرٌ ثانوي، وليس أمرًا ثوريًا سياسيًا، ليبقى هذا الحراك في هذا المجال منوطًا بأصوات فردية، نسوية، لا صدى شعبيًا حقيقيًا لها، حين فشلت في التحول إلى حملات ضغط وتنوير شعبية. كما فشلت في الوصول، عبر عقود كثيرة قبل الثورة، إلى فرض هذه المطالب، عبر السبل السياسية المتاحة في الدولة السورية الغارقة في الفساد السياسي، المتعاون مع فساد المؤسسة الدينية.
لكن الآن، بعد أن قامت الثورة، عبر ثماني سنوات من المخاض الدموي بعيدًا من سيطرة النظام، لم يتحرك هذا الملف، وبقي في الدائرة الضيقة النخبوية، التي تعرف وتعي أن أي تدخل للشرع سيذهب بكلمة مواطنة! ومع ذلك؛ نلاحظ ذلك الضغط المكثف على شارع الثورة، ولا سيّما في وسائل التواصل الاجتماعي، كي يتم رفض العلمانية على سبيل المثال، ويتم ربطها تضليلًا بالإلحاد، متناسين -عن عمد- أن النظام السوري يفعل هذا أيضًا!
فالنظام السوري يعترف ويقرّ بالشرع، كناظم لحياة السوريين في مؤسسة الأسرة. السوريون -منذ الجمهورية الأولى- محكومون بالشرع والتشريع الديني في حياتهم المدنية، ولم يتغير هذا الواقع إلى يومنا هذا، ويبدو أنه سيستمر، لأن المعارضة لا تريد التغيير في هذا الجانب، بل إنها تصارع من أجل بقائه. الأمر الذي يضع السلفيين والإخوان والنظام في خندق واحد، حين يكونون متفقين تمامًا في هذه المسألة. فما هو تعريف الثورة إذًا؟ ولماذا الثورة، إذا كانوا متفقين مع من يثورون ضده؟ والمؤسف أن شريحة كبيرة من المعارضين، حين يريدون سبّ النظام السوري، ينعتونه “بالعلماني”! كيف يمكن تصنيف نظام بأنه علماني، والقوانين التي يحكم بها الأسرة قوانين دينية شرعية؟ النظام السوري ليس علمانيًا، ما دام يستخدم الدين والشرع في القوانين، أو في جزء منها. وهذا الجزء الذي يستخدم فيه الشرع والدين ليس جزءًا بسيطًا، فهو يتعلق بمؤسسة الأسرة التي هي مسؤولة عن بناء المجتمع السوري.
لمن يُحاجج في الدستور السوري بأنه علماني، أقول إن الأزمة بين الدستور والقوانين السورية المشتقة منه تشبه كثيرًا أزمة القرآن مع الفقه. فكما عطلت القوانين العملَ بالدستور، عطل الفقه العمل بالقرآن، لدرجة أن الفقه في مفاصل كثيرة يتعارض مع القرآن، وهكذا الدستور.
يشي هذا التضليل المنهجي من قوى السلفية الدينية، بأن من يجاهدون في صناعة جدار بين العلمانية والجمهور المستهدف الذي يشكل الشارع الأكبر والأعرض في الحراك، لا يعنيهم التغيير أو لا يريدون التغيير، بل يريدون السلطة؟! والسؤال الأهم يجب توجيهه إلى السوري الموالي: لماذا لا يريد النظام فرض القوانين المدنية على الأسرة وتحقيق المواطنة؟ لماذا لا يريد الانتقال في سورية والسوريين إلى مصاف الدول المتقدمة؟ لماذا يرفض الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟ لماذا هذه اللحمة الفكرية بينه وبين السلفيين والإخوان؟
هل هذا يعيد إثبات الرابطة المصيرية الأزلية في العلاقة الوطيدة الوجودية بين الاستبداد والدين مثلًا؟
لم يحكم النظام السوري يومًا إلا بمباركة وتعاضد مع المؤسسات الدينية والطائفية، عبر “قوانين وتشريعات” لا عبر حب عذري. ولم يكتفِ بقوانين الشرع الديني والطائفي المذهبي، بل تعداها إلى القوانين المدنية في قانون العقوبات، من خلال التمييز العلني الصريح ضد المرأة في القانون المدني. وحزمة قوانين “جرائم الشرف” في قانون العقوبات، مثلًا، هي خير دليل. فهي تعفي أي ذكر سوري من عقوبة الإعدام، بتهمة القتل العمد لزوجته أو ابنته أو أخته. وبقليل من التفكر؛ نجد أن هذه الحزمة من القوانين ليست إلا لتكريس وإرساء البنية الماضوية للمجتمع لمرحلة ما قبل بناء الدولة: العائلية والعشائرية والقبلية. حين منحت السلطة الحاكمة حق تقرير مصير حياة النساء في المجتمع، للرجال. فكيف يمكن نعت النظام بأنه علماني؟
ثمة تواطؤ صريح على السوريين، تم بإرادة متبادلة بين سلطة مدنية حاكمة، وسلطة دينية تبارك السلطة الحاكمة! فالمؤسسة الدينية تعرف أن النظام ليس علمانيًا. والسلطة الحاكمة تعرف أن السلطة الدينية لا علاقة لها بمقاصد الشريعة والدين قدر علاقتها بالسلطة!
من ناحية أخرى، فإن النخب (قادة الحراك) لم توضح ولم تشرح للناس، بل ترفض حتى الضغط بهذا الاتجاه، على اعتبار أن مثل هذه الملفات والنقاشات والبحوث، أمورٌ “ثانوية”، على عكس الدور الحقيقي المنوط بالنخب. وهنا ربما تكمن العقبة الأكثر صعوبة: لا يوجد إرادة حقيقية للتغيير!
حين أرادت تونس منع تعدد الزوجات، دخلت إليه من باب الفقه الذي وقف عند كلمة (عدل) ونفاها عن البشر، فتم المنع! تركيا أيضًا، البلد المسلم، كما يطيب لمعظم المسلمين السوريين تسميته، اعتنق العلمانية لإدارة شؤون العباد. فلا وجود لتعدد الزوجات، ومع ذلك نجد ملايين المسلمين السوريين يتغنون بتركيا وإنجازاتها، ويحلمون بدولة كتركيا، مع أنها مبنية على أسس علمانية، لا على أسس دينية!!
لا يمكن لبلد أن ينهض، إذا أصرّ على العيش في زمن يسبق البشرية بألف عام على الأقل. لا يمكن أن نقيس مجتمع اليوم بمسطرة الماضي، إلا إذا كنا نريد لهذه المجتمعات أن تبقى في الماضي!
في الماضي، لم يكن لديهم مؤسسات، ولم يكن لديهم نساء موظفات ولا نساء معيلات. لماذا لا نناقش إمكانية تعطيل تشريع تعدد الزوجات، كما تم تعطيل ملك اليمين والجواري والاستعباد؟ التي لم تعطلها القوانين العربية ولا المؤسسات الفقهية الإسلامية، بل عطّلها تطور الفكر البشري وتطور قوانين حقوق الإنسان. يجب أن نعترف بأننا لسنا في كوكب معزول عن العالم، إذا كنا نريد -بنيّات حقيقية- أن نتطور ونلحق بركب الإنسانية الحديث. فما الفرق بين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتشريع الديني سوى في واقع “المواطنة” بين الاثنين؟
الخيل والرماح والسيوف لم تعد اليوم وسائل مناسبة للحروب وبناء الدول. العِلم هو المقياس اليوم. إنجازات الشعوب الحضارية هي المقياس. وضاقت كثيرًا حرية خياراتنا: فإما دولة دينية، أو دولة علمانية.