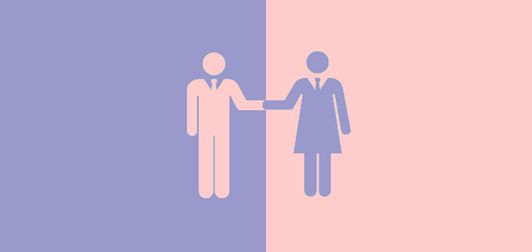سوسن جميل حسن/العربي الجديد- انتشرت، أخيراً، على صفحات التواصل الاجتماعي صورةٌ لسيدة سورية لاجئة، تضع يدها على صدرها محجمةً عن مصافحة رئيس الوزراء السويدي. سببت الصورة نزالاً حامياً بين مرتادي هذه الصفحات، وأثارت ردود أفعال غاضبة وعنيفة وصلت إلى حدّ حدوث سجال ديني ومذهبي وكيل الاتهامات في بعض الحالات. انقسم الجمهور إلى مستهجنٍ بعنف هذا السلوك الذي اعتبره أرعن متعصباً، يدلّ على انغلاق واتخاذ موقف معادٍ ضدّ الآخرين، وإلى مباركٍ له وناكر استهجان الفريق الآخر، معتبراً أنه سلوك سليم صحيح، يحمل عنوان الكرامة بالتمسك بهوية إسلامية، يجب على المسلم عدم التهاون بها.
من يتمعن في الصورة سوف يقرأ في ابتسامة السيدة المعنية وملامح وجهها معنى مركّباً، فيه شيء من الحياء ومن الاعتذار ومن المفاجأة ومن التحفظ ومن الارتباك ومن العرفان. لكن، في النتيجة، هو موقف عفوي، التقطته كاميرا حاضرة، فاعتقلت “لحظة هاربة”، كما كتبت غادة السمان ذات إبداع، ودفعت إلى وسائط الميديا بمادة إشكالية تحرّض الحراك في ميادين مختلفة.
أول ما حضر إلى ذهني، عندما رأيت الصورة كتاب أمين معلوف “الهويات القاتلة” الذي يجد أبلغ تعبير له في عصرنا الحالي، ولحظتنا السورية الراهنة. يقول معلوف: حيث يجد الناس أنهم مهددون في عقيدتهم، يبدو أن الانتماء الديني هو الذي يختزل هويتهم كلها.
التحية والسلام هما موروث ثقافي ترسّخ خلال الزمن، يختلف بين شعب وآخر، منه ما يحمل بعداً دينياً، ومنه ما يحمل بعداً قومياً أو وطنياً، أو ربما يكون خلاصة تاريخٍ ترك ندبة عميقة، يلزمها تاريخ آخر كي تشفى، كما في مناطق في الصين تعرّضت، في تاريخها، إلى جوع طويل، فالفرد في هذه المناطق يبادر الآخر بسؤاله: هل أكلت؟ كتحية حميمة، وفيها تأكيد لمشاعر الصداقة والتضامن.
التحية في الإسلام هي السلام، والسلام سنّة، وردّه واجب وفرض. وهو “تحية المؤمنين في الجنة، وتحية أهل الإسلام في الدنيا. وفي المداومة عليه، تمييز للمسلمين وكيد لأعداء الدين. في إفشائه تمكين ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل”. والمصافحة مباركة في الإسلام، يقول الحديث الشريف: ما من مسلمَيْن يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
وللتحية في الإسلام آدابها، ومنها تحية النساء: للمسلم أن يلقي السلام على النساء، فإن كانت واحدة ويأمن على نفسه الفتنة سلم عليها، لكن بدون مصافحة، وإلا فالأولى تركه، والأمر كذلك بالنسبة للمرأة. فالمصافحة بين الرجل والمرأة مخالفةُ لأدبيات التحية في الإسلام، كما يشرح بعض الفقهاء والمشايخ. وعليه، عندما السلوك البشري الجمعي عندما يصبح مرتبطاً بأحد عناصر الهوية، خاصة عندما يكون هذا العنصر متيناً وتزيده الظروف المحيطة متانة، فإنه سيتأصّل في الأفراد، ويصير دلالة بليغة على الانتماء، وإشهاراً صارخاً له.
يقول أمين معلوف: نظرتنا هي التي تحتجز الآخرين في انتماءاتهم الأضيق، في أغلب الأحيان، ونظرتنا هي القادرة على تحريرهم أيضاً. وهذا يفضي إلى استنتاج أن انتماء شخصٍ إلى مجموعةٍ ما يشكله الآخرون، كالعائلة والأهل والمقربين، وتتسع الدائرة إلى أن تشمل الدين، وكلهم يسعون إلى امتلاك الفرد وتذويب فرديته بالجماعة، مثلما يساهم في تكريسها آخرون بطريقة أخرى، عندما يعملون على إقصائه، أو إلغائه مادياً حتى، كما تظهر الحرب التي تضرم بحطب طائفي في سورية.
لم يبدِ رئيس الوزراء السويدي امتعاضاً من سلوك السيدة السورية، بل تقبّل الأمر، بوصفه مواطناً أولاً، وإنساناً ثانياً، وممثلاً لشخصية اعتبارية أخيراً، ليس فقط لأن المجتمع السويدي متسامح، فكل الأديان في جوهرها تدعو إلى التسامح، بل إن التسامح من النوازع الإنسانية التي تثري النفس البشرية، وتمنحها نوعاً من السكينة، حتى للجماعات اللادينية تسامحها، بل لأن الفرد السويدي يكبر وينمو في مجتمعٍ ينتمي إلى دولةٍ، تقوم على أساس المواطنة وحفظ الحريات واحترام المعتقدات وحماية الحقوق وصون الواجبات. وبالتالي، هو معافى، في الغالب، من مشاعر الإحساس بانتقاصٍ في إنسانيته، ومشاعر الإحساس بالظلم وغياب العدالة من حياته، ومن تمييز أفرادٍ آخرين بسبب أفضليةٍ ما.
عندما تحرّرت سورية من الاستعمار الفرنسي، بعد قرون من الاستعمار المتنوع، كانت لدى الشعب السوري أحلام نهضة وتوق وطموح نحو إقامة دولةٍ حديثة، ولم تكن التباينات الطائفية أو المذهبية أو القومية وهوياتها عائقاً، بل كانت شبه مشلولة أمام الهدف الأكبر، ولم يكن فهم الإسلام وتعاليمه منغلقاً أو محشوراً ضمن النص، بل كان منفتحاً على الحياة، وعلى الاجتهاد، فإذا كانت التحية في الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بما تحمل من مشاعر خيّرة وطيبة، كانت أيضاً تحية اجتماعيةً متعارفاً عليها في المجتمع السوري، ويمكن تأديتها من كل الأديان والطوائف، مثل التحيات الأخرى، ومنها: صباح الخير أو مساء الخير أو سعيدة ليلتكم. ولم يكن هناك تأثيم من رجال الدين لمن يؤدي تحية أخرى، لأنك: قد تأثم لتشبهك بغير المسلمين، ونحن قد أُمِرنا بمخالفتهم، بل هم يحسدوننا على تحيتنا هذه، وأنت تفرّط فيها.
لم يكتب لهذه الأحلام وتلك الطموحات أن تُنجز، بل إن عقوداً من الحكم الاستبدادي الشمولي كان كفيلاً بأن يُنحّي الأحلام ويقتلها، ويدفع بالمجتمع إلى البحث عن ملاذاتٍ لأرواحه، وذلك باللجوء إلى الجماعة، والالتصاق بكيانها لملجأ يعزّز شعور الأفراد بذواتهم، ويمنحهم إحساساً وهمياً بالقوة، والقدرة على تحدي حياة الظلم والقمع والتهميش، ثم جاءت الحرب، بكل زخمها وعنفها وشراستها، ودفعت الحراك السوري إلى ساحات الجهاد الطائفي، ولم يكن العالم رحيماً بهذا الشعب، لم تسعَ الأنظمة والقوى الفاعلة إلى التخفيف من معاناة الشعب، ووقف ذبحه وقتله وتهجيره بشتى الطرق، مدعومة بضخ إعلامي مضلل ومؤجج للفتن. وبالتالي، ازدهرت الهوية الدينية والطائفية والمذهبية وتشرّبت بمشاعر المظلومية والجهاد والتمسك بما تمليه من طقوس وسلوك.
وبما أن العالم اليوم منشغل بمعضلةٍ آثمةٍ بحق البشرية هو تنظيم داعش، أو الدولة الإسلامية أو التيارات المنتمية إلى القاعدة، وما ينجم عن هذه التنظيمات من أعمال اعتداء على البشرية في كل مكان من العالم تحت مسمى الدين الإسلامي، وطموح هذا التنظيم إلى السيطرة على العالم بالجهاد، وإلحاقه بحكمه وسيطرته وشريعته بالقوة، ما استدعى بعض الحركات العنصرية أو المتطرفة في الغرب والعالم إلى الجهر بموقفٍ معين تجاه المسلمين، وبعض من تلك الأصوات لا يعرف أصحابها عن المسلمين شيئاً غير ما تبثه الفضائيات والوسائط الإعلامية عن سلوك الجماعات الإسلامية المتطرفة، فإن هناك توجساً وخوفاً من المسلمين الذين يرفضون سلوك تلك التيارات وعقيدتها وشريعتها، ويشعرون، في المقابل، بأن العالم الآخر يرفضهم بتهمة الإسلام، وأنهم مهدّدون بإسلامهم، فتراهم في الدول التي لجأوا إليها حريصين على التمسك بهويتهم، متحفظين تجاه المجتمعات المضيفة، حذرين من فتح أبواب الاندماج، خوفاً على الهوية المستهدفة في بلدانهم وبلدان العالم أجمع.
ليست قضية امتناع السيدة السورية عن المصافحة بهذه البساطة أو تلك، إنها قضيةٌ إشكالية، لا يمكن تفكيك أبعادها وتشذيب حواملها الثقافية، من دون توفير البيئة المناسبة والملائمة لحياة الإنسان، بيئة نظيفة من أشكال التمييز والظلم والاستغلال والانتقاص من الحقوق والإقصاء، بيئة مجتمعية أكثر إنسانيةً يمكن للمواطنين جميعاً أن يعيشوا فيها بكرامة. وهذا لا يحصل إلا في مجتمعٍ تقوده دولة قانون ومؤسسات يقوم على المواطنة، يحكمها دستورٌ يساهم في صياغته كل الشعب. عندها سيكون موضوع المصافحة أمراً شخصياً، وليس قضية خلافية.